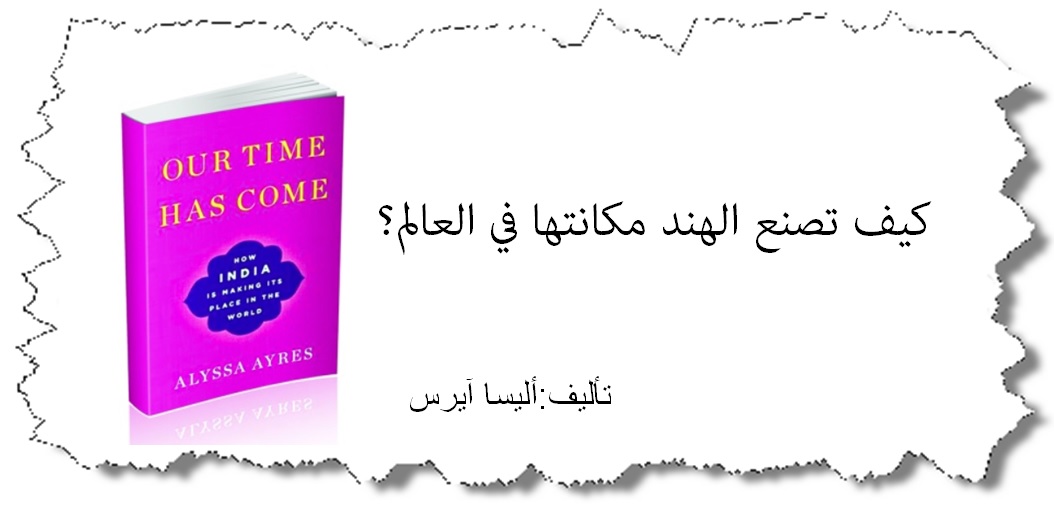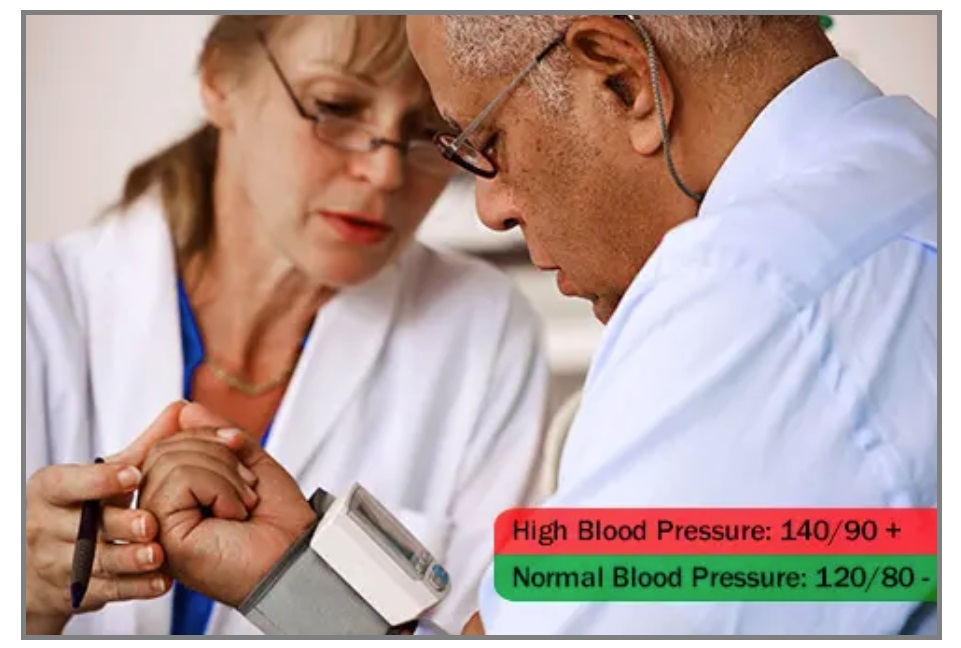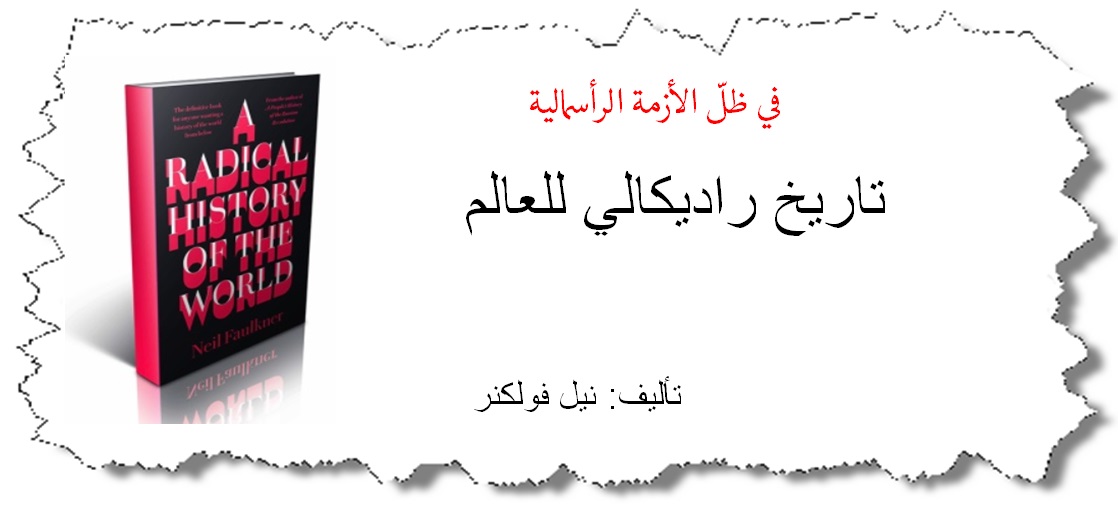Day: ديسمبر 6, 2018
تاريخ راديكالي للعالم
منذ ملايين السنين، سادت وتلاشت إمبراطوريات عدة، وخلال هذه الفترات المختلفة، ناضل البشر دوماً؛ لإيجاد مجتمع أفضل مما كان عليه في السابق، إلا أنه في جميع أنحاء العالم؛ نجد ارتباطات مع الماضي، ربما أصبح من الضروري التوقف عندها، وإعادة التفكير فيها، هذا ما يتناوله نيل فولكنر في هذا الكتاب، متوقفاً عند تاريخ السلطة، وجشع المتحكمين فيها، ويناقش أيضاً جوانب التحرر والتقدم والتضامن، ويرى أنه إذا أنشأنا ماضينا على نحو جيد، يمكننا أيضاً أن نخلق مستقبلاً أفضل.
يعدّ عالم الآثار والمؤرخ والكاتب والناشط السياسي البريطاني نيل فولكنر من الأكاديميين الغربيين المنشغلين بمراجعة الأحداث التاريخية، وربط إسقاطاتها، من منظور ماركسي في الغالب، بالواقع المعيشي اليوم، في ظلّ الأزمة الرأسمالية العالمية، وهيمنة المؤسسات الكبرى.
يقول في مقدمته:
«يواجه العالم اليوم أزمة على مستوى ما حصل في ثلاثينات القرن الماضي؛ فالرأسمالية تعيش أزمة طويلة الأمد، بينما تعمل الأموَلة والتقشف على انكماش الطلب، وتعميق الكساد، وتوسيع نطاق اللامساواة الاجتماعية. النسيج الاجتماعي مفتت. والعلاقات الدولية تزداد حدّة، وتتخذ طابعاً عسكرياً. الحرب تهدد على عدة جبهات…والأحزاب الديمقراطية همّشت مع قبول الدوغما الموالية للسوق… ومع ذلك، فإن العقد الأخير قد شهد مستويات غير مسبوقة تاريخياً من المشاركة في الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، منطوياً على حشودٍ شعبية عريضة للبدائل التقدمية».
لقد عدّ داعمو التدخل العسكري الغربي في العالم الإمبراطويات الماضية – كالإمبراطورية الرومانية والبريطانية كنماذج للحضارة. لقد أعيد تفسير «أوروبا القروسطية» كمثال للاقتصادات ال«نيو كلاسيكية»، التي يفضلها المصرفيون أصحاب الملايين. أما الثورات العظيمة، فقد أعاد المؤرخون التعديليون تفسيرها؛ لتظهر بما يشبه الانقلابات أو نزاعات الفصائل، في محاولة منهم لشطب الصراع الاجتماعي من التاريخ. أما المحاولات لتفسير الماضي- بحيث يمكننا فهم الحاضر وكفعل لتغيير المستقبل – فقد همشتها نظريات «ما بعد الحداثة»، التي تجادل بأن ليس للتاريخ أي بنية أو نمط أو معنى.
ويناقش فولكنر هذه النظريات فيقول: «إنها تظهر أحياناً بلبوس «الأبحاث الجديدة»؛ إذ إنه دأب المؤرخون على أن يبحثوا بين الأرشيفات؛ لجمع المعطيات والبيانات طوال الوقت، ربما يكون المؤرخون التعديليون الأفضل تزوداً بالمعلومات والمعطيات؛ لكن لا يبدو أنهم الأكثر حكمة».
ويشير إلى دور الفعل في حركة التاريخ، فيقول:»لقد علمنا الفيلسوف الألماني الكبير جورج (فيلهلم فريدريش) هيجل، أن الحقيقة هي الكل، إن سياق التاريخ غير محدد مسبقاً؛ ونتائجه غير حتمية؛ إذ يمكن أن يسير في اتجاهات مختلفة بحسب الأفعال الإنسانية«.
في التعريف بكتابه يقول فولكنر: بدأ هذا الكتاب كسلسلة من المقالات المنشورة بين عامي 2010 و 2012 على موقع يساري على شبكة الإنترنت. بعد ستة أعوام، نشر النص بشكل موسّع ككتاب. وقد فعلت هذا لثلاثة أسباب: أولاً؛ لأنني أدركت المواضيع الأساسية المغفلة، وأردت بذلك ملء الثغرات وتجاوزها. ثانياً؛ لأنني تلقيت الكثير من التعليقات النقدية، وأردت عمل التعديلات اللازمة، وثالثاً؛ بسبب أن التغيير الكبير في السياسات العالمية خلال الأعوام الستة الماضية يتطلب فصلاً أخيراً مفصلاً وموسعاً للتعامل مع الأزمة العالمية… لست، كما وصفني أحدهم، بالمؤرخ اللامبالي؛ لأنني أشارك كارل ماركس نظرته أن (تاريخ كل المجتمعات الموجودة حتى اليوم هو تاريخ الصراعات الطبقية). كما أتشارك معه بفكرة مفادها أن (الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم، فيما المهم هو تغييره).
يأتي الكتاب الصادر عن منشورات«بلوتو برس» في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في 512 صفحة موزعة على مقدمة وثمانية عشر فصلاً وخاتمة.
العالم بين أزمة الرأسمالية والفاشية
يقول فولكنر: الاقتصاد العالمي غارق في أزمة ركود طويلة الأمد. كما أن الإنسانية قادرة على إنتاج كميات غير مسبوقة من الثروة. نصف هذه الثروة تقريباً تحت سلطة البنوك، الشركات، الدول والأشخاص إضافة إلى مفرطي الثراء. هذه الكتلة من الفائض الهائل، التي ينتجها كدح القوة العاملة، لم تعد تستثمر بالشكل المنتج: إنها مستخدمة في تمويل نظام فاشل بعمق يقوم على الدين والمضاربة.
هذه «النيوليبرالية» المتطفلة هي جزء من أزمة أعرض للرأسمالية العالمية. تفتت اللامساواة وغياب العدالة في النسيج الاجتماعي. كما أن النظام العالمي في حالة انهيار. أما الفاشيون، العنصريون فيحصلون على المزيد من المساحة على الأرض، همشت الديمقراطية، وتقلصت الحريات المدنية. كما أن الاحتباس الحراري يهدد الكوكب والإنسانية كلها بكارثة مناخية.
يلاحظ محللو التيار السائد (الماينستريم) هذه المشاكل؛ لكنهم إما أن يلجأوا إلى التقليل من أهمية ذلك أو أنهم يتجاهلون الروابط بينها. «ويشير الكاتب للفكرة الماركسية، التي استقاها كارل ماركس من الفيلسوف الألماني هيجل، والتي مفادها أن (المجتمع كلٌّ معقد ومتناقض)؛ حيث كل شيء مرتبط بكل شيء آخر، وأن الخاص يمكن فهمه، فقط؛ عبر علاقته ضمن العام».
هذه كانت الفرضية الضمنية عبر هذا «التاريخ الراديكالي». ويتوجب علينا الآن تطبيق هذا النهج على الحقبة، التي نعيشها راهناً؛ إذ ليس باستطاعتنا فهم الأزمة المركبة، التي يعيشها النظام الرأسمالي العالمي في مطلع القرن الحادي والعشرين دون الإحالة إلى الفترة الطويلة، التي أوصلتنا إلى هذه النقطة».
في فقرة فرعية، بعنوان: «الفاشية الزاحفة» يقول فولكنر: «كانت واحدة من تلك اللحظات، التي تغير العالم فيها. ومثل انهيار جدار برلين عام 1989، وتفجير البرجين التوأم في 2001 والأزمة المالية في 2008، فإن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2016 أرسل موجات صدمة خلال العالم».
لم يجد المحللون الكلمات المناسبة لوصف ما حدث.. ملياردير متهرب من الضرائب، كاره للنساء معترف بارتكاب إساءات، متنمر على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. فخور بتعصبه، كاره لمعظم البشرية. هذا الرجل بالتحديد انتخب؛ ليشغل أقوى منصب سياسي في العالم. 63 مليون أمريكي انتخبوا هذا الشخص.
لكن ترامب هو جزء من ظاهرة عالمية: صعود طبقة من الحكام اليمينيين المتطرفين المستبدين… وعبر العالم، باتت الديمقراطية مهمشة والحريات المدنية مهددة وحقوق الإنسان منتهكة. وفي أوروبا تحديداً، بات هناك ما يمكن تسميته «الموجة الثانية» من الفاشية، التي من مظاهرها وصول الحكومة اليمينية المتطرفة للسلطة في كل من بولندا وهنغاريا. وحصول زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا على 34 في المئة من الأصوات في حملتها الرئاسية الأخيرة.
يستخدم مصطلح «فاشي» أحياناً بشكل فضفاض؛ لوصف أي سلوك سلطوي مستبد؛ لكن ما يثير القلق أكثر هي النزعة لتعريف المصطلح في إطاره الضيق والمحدد، وإنكار أنه قابل للتطبيق على الحركات اليمينية المتطرفة الموجودة اليوم؛ عادة على أساس أنها لا تمثل بشكل كاف صورة النازيين الألمان في فترة ما بين الحربين. وهذا خطأ كبير؛ لأن التاريخ يعيد نفسه؛ لكن ليس بشكل حرفي. إن تجربة ما بين الحربين ترينا أنه يمكن للفاشية أن تتخذ أشكالاً مختلفة. إنها حركة تحمل المعنى الحرفي للعملية (السيرورة)، التي تتغير من مكان إلى آخر، وتتبدل من زمن لآخر، وتتطور عبر التفاعل مع قوى أخرى في ظروف تاريخية متينة.
الثورة النيوليبرالية المضادة
يركز الكاتب على دور النيوليبرالية في إضعاف الحركة العمالية، وتعزيز الآلة الرأسمالية المهيمنة. يقول: «لقد أضعفت الثورة النيوليبرالية المضادة، التي انطلقت أواخر السبعينات المجتمع المدني عموماً، والحركة العمالية خصوصاً. لقد ظهرت الطبقة الحاكمة الدولية في الثمانينات؛ بعد عدد من الهزائم الكبيرة والعميقة، التي تعرضت لها الطبقة العاملة، ثم شهدت العقود الأربعة التالية، توزيعاً على نطاق واسع للثروة والسلطة في مصلحة رأس المال. لهذا، ربما نكون اليوم شهوداً على مرحلة ثانية من تلك الثورة المضادة؛ تصاعد راديكالي، عدم التمكين وإزالة الصفة السياسية للطبقة العاملة».
ليست الفاشية «أداة» مصممة لغرض تاريخي معين. إنها غير «متحكم بها» من سادة ومحرّكين رأسماليين. إنها تعبير مركّز للنيوليبرالية، العنصرية، كراهية الأجانب (الزينوفوبيا)، التحيز الجنسي، العسكرة، التعصب الديني، عبادة السلطة، الانفعال الذهاني، الذي يفيض في المجتمع الرأسمالي في وقت الأزمات.
لا يمكن للنخبة العالمية الاستمرار بالحكم وفق الأسلوب القديم؛ لكن البديل الوحيد الممكن والقابل للتطبيق للفقر، الحرب، الاحتباس الحراري هو تجريد النظام المحدد، الذي ترتكز عليه ثروة وسلطة هذه النخبة. وهذا ما ليس بمقدورهم فعله. لا يمكن للطبقة الحاكمة حلّ هذه الأزمة إلا بالانحدار نحو الهمجية. إن دور سادة رأس المال يجعلهم، في مطلع القرن الحادي والعشرين، طبقة اجتماعية متطفلة دون وظيفة تاريخية.
لقد أخذ التقدم الإنساني بالاعتماد على إطاحة الطبقة النيوليبرالية الحاكمة، سلطة الدولة بأفراد الطبقة العاملة، والاعتراف بالحياة الاقتصادية والاجتماعية تحت الحكم الأهلي.
أما درس القرن ال21 فهو أنه لتحقيق النجاح؛ يتوجب تحقيق ذلك على المستوى العالمي. أما درس العقود الأربعة الماضية؛ فهو أن «الاشتراكية في دولة واحدة»؛ تعد وهماً مضللاً؛ لكن هل الثورة العالمية لا تزال ممكنة في القرن الحادي والعشرين؟
الثورات، بالعموم، غير متوقعة، ومعدية بشكل مؤثر. كما أنها آليات تغيير هائلة. انفجرت الثورة الفرنسية عام 1789، ثم بين أعوام 1789 و1794 بدأت تتشكل آليات عملية سياسية لقيادة الثورة… انحسرت الثورات بعد عام 1815؛ لكنها ما لبثت أن انطلقت مجدداً؛ أولاً في فرنسا عام 1830، ثم إثر موجة من العصيان عام 1848 في باريس، برلين، فيينا، بودابست، روما ومدن أوروبية أخرى. ومع أن الثوار قد هزموا، إلا أن الدافع للإصلاح الذي قدموه لم يكن ليتوقف. لقد عرف حكام أوروبا أنه كان عليهم إدارة التغيير من أعلى أو المخاطرة بمواجهة المزيد من الانفجارات من تحت. أصبحت فرنسا دولة، وتوحدت إيطاليا وتحولت ألمانيا إلى دولة-أمة حديثة. لقد أطلقت الثورة البلشفية (1917) سلسلة من ثورات رد الفعل من ألمانيا إلى الصين. أنهت الثورات في ألمانيا والنمسا-هنغاريا الحرب العالمية الأولى. وبدا أن الحركة الثورية ككل، بين 1917 و 1923 قد اقتربت من هدم النظام الرأسمالي العالمي برمته.
خطوات لفهم الثورة وحقيقتها الفعلية
في عام 1924، كتب المنظر الماركسي الهنغاري جورج لوكاش، في معرض تأملاته حول الحقبة العظيمة من الحرب والثورة، التي مرت للتو، في كتابه «حقيقة الثورة» ما يصلح لأن نستعيده في إطار عصر الأزمة،الذي نعيشه. كتب لوكاش، إن الماركسية «تفترض الحقيقة والفعلية العالمية للثورة البروليتارية. وبهذا المعنى، من ناحية الأساس الموضوعي للحقبة كلها ومفتاح فهمها، فإن الثورة البروليتارية تشكّل جوهر الماركسية…».
بالنسبة للوكاش، فإن ثورة الطبقة العاملة العالمية كانت إمكانية حيوية وحاضرة باستمرار. النقطة هنا، أن النظام القديم احتوى ضمنه الإمكانية المستمرة للثورة، وأن ذلك كان الحل الوحيد المرجح للمعاناة الإنسانية المتزايدة باستمرار.
ويورد فولكنر خمس نقاط يرى أنها ضرورية في سياق فهم أفضل لسيرورة الثورة ضد الرأسمالية والنيوليبرالية:
1) يتوجب علينا فهم ضرورة الحاجة لتغيير النظام. وعندما نتمكن من ربط الحملات، المحتجين والصراعات على تباينها ضمن هجوم عام على النظام الذي هو في الأساس مشاكل الإنسانية، حينها يمكننا أن نأمل بحل تلك الأزمات.
2) علينا أن نفهم الحاجة إلى الدولانيّة. وهذا يعني رفض كل أشكال العنصرية، النزعة القومية و«الشيوعية في دولة واحدة». وبناء شبكات عالمية للمقاومة والتضامن قادرة على تحدي السلطة العالمية للأثرياء.
3) كما أن علينا فهم مركزية الطبقة العاملة – المعرفة بنسبة ال 80 في المئة- لأي استراتيجية جدية لتغيير النظام.
4) يجب أن نبني شبكة من الحركات الاجتماعية الواسعة والجماعات الشعبية المشاركة لتنظيم، نشر وتعزيز صراعات الطبقة العالمية ضد النظام.
5) يتوجب علينا تنظيم أصحاب الرؤى الثورية ضمن شبكات من النشطاء القادرين على قيادة وتنظيم المقاومة العامة من الأسفل، وتحويل الغضب الشعبي إلى موجة من صراع الطبقة العاملة التي تتحول في النهاية إلى حركة ثورية عالمية جديدة يمكن مقارنتها، وإن كانت أكبر، من تلك في أعوام 1789، 1848، 1917، 1968 و 1989.
ويخلص الكاتب إلى فكرة مفادها: «بات العالم المختلف ضرورة تاريخية مطلقة. العالم الآخر ممكن. أما الثورة، بهذا المعنى، فهي «حقيقة فعلية». لكن هذا ليس يقيناً. يجب القتال لأجله. وإنجازاته تعتمد على ما سنفعله كلنا. لم تكن الرهانات التاريخية بأعلى مما هي عليه الآن».
نبذة عن الكاتب
** نيل فولكنر (1958) أكاديمي وعالم آثار ومؤرخ بريطاني. له الكثير من الأبحاث والمحاضرات المنشورة في دوريات ومواقع يسارية. من أحدث كتبه:«تاريخ ماركسي للعالم»(2013)، حرب لورانس العرب (2016)، تاريخ شعبي للثورة الروسية (2017) وآخر كتبه«تاريخ راديكالي للعالم» (2018).
كيف تصنع الهند مكانتها في العالم؟