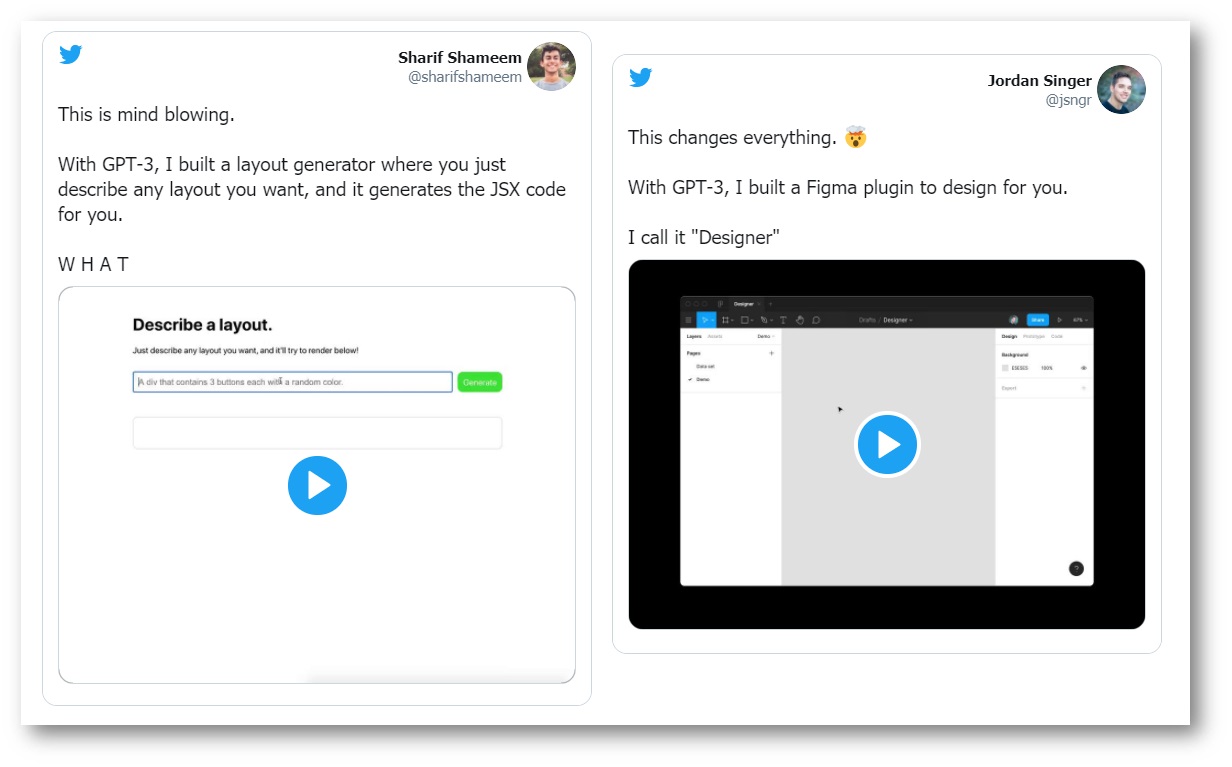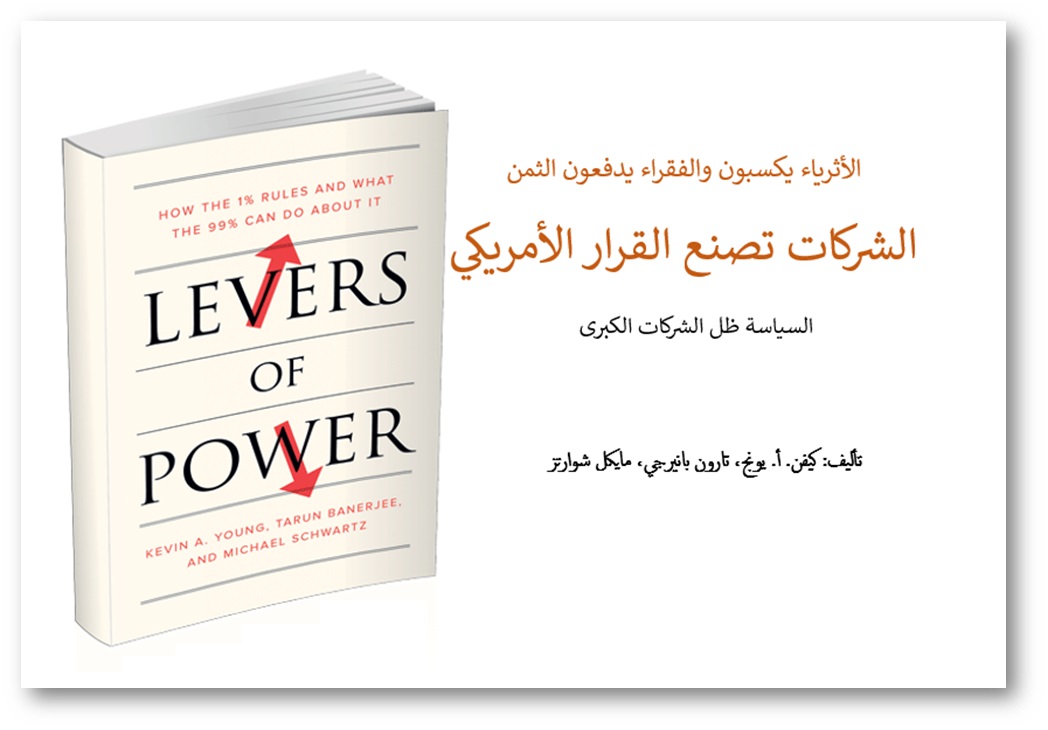
لا يخفى على الكثيرين في أمريكا، وخارجها، أن السياسة الأمريكية تخضع إلى حد كبير، للشركات الكبرى المتحكمة في الاقتصاد الأمريكي، وكثيراً ما تفرض هذه الشركات سياسات تدعم مصالحها على حساب مصالح الشعب. ويناقش هذا الكتاب كيفية صناعة القرار السياسي عبر تأثير هذه القوة المفصلية في المجتمع الأمريكي، وكيف يعمل السياسيون القادمون لأجل تحقيق التغيير على خلق حالة التوازن بين مصالح الشعب، وأصحاب الأعمال.
ليس سراً أن «1%» – النخبة التجارية التي تسيطر على أكبر الشركات والشبكة المتصلة بها من المؤسسات العامة والخاصة – تمارس سيطرة هائلة على الحكومة الأمريكية. في حين تُعزى هذه السيطرة عادة، إلى تبرعات الحملات وكسب التأييد، ويجد هذا الكتاب أن قوة الشركات تنبع من السيطرة على الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الحياة اليومية.
ويذكر المؤلفون أنه يجب أن يسعى المسؤولون الحكوميون باستمرار لإبقاء الرأسماليين سعداء، خشية من «إضراب رأس المال» – أي رفض الاستثمار في صناعات أو مواقع معينة، أو نقل ممتلكاتهم إلى بلدان أخرى – وبالتالي فرض مشقة مادية على مجموعات معينة، أو الاقتصاد ككل. لهذا السبب، حتى السياسيين الذين لا يعتمدون على الشركات لتحقيق نجاحهم الانتخابي، يجب عليهم تجنب انقطاع استثمار الشركات.
يوثق الكتاب القوة المنتشرة للشركات والمؤسسات الأخرى على صنع القرار في تجمعات كبيرة لرأس المال، ولا سيما «البنتاجون». كما يُظهر أن أكثر حركات الإصلاح نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الحديث – من أجل حقوق العمال والحقوق المدنية وضد الحروب الإمبريالية – قد نجحت من خلال الاستهداف المباشر للشركات، وغيرها من الخصوم المؤسسيين الذين بدأوا واستفادوا من السياسات القمعية. وعلى الرغم من أن معظم الحركات الاجتماعية اليوم تركز على الانتخابات والسياسيين، فإن حركات «99%» تكون أكثر فاعلية عندما تفرض تكاليف مباشرة على الشركات والمؤسسات الحليفة لها. وهذه الاستراتيجية هي أيضاً أكثر ملاءمة لبناء حركة جماهيرية ثورية يمكن أن تحل محل المؤسسات الحالية ببدائل ديمقراطية.
في عام 1931، أعرب الفيلسوف جون ديوي، عن أسفه لأن «السياسة هي الظل الذي تلقيه الشركات الكبرى على المجتمع». الحكومة بشكل عام، هي صدى «وفي بعض الأحيان شريك مباشر» لمصالح الشركات الكبرى. اليوم، كما في زمن ديوي، تعتبر سيطرة الشركات الكبرى على الحكومة الأمريكية سراً مكشوفاً. لدينا مؤسسات ديمقراطية رسمياً، لكن 1% يمارسون سيطرة واضحة على صنع السياسات الحكومية. وفي السنوات التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في عام 2008، اتفق نحو الثلثين على أن استجابة الحكومة قد أفادت «البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة» و«الشركات الكبيرة والأثرياء»، وأن بقية السكان قد استفادوا «ليس كثيراً»، أو «لم يستفيدوا على الإطلاق».
إن الانتقادات تجاه الأثرياء – حكم الأغنياء – ليست جديدة. فلطالما شجب الماركسيون واللاسلطويون (الأناركيون) تأثير الرأسماليين في الحكومة. وكان بعض الليبراليين، مثل ديوي، أعربوا عن انتقادات مماثلة تعود على الأقل إلى شكوى آدم سميث في عام 1776 من أن «التجار والمصنعين» في إنجلترا كانوا «المهندسين الرئيسيين للسياسة الاقتصادية ومصالحهم» التي يتابعها السياسيون بعناية. ويدعم التاريخ وجهة نظر ديوي. فقد واجهت الحكومات المنتخبة بتفويض تقدمي قوي، من تشيلي في سبعينات القرن الماضي إلى فنزويلا، واليونان، مؤخراً، اضطراباً اقتصادياً هائلاً، وغالباً انقلابات عسكرية؛ عندما تشكل إصلاحاتها تهديداً لمزايا وامتيازات الرأسماليين. وكان الإصلاحيون الأقل طموحاً، مثل باراك أوباما، تسببوا أيضاً بغضب قطاع الأعمال، على الرغم من بذلهم جهوداً هائلة لاستيعاب مصالح الشركات.

لماذا الأعمال قوية جداً؟ يعزو معظم المحللين نفوذها السياسي إلى التبرعات الانتخابية، وكسب التأييد. لكن تمويل الحملات الانتخابية هو مجرد وسيلة واحدة تؤثر بها الأعمال التجارية في الحكومة. ويرى المؤلفون أن المشكلة تذهب إلى ما هو أبعد من المال في السياسة، إلى هيكل الاقتصاد ذاته. وتنبع القوة السياسية للبنوك والشركات في نهاية المطاف من القوة التي تمارسها على الاقتصاد نفسه. إنهم يتحكمون في معظم الموارد الحيوية التي يعتمد عليها المجتمع، بما في ذلك رأس المال الاستثماري، (وبالتالي الوظائف والقروض)، إضافة إلى الغذاء، والنقل، والطب، وخدمات الرعاية الصحية، وأشياء أخرى لا حصر لها.
يقول المؤلفون: «أقوى سلاح للبنوك وأرباب العمل هو الإضراب الرأسمالي: سحب رأس المال الاستثماري من قطاع أو أكثر من قطاعات الاقتصاد، أو «سحب الاستثمار» في شكل تسريح العمال، أو نقل الأموال إلى الخارج، أو تحويل رأس المال المالي إلى الخارج، وتشديد الائتمان وغيرها من التدابير التخريبية. ويمكن تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الشركات الفردية أو الصناعات بأكملها، أو عندما يتخذ كبار المستثمرين قراراً جماعياً بعدم الاستثمار.
ويضيفون: «إن حجب رأس المال لا يمثل دائماً إضراباً متعمداً من قبل الرأسماليين لأغراض سياسية، فقد يسحب الرأسماليون الاستثمار لمجرد ظروف السوق، مثل انخفاض الطلب على منتجاتهم، كما يحدث عندما يقطع صانعو السيارات الإنتاج ويسرحون العمال عندما ينخفض الطلب على سيارات معينة. ويتميز إضراب رأس المال عن هذه الحالات «العادية» لسحب الاستثمارات من قبل الرأسماليين الذين يطالبون بتغيير سياسة الحكومة، ووعودهم بأن التغييرات الإيجابية ستجلب استثمارات جديدة، أو متجددة. بعبارة أخرى، يشكل سحب الاستثمار إضراب رأس المال عندما يكون حجب رأس المال مصحوباً بوعد بالاستثمار، مقابل خدمات من الحكومة. ونظراً لأن الأعمال تتحكم في معظم الموارد التي نعتمد عليها جميعاً، يجب على المسؤولين الحكوميين إرضاء الرأسماليين باستمرار حتى يواصلوا استثمار هذه الموارد بشكل منتج».
ويؤكدون أن «الحكومات الأكثر جرأة فقط هي على استعداد لإكراه الرأسماليين على الاستثمار، لأن القيام بذلك عادة ما يدعو إلى إضرابات رأسمالية أعمق، ويؤدي إلى عرض يجب على الدولة فيه إما مصادرة المشاريع الخاصة، (متحدية الاتهامات بالاستبداد)، وإما الاستسلام للحكومات في كل مكان، وبالتالي تستثمر طاقة كبيرة وموارد عامة لدرء السخط من قبل المديرين التنفيذيين والمستثمرين الغاضبين».

تستخدم الأعمال مجموعة من الأدوات اليومية إلى جانب إضراب رأس المال. لديها موارد هائلة لإنفاقها على الحملات الانتخابية، وتبرعاتها تفوق تلك التي تقدمها جميع الفئات الأخرى في المجتمع في عملية صنع السياسات. يفعلون ذلك، أولاً، من خلال ضمان انتخاب المرشحين الودودين في مجال الأعمال. وفي بعض الأحيان يأتي المرشحون مباشرة من عالم الأعمال، وأحياناً لا.ويخضع جميع المرشحين على المستوى الوطني لعملية فحص صارمة من قبل مانحين أثرياء قبل تقديمهم للجمهور. وعادة ما يقترب المرشحون للرئاسة من نخب الأعمال لقياس دعمهم حتى قبل الإعلان عن ترشيحاتهم. وبمجرد انتخاب المرشح، سيتم سداد التبرعات السابقة من خلال التشاور الوثيق مع جماعات الضغط التجارية، ومن خلال تعيين موظفين ودودين للعمل، ومستشارين، ومنظمين، وقضاة. وتساعد العلاقة في تحديد التشريعات التي يتم تقديمها، والسياسات المستبعدة من الاعتبار، كيفية تنفيذ القوانين الحالية. ويواصل كلا الجانبين تنمية هذه العلاقة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن المانحين هم الأكثر قوة. إنهم في الأساس مستثمرون «يجعلون السياسيين يشبهون الأسهم إلى حد ما»، ويستثمرون في أولئك الذين يرجح أن يحققوا عائداً، أولئك الذين لديهم سجل حافل من التدابير المؤيدة للأعمال التجارية والتخلص من أولئك الذين ثبت أنهم مخيبون للآمال.
ويقول المؤلفون: «إذا خيب أحد السياسيين الظن، وفشلت الشركات في الحصول على كل ما تريده من الحكومة، فإن الجهات المانحة لديها الكثير من أسلحة الاضطراب الأخرى في ترسانتها. حيث تساعد تهديدات الإضرابات الرأسمالية، وإضرابات رأس المال الحقيقية في بعض الأحيان، على إبقاء السياسيين والمنظمين في صف واحد. وتستفيد الشركات أيضاً من نظام المحاكم بشكل كامل، وتنفق مبالغ هائلة على التقاضي لتحدي القوانين التي لا تحبها. ومن أجل تدبير جيد، غالباً ما تضغط الشركات على حلفائها في الكونجرس لقطع التمويل عن الوكالات التنظيمية، وبالتالي ضمان أن أهداف التقاضي التجاري ستكون ناقصة التمويل وغير مجهزة للدفاع عن أفعالهم ضد الشركات الكبيرة. وبهذه الطريقة، تصبح العديد من السياسات بؤرة حرب لا تنتهي أبداً إلى التنفيذ، والتي تستمر لفترة طويلة بعد أن يوقع الرئيس على قانون جديد، وحتى بعد فترة طويلة من تركه لمنصبه».
وتوضح المعركة حول إصلاح «وول ستريت» وقانون حماية المستهلك («دود-فرانك») عام 2010 كيف تعزز استراتيجيات الشركات المتنوعة بعضها بعضاً. أولاً، ضمنت مجموعة تبرعات حملة وول ستريت، والتحذيرات الرهيبة بشأن سحب الاستثمار في أعقاب انهيار عام 2008 أن أوباما عيّن منظمين ومستشارين صديقين للبنوك، وضمن أيضاً أن جماعات الضغط في «وول ستريت» سيكون لها وصول مباشر إلى المفاوضات بشأن الإصلاح. ونتيجة لذلك، كانت المسودات الأولية للتشريعات التي قدمتها الإدارة أقل راديكالية بكثير مما توقعه معظم الناس استناداً إلى خطاب أوباما في حملته الانتخابية عام 2008، بحسب المؤلفين.
لغز أوباما
هذا الكتاب (الصادر عن دار فيرسو للنشر باللغة الإنجليزية في يوليو/ تموز 2020 ضمن 224 صفحة)، هو نتاج أكثر من عقد من البحث والمناقشة. بدأت المحادثات لكتابته في أواخر عام 2009، مدفوعة بنمط ناشئ هو «لغز أوباما». وعلى الرغم من أن إدارة أوباما الجديدة قد تم انتخابها بتفويض قوي من أجل «التغيير الذي يمكننا أن نؤمن به»، وتمتعت بالسيطرة الواضحة على الكونجرس، إلا أنها لم تقدم إصلاحات تقدمية كبيرة. يقول المؤلفون: «بدأنا نرى هذا النمط على أنه انعكاس لسؤال نظري أكبر بكثير: ما هي عقبات التغيير السياسي التقدمي في مجتمعات العصر الحديث، وكيف يمكننا التغلب عليها؟ وتم تشكيل إجابتنا من خلال بحثنا والمناقشة المستمرة بين المؤلفين، مع مدخلات من دائرة كبيرة من الأصدقاء والزملاء».
كما يوحي مثال إصلاح «وول ستريت»، أن الشركات بشكل كامل استفادت من كل هذه الأدوات خلال إدارة أوباما. ولذلك خصص المؤلفون الكثير من تركيزهم في هذا الكتاب على رئاسة أوباما، ليس لأن أوباما كان أكثر خضوعاً للرأسماليين من الرؤساء الآخرين، بحسب رأيهم، ولكن لأنه كان هناك مثل هذا الانفصال الدراماتيكي بين وعود التقدم التي قدمها وسياساته الفعلية. ويذكرون: «كمرشح، تعهد بمواجهة شركات الوقود الأحفوري، وشركات التأمين الصحي، وبنوك وول ستريت، وغيرها من المصالح التجارية المفترسة. وفي جميع هذه المجالات، حظيت وعوده بتأييد ساحق بين الناخبين الديمقراطيين، كما كانت تحظى بشعبية لدى العديد من الناخبين الجمهوريين، والمستقلين. ومع ذلك، فإن إصلاحاته السياسية لم ترق إلى مستوى خطابه. كان المحير بشكل خاص هو حقيقة أن بعض الإصلاحات كانت في متناول اليد خلال عامين من سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، أو يمكن تحقيقها باستخدام السلطات التنفيذية».
وعد أوباما لم يتحقق
تُظهر سنوات حكم أوباما كيف أنه على الرغم من الانتصار الانتخابي المدوي للرئيس، والتفويض العام القوي للتغيير، ظلت الشركات في دفة القيادة. على سبيل المثال، وعد أوباما بإصلاحات بيئية ملحة، ولا سيما لمنع تغير المناخ الكارثي.
وكان الجمهور داعماً. وفي عام 2008، فضل 78 في المئة معاهدة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفضل 66 في المئة اللوائح الحكومية التي من شأنها إجبار المرافق على استخدام المزيد من مصادر الطاقة النظيفة. عند الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في ذلك العام، توقع أوباما أن تكون رئاسته هي اللحظة التي بدأ فيها ارتفاع المحيطات في التباطؤ وبدأ كوكبنا بالتعافي. ومع ذلك، فإن الإصلاحات البيئية لإدارته توقفت كثيراً عما هو ضروري علمياً.