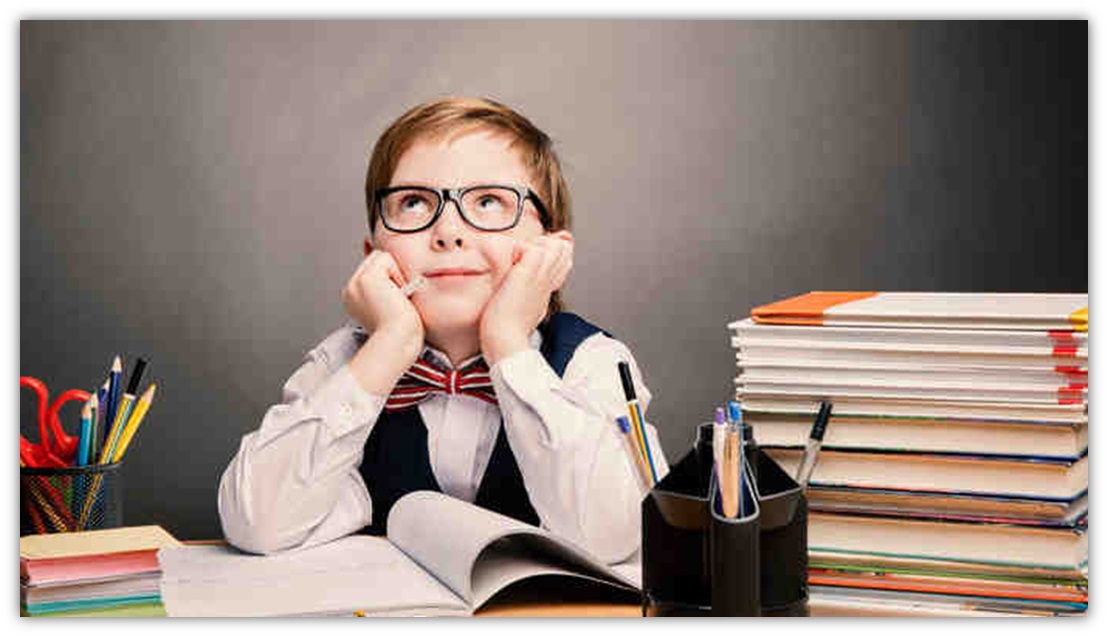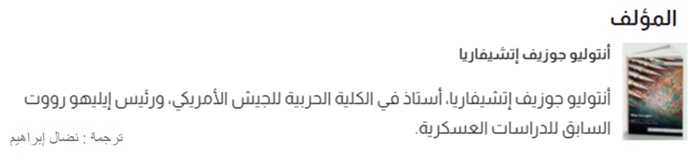يعتبر التعليم محركًا قويًا للتنمية الاقتصادية للدول وأحد أدوات الحد من الفقر، ويساعد التعليم على نشر السلام والاستقرار بين الدول. كذلك يساعد التعليم على توفير فرص توظيف للأفراد وزيادة الدخل المادي للأسر. فحسب دراسة للبنك الدولي حول تأثير التعليم على الدخل فإن دخل الفرد يزيد بنسبة 9% في الأجر بعد التحاقه بسوق العمل مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي. ولا يقتصر الأمر على المستوى الفردي لكنه يمتد ليشمل المستوى القومي أيضًا، حيث أجرت المؤسسة الدولية دراسة عن العلاقة بين جودة التعليم (والتي تم قياسها باستخدام اختبارات عالمية في الرياضيات والعلوم) ومستوى نمو الدخل القومي، وخلصت الدراسة التي أجريت على بيانات 50 دولة طيلة 40 عامًا إلى تفوق الدول التي تتمتع بتعليم أفضل على تلك التي لا تتمتع به في معدلات النمو بنسبة تبلغ 2% سنويًا خلال تلك الأعوام الأربعين. كذلك يحفز التعليم الابتكار في المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتشير دراسة لـجامعة هارفارد إلى أن أهمية التعليم وتأثيره في النمو الاقتصادي والاجتماعي يرجعان لأكثر من سبب منها أن الاستثمار في رأس المال البشري يزيد من الناتج العالمي بنسبة 62%، وتزيد هذه النسبة في الناتج مع زيادة نسبة الخدمات المقدمة للأفراد كما تشكل زيادة الآلات والموارد الطبيعية النسبة الباقية. وتؤكد هذه البيانات أن الاستثمار في الموارد البشرية أمر مربح أكثر من الاستثمار في الآلات أو في اكتشاف الموارد الطبيعية على الرغم من أهميتهما. كما تؤشر الدراسة إلى أن الدولار الواحد الذي يتم إنفاقه على التعليم في أي دولة، خاصة في الدول النامية، يعود إليها دخلًا سنويًا يتراوح بين 7-10 دولارات بين 15-20 سنة والذي يزيد من الاستثمارات طويلة المدى بالإضافة إلى أن فرص التعليم تساعد على تحسين مهارات وقدرات المتعلمين.