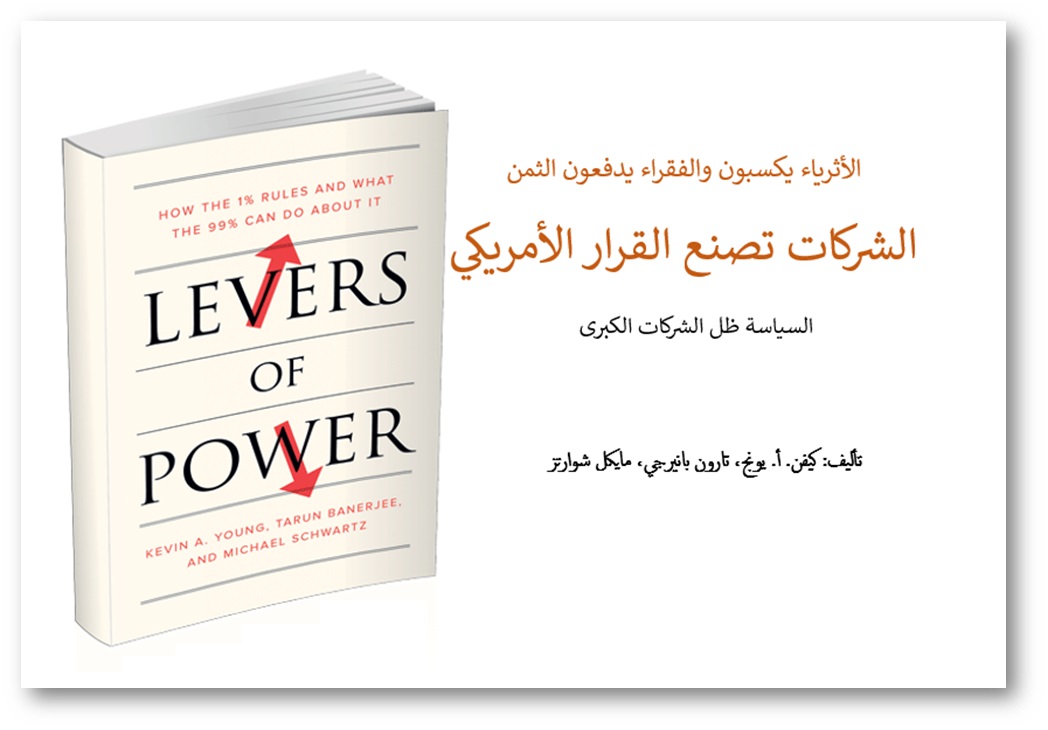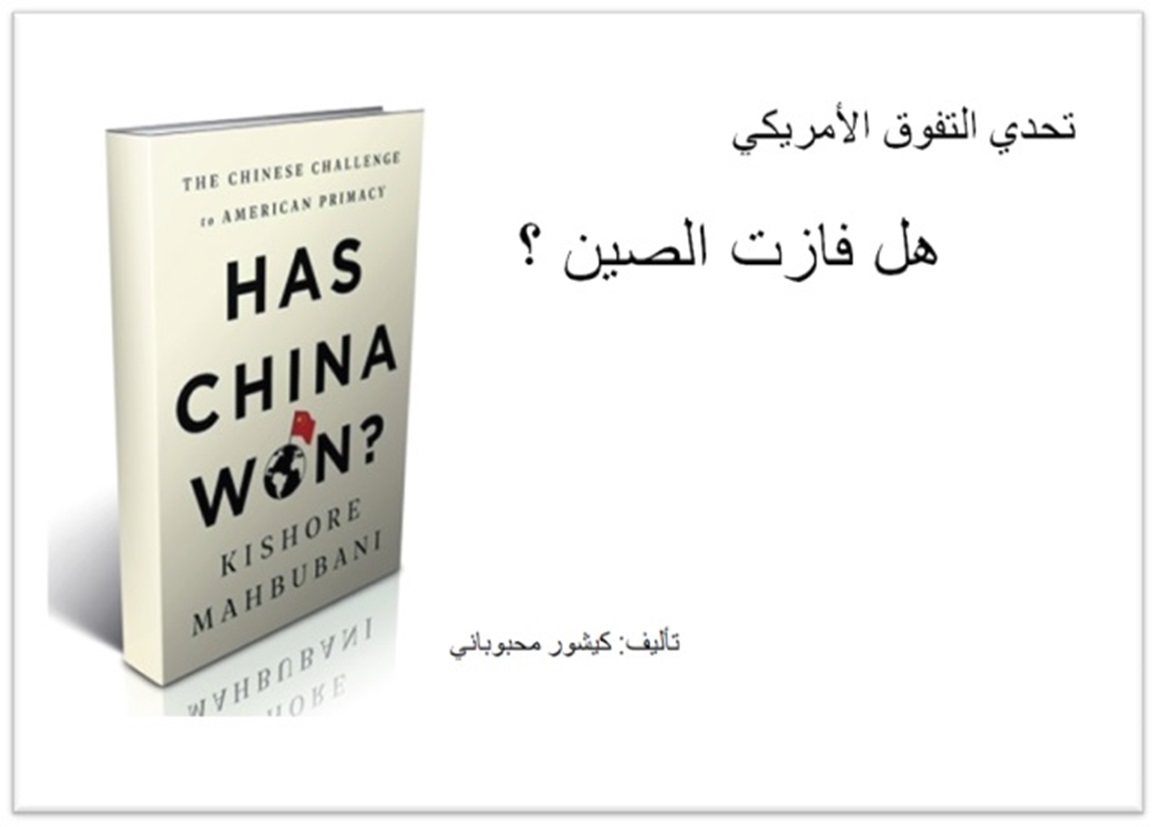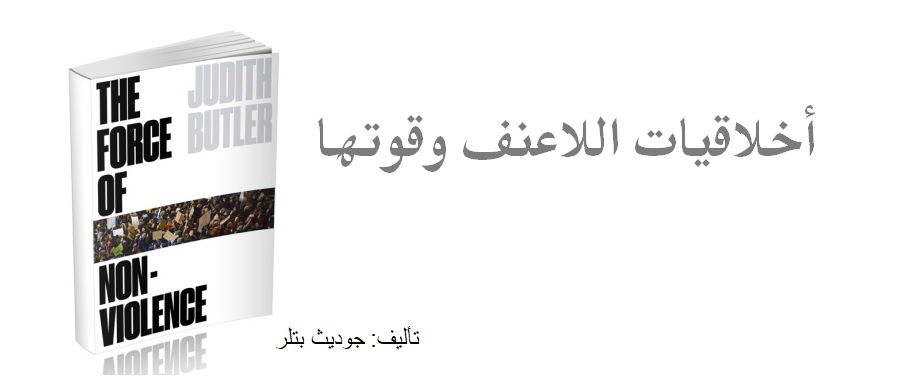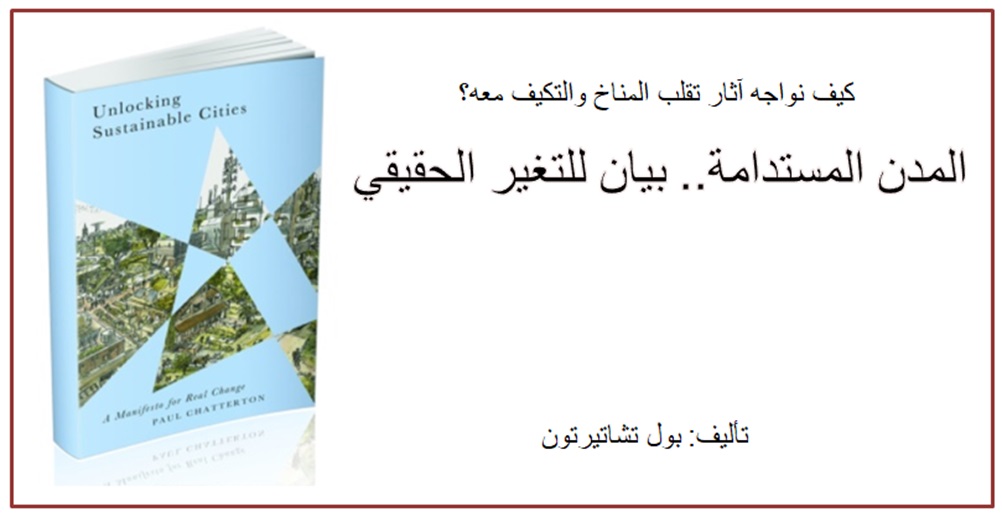كشفت جائحة «كورونا» بشكل مأساوي كيف أن نموذج دولة الرفاه اليوم لا تستطيع حماية مواطنيها بشكل صحيح في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع العام، فإن اختلالات كبيرة ظهرت إلى السطح، وتحتاج إلى معالجة. توضح المحللة السياسية البارزة أورسولا هووز كيف يمكننا إنشاء دولة رفاه عادلة في المملكة المتحدة، من شأنها أن توفر الأمن للجميع على كافة الأصعد.
بالاعتماد على بحث استمر معها طيلة حياتها حول بعض القضايا الرئيسية في عصرنا مثل اقتصاد الوظائف المؤقتة، والرعاية الصحية الشاملة والمجانية، والرعاية الاجتماعية؛ تشرح المؤلفة في كتابها « إعادة ابتكار دولة الرفاة» بوضوح لماذا نحتاج إلى إعادة التفكير جذرياً في كيفية تغييرها، وتقترح أفكاراً سياسية جديدة ومبتكرة، بما في ذلك المناقشات النقدية للدخل الأساسي العالمي والتشريعات الجديدة لحقوق العمال العالمية، كما أنها تحدد «دولة الرفاه الرقمية» في القرن الحادي والعشرين. ويشمل ذلك إعادة استخدام تقنيات المنصات الإنترنيتية لتكون تحت السيطرة العامة؛ بهدف تحديث وتوسيع الخدمات العامة، وتحسين إمكانية الوصول.
انقسامات بين العمل والأحزاب السياسية
منذ عام 2016، ظهرت انقسامات مقلقة داخل الطبقة العاملة البريطانية، وبين الأحزاب السياسية التي تدعي أنها تمثل مصالحها. لقد استجاب الكثيرون لهذا الموقف؛ من خلال التراجع إلى المواقف المستقطبة أو الاستسلام لأشكال عميقة ومشلولة من الاكتئاب تجعلهم يائسين أو غير فاعلين.
يأتي هذا الكتاب في محاولة لمواجهة ردود الفعل هذه؛ إذ ترى الكاتبة أنه على الرغم من هذه الانقسامات المؤلمة، هناك ما يوحد الناس أكثر بكثير مما يفرقهم. تقول المؤلفة: «قبل كل شيء، وضد بعض الأدلة المستمدة من الانتخابات العامة لعام 2019، يبدو لي أن هناك جوعاً عميقاً بين الشعب البريطاني، عبر كافة أطيافه، إلى دولة رفاه تهتم حقاً بمواطنيها، بكافة تنوعاتهم من المهد إلى اللحد. ظهرت أدلة جديدة على هذا الجوع خلال أزمة فيروس كورونا، على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه، كما أكتب، معرفة إلى أين سيؤدي ذلك. على الرغم من الإغراءات العديدة لإلقاء القبض على جعل الآخرين كبش فداء لأوجه القصور في دولة الرفاه الحالية، أو الاستسلام للانهزامية، أعتقد أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص ذوي المبادئ ممن لديهم الشجاعة لتنحية خلافاتهم جانباً، والقيام بحملة لتأسيس دولة رفاه أفضل».
وتضيف المؤلفة: «لذلك، أكتب من موقع التفاؤل، وأقدم هذا الكتاب كمساهمة بناءة في تطوير بيان للأمل وشكل تعاوني للسياسة يمكنه بناء مستقبل بديل. نحن مدينون لأبنائنا وأحفادنا بتزويدهم ببيئة اقتصادية واجتماعية لا يضطرون فيها إلى إهدار طاقاتهم من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن يمكنهم العيش حياة كريمة ومرضية يركزون فيها طاقاتهم على مواجهة التحديات الضخمة التي تواجه الكوكب. دعونا نعطيهم أفضل ما لدينا. من الواضح أن دولة الرفاه التي لدينا في المملكة المتحدة لم تعد مناسبة. لكن ما الذي يمكن عمله حيال ذلك؟ هذا من أكبر التحديات التي تواجهنا ونحن ندخل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. هل نحاول إعادة خلق العالم المريح في منتصف القرن العشرين، أم أننا بحاجة إلى تصميم شيء جديد، لعصر رقمي عالمي؟ تلعب دولة الرفاه في منتصف القرن العشرين دوراً قوياً في الخيال الاشتراكي، فهي لا توفر فقط أصل العديد من مؤسساتنا الحالية، على الرغم من أن بعضها قد يكون كذلك، ولكنها تمثل أيضاً نموذجاً طموحاً. في أوروبا، على وجه الخصوص، لا يزال الكثيرون يعدونها المعيار الذي يتم من خلاله قياس الحياة الكريمة، مع وجود الأمن والأمان، والتضامن الاجتماعي، وحماية الشعب من المهد إلى اللحد من الفقر، وتكافؤ في الفرص، ورؤية التقدم.
عندما يُسأل الناس عن الشكل الذي تبدو عليه «الوظيفة المناسبة» – تقول المؤلفة – لا يزال معظمهم يشير إلى النموذج الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، على الأقل بالنسبة لأقلية مميزة، للعمل بدوام كامل ودائم مع ساعات عمل منتظمة، مع وجود التأمين ضد مخاطر المرض أو العجز أو البطالة، ومعاش في النهاية؛ لتوفير تقاعد سعيد. وبالمثل، فإن هناك دعماً واسع النطاق لفكرة أن المجتمع المتمتع بحياة كريمة هو المجتمع الذي يوفر المأوى الكافي لضمان عدم اضطرار أي شخص إلى النوم في الشارع، وشبكة أمان للرفاهية تمنع حدوث مجاعة. لا يزال الكثيرون يتفقون مع هدف الاقتصادي الإنجليزي وليام بيفريدج (1879 – 1963) الذي لا يُنسى في القضاء على «الشرور العملاقة» الخمسة؛ المتمثلة في الفساد والجهل والعوز والكسل والمرض. وبهذه الروح، أعطتنا حكومة أتلي بعد الحرب العديد من السمات الأساسية التي لا يزال معظم البريطانيين يعدونها حقوقاً اجتماعية معيارية؛ وهي: الرعاية الصحية الشاملة والتعليم الشامل ونظام التأمين الوطني الذي يوفر معاشات تقاعدية وإعانة الأطفال والتحرر من العوز عبر شبكة أمان اجتماعي.
تفكك دولة الرفاه
تذكر الكاتبة أن الأجيال التي نشأت في احتضان دولة الرفاه هذه، أو على الأقل من بينهم الاشتراكيون، شاهدت تفككها البطيء على مدى العقود الأربعة الماضية بصورة مرعبة، واضعين طاقاتهم السياسية في محاولة للمحافظة على ما يستطيعون منها، مطالبين بإعادة تأميم ما تمت خصخصته، وإعادة تنظيم ما تم تحريره، وإعادة الميزانيات التي تم تخفيضها. بعبارة أخرى، يطالبون بحل يبدو للكثيرين وكأنه عودة إلى الوراء. في الأغلب تكون المؤسسات الحكومية الحالية أمراً مفروغاً منه في المشهد الاجتماعي؛ بحيث يصعب على الأشخاص من مواليد هذه الفترة الفصل بين السمات المحددة لتلك المؤسسات والأهداف الاجتماعية التي ألهمت تصميمها. إن تجربتهم في محاولة الدفاع عن هذه الهيئات في القرن العشرين خلال السنوات الصعبة الطويلة بين صعود النيوليبرالية في نهاية السبعينات والأزمة المالية في عام 2008 جعلتهم يشككون بشدة في الإصلاح؛ لكن هذا ربما جعل من الصعب عليهم فهم مدى نشوء الفجوة بين تلك الأهداف الاجتماعية الأصلية والطريقة التي تعمل بها هذه المؤسسات الآن. وربما تكون هذه التجارب ذاتها قد أزالت حساسيتهم تجاه آراء الأجيال الشابة التي لم ترَ دولة الرفاه إلا من منظور النيوليبرالية.
وترى أنه بالنسبة لأي شخص دخل سوق العمل بعد عام 1990، فإن عالم العمل في فترة ما بعد الحرب – الذي يهيمن عليه المعيلون من الذكور في وظيفة دائمة بدوام كامل يدعمون الأسر المعالة – أمر لا يمكن تصوره تقريباً، وتقول: كان سقوط جدار برلين علامة على التأسيس الرمزي لتقسيم دولي جديد للعمل؛ حيث واجهت القوى العاملة المحمية في الاقتصادات الغربية المتقدمة تحدياً متزايداً؛ بسبب وجود جيش احتياطي عالمي من العمالة، يمكن الوصول إليه من قبل أرباب العمل خارج الحدود الوطنية إما عن طريق نقل العمل إلى الخارج وتأسيس اقتصادات منخفضة الأجور وإما من خلال الاستفادة من قوة عاملة مهاجرة غير مستقرة في بلدانها الأصلية. أدى ذلك إلى خلق قوة عاملة مشتتة وإن كانت مترابطة، منظمة في سلاسل القيمة العالمية، في الأغلب خارج نطاق المواطنة الوطنية وبالتالي تم استبعادها من تغطية الرعاية الاجتماعية أو قوانين حماية العمالة. في هذا السياق، قد تبدو الاستراتيجيات لمحاولة استعادة نموذج التوظيف والرعاية بعد الحرب وكأنها محاولة رومانسية من خلال الرؤية في نظارات وردية. في الواقع، إذا تم نقل معظم الشباب «اليقظين» الذين نشأوا في أوائل القرن الحادي والعشرين، إلى الخمسينات من القرن الماضي، من المحتمل أن يشعروا بأنهم في جحيم حقيقي، مقيد بالفئوية، ومتحيز ضد المرأة، وعنصري. من الصعب تخيل العودة إلى بعض من سمات الحياة اليومية في منتصف القرن العشرين.
في هذا الكتاب تدعو المؤلفة إلى نهج مختلف. بالاعتماد على بحث مكثف حول التغييرات في العمل والرفاه، يجادل بأن ما نحتاج إليه الآن ليس إعادة خلق حنين إلى المشهد المؤسسي لدولة الرفاه بعد الحرب ولكن العودة إلى المبادئ التي ألهمتها. بعد تحديد هذه المبادئ، تجادل بأنه ينبغي إجراء تحليل صارم للواقع الاجتماعي لبريطانيا الحديثة من أجل معرفة كيف يمكن تطبيق هذه المبادئ على أفضل وجه لتلبية احتياجات السكان الحاليين.
ترى الكاتبة أن السياق الذي يجب تطبيق هذه المبادئ فيه هو السياق الذي يتم فيه تنظيم العمل والاستهلاك بشكل متزايد في الأسواق العالمية من قبل الشركات متعددة الجنسيات المتهربة من الضرائب؛ حيث تُستخدم التقنيات الرقمية لاستخراج قيمة من مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث من المحتمل أن تنخرط المرأة في عمل مدفوع الأجر مثل الرجال، وينتشر التشرد والفقر، ويكون للسكان المسنين احتياجات يائسة بشكل متزايد للرعاية الصحية والاجتماعية، وحيث يبقى ظل تغير المناخ يخيم على كل شيء».
تقول المؤلفة: «في رأيي، سيكون من الخطأ الفادح محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لدينا فرصة تاريخية لإعادة التفكير في المبادئ الأولى من الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه دولة الرفاه في القرن الحادي والعشرين، ونحن مدينون لضحايا العولمة النيوليبرالية بتقديم أفضل ما لدينا. وهذا يتطلب شيئاً أكثر طموحاً من محاولة إعادة إنشاء نسخة مصححة من الربع الثالث من القرن العشرين (يُنظر إليها من خلال النظارات الوردية في القرن الحادي والعشرين)، وأكثر تركيزاً على القضايا المحددة التي تواجه الطبقة العاملة في اقتصاد معولم رقمي. لفهم طبيعة التحدي، من الضروري أولاً تقدير ضخامة التحول في دولة الرفاه في منتصف القرن العشرين الذي حدث خلال العقود السبعة الماضية».
بنية الكتاب
يقع الكتاب في 240 صفحة، وهو صادر باللغة الإنجليزية عن دار بلوتو للنشر في 20 سبتمبر/أيلول 2020. ويتكون من مقدمة ثم فصول هي: ماذا حدث لدولة الرفاه في القرن العشرين؟؛ ماذا حدث في سوق العمل؟؛ ماذا حدث للمساواة بين الجنسين؟؛ إعادة ضبط آليات إعادة التوزيع؛ دخل أساسي عالمي يمكن إعادة توزيعه حقاً؛ صفقة جديدة للعمل؛ منصات رقمية للصالح العام؛ إلى الأمام.
تتناول المؤلفة أولاً (في الفصل الثاني) كيفية تحول مؤسسات دولة الرفاه من خلال سلسلة من التحولات من وسائل تحسين مستويات المعيشة، وزيادة الاختيارات وإعادة توزيع الثروة بشكل متساوٍ عبر المجتمع إلى آليات إعادة التوزيع من الفقراء إلى الأغنياء.
ينظر الفصل الثالث في التغييرات في سوق العمل وكيف حدث تآكل في نموذج التوظيف القياسي في القرن العشرين، ما أدى إلى انتشار غير رسمي وظهور أشكال جديدة من العمل غير المستقر المُدار رقمياً. يلخص الفصل الرابع التغييرات التي حدثت في تقسيم العمل بين الجنسين خلال الفترة نفسها، مما أحبط العديد من الأهداف الكبرى للحركة النسائية في السبعينات. ويوضح هذا الفصل الطريقة التي تفاعلت بها التطورات في نظام الرعاية وسوق العمل مع بعضها لإنتاج حلقة مفرغة يدفع فيها الفقر الزمني والفقر المالي بعضهما إلى دوامة لا تنتهي، بطرق ضارة للغاية بالمساواة وكذلك نوعية الحياة في العمل والمنزل.
يبحث الكتاب في الطرق التي يمكن من خلالها عكس هذه الحلقة المفرغة، وكيف يمكن تطوير السياسات التي تعزز المساواة وحرية الاختيار والتوازن بين العمل والحياة، مع معالجة بعض تحديات السياسة الرئيسية الأخرى التي تواجهنا بما في ذلك الرعاية لشيخوخة السكان، وتطوير الاقتصادات المحلية ومعالجة نفايات الغذاء والطاقة.
تلقي المؤلفة في الفصل الخامس نظرة على آليات إعادة التوزيع والمبادئ الأساسية التي يجب أن تدعم مثل هذه السياسات. ثم تقدّم بعض الاقتراحات الملموسة: من أجل أشكال الدخل الأساسي الشامل الذي يمكن إعادة توزيعه بشكل حقيقي (في الفصل السادس) ومن أجل ميثاق جديد للحقوق العالمية للعمال (في الفصل السابع).
في الختام، يبحث الكتاب في الخدمات التي تقدمها دولة الرفاه، أو ينبغي أن توفرها لجعل أهداف إعادة التوزيع والمساواة هذه حقيقة واقعة. ويركز الفصل بشكل خاص على الخدمات التي يمكن تقديمها عبر المنصات الرقمية، مثل التي تتضمن النقل وتوصيل الطعام والمطابقة بين العرض والطلب بين العمال والعملاء في خدمات مثل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية. على العموم، لا يقترح الكتاب حلولاً فيما يتعلق بنطاق هذه الخدمات أو كيف ينبغي تنظيمها. بل يقترح، بدلاً من ذلك، مجموعة متنوعة من الطرق الممكنة والمختلفة، على سبيل المثال، من خلال دمجها في المؤسسات القائمة أو إنشائها كشراكات أو مؤسسات اجتماعية أو تعاونيات، بهدف تشجيع نهج يبدأ من القاعدة إلى القمة على المستوى المحلي متجذر في التعاون بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الاجتماعية المختلفة.
عن المؤلفة
* أورسولا هووس أستاذة العمل والعولمة في جامعة هيرتفوردشاير. لها العديد من الكتب والأبحاث الرائدة عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتغير التكنولوجي، وإعادة هيكلة التوظيف والتقسيم الدولي المتغير للعمل.. وهي تحاضر وتقدم المشورة لصانعي السياسات على المستوى الدولي.
ترجمة: نضال إبراهيم