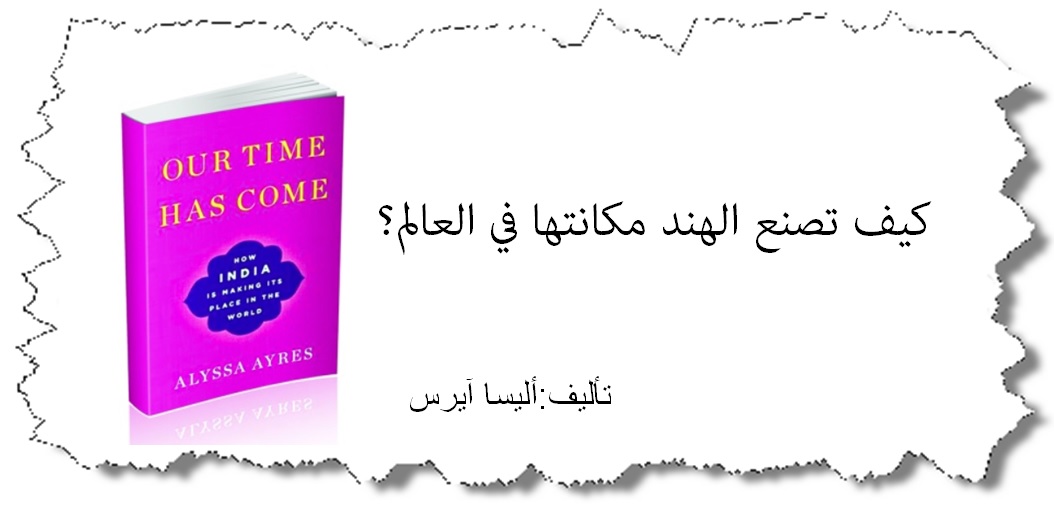

كتب
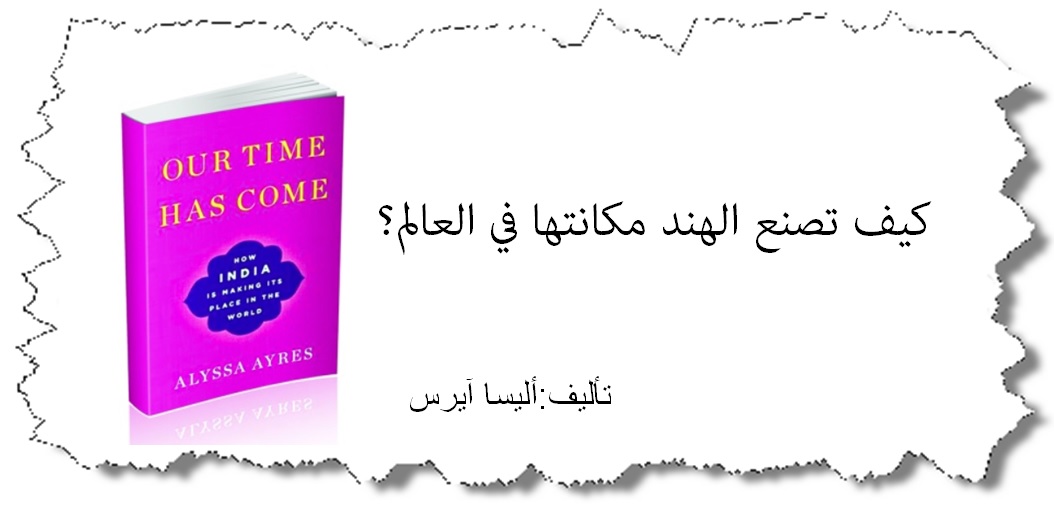



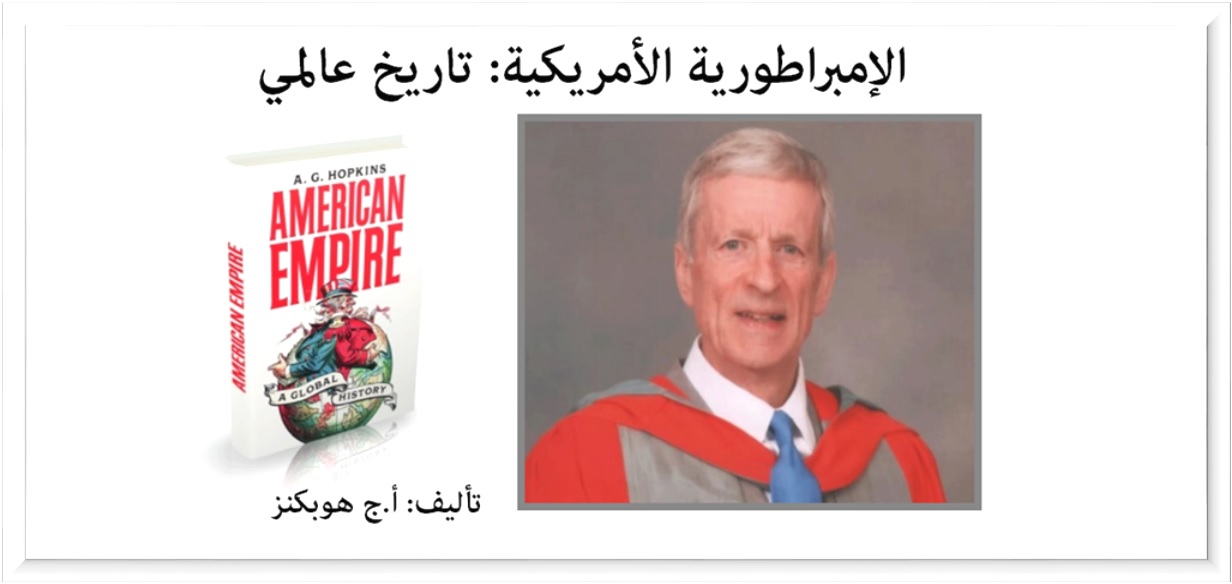
هل تختلف الإمبراطورية الأمريكية عن غيرها من الإمبراطوريات؟ هل هي الوريث الشرعي للإمبراطورية البريطانية؟ بماذا تختلف عن غيرها؟ نتعرّف إلى الكثير من التفاصيل في هذا العمل البانورامي الذي يقدم منظوراً عالمياً جديداً عن تاريخ الولايات المتحدة. ويعتمد المؤلف على خبرته في التاريخ الاقتصادي والإمبراطوري لبريطانيا، وأوروبا، وينطلق من الحقبة الاستعمارية إلى الوقت الراهن، لإظهار كيف أن الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، اتبعتا مسارات مماثلة طوال هذه الفترة الطويلة، وكيف امتد اعتماد أمريكا على بريطانيا وأوروبا لاحقاً.
في رواية شاملة تمتد على مدى ثلاثة قرون، يصف هوبكنز كيف أن ثورة مستعمرات البر الرئيسي كانت نتاج أزمة أصابت دول أوروبا الإمبريالية بشكل عام، وكيف أن تاريخ الجمهورية الأمريكية بين 1783 و1865 كان رداً على إنهاء النفوذ البريطاني، ولكن لتحقيق توسع مستمر.
ويبيّن المؤرخ البريطاني المتقاعد كيف أنّ تأسيس دولة أمريكية صناعية بعد الحرب الأهلية، بالتوازي مع التطورات في أوروبا الغربية، عزز تأثيرات مشابهة مزعزعة للاستقرار، ووجدت هذه الدولة منفذاً للإمبريالية من خلال اكتساب إمبراطورية معزولة في منطقة الكاريبي، والمحيط الهادئ. ويقول: «عكست فترة الحكم الاستعماري التي أعقبت تاريخ الإمبراطوريات الأوروبية شكلاً من تبريراتها الإيديولوجية، والعلاقات الاقتصادية والمبادئ الإدارية. وبعد عام 1945، أدى تحول عميق في طابع العولمة إلى إنهاء عصر الإمبراطوريات الإقليمية العظيمة».
موضوع الكتاب هو أحد أوجه التاريخ الأمريكي، وليس كل التاريخ الأمريكي، إذ يجد هوبكنز أن الموضوع لا يزال ضخماً، والمخاطر فيه هائلة.
حصار الكوت
يبدأ هوبكنز عمله بالحديث عن حصار الكوت (العراق) في الحرب العالمية الأولى، فقد كانت المدينة تابعة للإمبراطورية العثمانية، ولقي البريطانيون فيها بقيادة اللواء تشارلز فيرير تاونشند، هزيمة نكراء بآلاف القتلى، والجرحى. وكانت من أكبر المعارك حينها، وشكلت ضربة للإمبراطورية البريطانية التي بدأت بالانحدار من حينها، بعد أن كانت تلعب دور الشرطي العالمي من 1815 إلى 1914.
يقول هوبكنز: «قد يكون من غير المتوقع البدء بالحديث عن تاريخ الإمبراطورية البريطانية في كتاب يحمل عنوان «الإمبراطورية الأمريكية»، حتى إن اللواء تاونشند نفسه ما كان ليتوقع أن يأتي فشله في السيطرة على الكوت في سياق تحليلي بشأن الغزو الأمريكي للعراق في بداية القرن الواحد والعشرين. ومع ذلك، تتم إعادة اكتشاف التاريخ عندما يختلّ النظام العالمي، خاصة من قبل المحللين الذين يعودون إلى الأحداث الماضية لفهم جذور المشكلات الراهنة. فصدمة «11 سبتمبر» ربّما لم تغيّر العالم، كما قيل وقتها، كما أنها من غير شك حفّزت السياسة الخارجية الأمريكية، وشجّعت تقديرات جديدة بعيدة المدى لدور الولايات المتحدة في دعم ومضايقة النظام العالمي، وولّدت نوعاً هائلاً من دراسات الإمبراطورية».
ويضيف: «بهذه الطريقة، ينظر إلى النهاية المخزية لمسيرة تاونشند كحكاية رمزية لصعود وسقوط الإمبراطوريات. على العموم، تم الاختلاف على مغزى القصة. بالنسبة لبعض المراقبين، امتد تأثير حصار الكوت على أكثر من الكتيبة السادسة. هذا الحصار هيمن على الإمبراطورية البريطانية في ذروتها، وكانت اللحظة التي بدأ فيها الانحدار الحتمي، وسلمّت الإمبراطورية البريطانية عصا الحكم إلى وصي جديد وأكثر شراسة للحضارة الغربية وهي: الولايات المتحدة».
ويشير إلى أنه «من وجهة النظر هذه، فإن تاونشند كان سجين القوى الدورية التي كانت متنفذة إلى درجة كافية لتقوم بدعم، أو إسقاط الدول العظمى حتى»، ويرى أن «أحداث 1915، مثل التي حدثت في 2003، يمكن أن تكون لها نتيجة واحدة. فكل السلالات الصينية فقدت في النهاية «وصايتها على السماء»؛ والإغريق علموا أن «التكبر البشري» تجاوز قوة الإلهة «نمسيس» في الميثولوجيا الإغريقية؛ وابن خلدون وضع مراحل النمو، والتوسع، والتدهور للإمبراطوريات؛ والإيطالي جيامباتيستا فيكو وضع ثلاثة عصور متكررة للإمبراطوريات؛ كما أن نظرية المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي عن صعود وسقوط الحضارات جعل منه شخصية شهيرة في الولايات المتحدة. ويستمرّ «الانحداريون» الحداثيون في جسّ نبض الدولة في لحظات الكآبة، ويعيدون التأكيد على أن النهاية قريبة».
حاجة العالم إلى «زعامة»
معلقون آخرون تراجعوا عن التشاؤمية العنيدة التي بسطت هيمنتها على المستقبل، كما يرى هوبكنز، ويعلق على ذلك: «في رأيهم، كانت الولايات المتحدة هي السليل الشرعي للإمبراطورية البريطانية. ومصير تاونشند حدّد تحوّل المسؤوليات العالمية من قريب مسن إلى خلف فتي. وقدّم المنظرون السياسيون في الولايات المتحدة حججاً لدعم مزاعم أن العالم كان بحاجة إلى زعيم مهيمن، ومسيطر ليمنع حدوث الفوضى العالمية».
ويوضح أكثر: «جي أي. هوبسون توقع هذا الأمر في وقت سابق. فقد أشار بقوله إن الفلاسفة السياسيون في العديد من العصور توقعوا أن الإمبراطورية هي الضامن المناسب الوحيد للسلام، والتسلسل الهرمي للدول تطابق على نطاق أكبر النظام الإقطاعي ضمن دولة واحدة».
ويضيف: «علاوة على ذلك، يمكن التعلم من دروس التاريخ، إذ نجد أنه من خلال جمع القدرة التحويلية للتكنولوجيا المتقدمة، مع الرؤى النافذة للعلوم الاجتماعية الحديثة، يمكن لأي قوة عظمى أن تنزع السلاح من المعارضين لها، وتنشر التقدم عبر العالم، وتتجنب الانحدار. وبالانطلاق من هذا الموقف المشجّع، فقد تربّعت الولايات المتحدة على قمة عملية التطور الطولي الذي يملك أصولاً في تفاؤلية التنوير. فقد اعتقد كل من هيجل وماركس، في طريقتيهما المختلفتين جداً، أن القوى الجدلية سوف تحمل المجتمع إلى مستويات أعلى من الإنجاز. وبالنسبة لهنري مين، ألزمت العملية تغيراً من الحالة إلى العقد. وربط هيربرت سبينسر التطور الاجتماعي بالفردانية الثورية.
تالكوت بيرسونس عرف كيفية تحويل «التقليدي» إلى مجتمعات «حديثة». وأنتج «انتصار» سنوات التسعينات «نهاية التاريخ»».
بهذه الطريقة غير المتوقعة، يقدّم النظر في حصار الكوت أجندة تتضمن العديد من القضايا الأساسية في تاريخ الإمبراطوريات. فعلى وجه الخصوص، وضعت هذه الواقعة وتفسيراتها المرتبطة بها بعد غزو العراق في 2003، قيمة حالة الولايات المتحدة في سياق أبعد بكثير من حدودها الوطنية. وكانت إحدى الطرق لتحقيق هذا الموضوع هي من خلال التأكيد على الملحمة الوطنية في سياق عالمي، وإمبريالي بشكل محدد.

ارتباط تاريخي
يرى هوبكنز أن العولمة والإمبراطوريات مترابطة عبر ثلاثة قرون في هذه الدراسة. فالإمبراطوريات كانت تلعب دور المبتكرين الحازمين، ووكلاء العولمة. قائلاً: «سارت نبضات التوسّع والانكماش في انسجام: سلاسل السبب والنتيجة سارت في كلا الاتجاهين.
ومراحل العولمة الأساسية الثلاث المعرّفة في هذه الدراسة خضعت لأزمات تحويلية في نهاية القرن الثامن عشر، وفي أواخر القرن التاسع عشر، وفي منتصف القرن العشرين. وكان لكل مرحلة تأثير عميق في ثروات ومسار الإمبراطوريات. وكل تحوّل كان يتم عبر عملية جدلية غيّرت التراكيب الاقتصادية والسياسية للإمبراطورية، وغيّرت التوزع الجغرافي للحكم الإمبريالي، إلا أن نظرة عالمية تغيّر السؤال المطروح خلال بعض المواضيع الأساسية في تاريخ الولايات المتحدة. الأجوبة التي تقدّمها ينبغي أن تربط مصالح المجموعتين المختلفتين من المتخصصين: مؤرخو الولايات المتحدة ومؤرخو الإمبراطورية».
ويشير إلى أن التاريخ الذي يظهر من هذه المراحل المختلفة للعولمة الإمبريالية يقدّم قراءة بديلة لبعض التطبيقات المماثلة لمصطلح «الإمبراطورية». فتاريخ مستعمرات البر الرئيسي لبريطانيا في أمريكا الشمالية قبل 1783 يمكن أن تعاد صياغته لإظهار كيف أن النبضات المتحولة من خلال بدايات العولمة الحديثة كانت مدعومة أولاً ثم قوّضت التوسع الإمبريالي الذي عززته الحكومة المالية- العسكرية.
ويضيف: «السنوات بين 1783 و1945، التي يعرّفها المؤرخون بشكل رئيسي كقصة نمو الدولة ومسعاها إلى الحرية والديمقراطية، يمكن أن ينجذب أيضاً إلى نطاق التاريخ الإمبريالي. وفي الوقت الحاضر، الإمبريالية والإمبراطورية تقومان بظهور محدود فقط، بشكل نموذجي في دراسات التوسع القاري، وعلى ما يبدو في الوقائع الشاذة مثل: الحرب مع إسبانيا في 1898. وإذا ما تم النظر إلى التاريخ كتمرين مطوّل في إنهاء الاستعمار، فإنه على أي حال، يمكن فهم الفترة التي تعود إلى الحرب الأهلية كبحث عن الحكم الذاتي، خلالها بقيت الولايات المتحدة خاضعة لنفوذ بريطاني غير رسمي. والسنوات بين الحرب الأهلية والحرب الأمريكية – الإسبانية يمكن حينها أن تتم إعادة صياغتها لتؤكد على العمليات المشتركة لبناء الدولة، والتصنيع، وتحقيق الاستقلال الموضوعي، وتأسيس إمبراطورية تمتد إلى ما وراء البحار».
حدود القوّة الأمريكية
دشنت الحرب مع إسبانيا مرحلة جديدة في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية. فقد أصبحت الولايات المتحدة قوة استعمارية في الباسيفيك والكاريبي؛ ورغم ذلك فسجلها في توصيل نسختها من «مهمة التحضر» الغربية موجودة الآن تحت المراقبة. مع ذلك، فإن دراسة الحكم الاستعماري الأمريكي بين 1898 وإنهاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية تعتبر واحدة من أكثر المواضيع المهملة في تاريخ الولايات المتحدة، وتقدّم آفاقاً بحثية لجيل جديد من المؤرخين بحسب الكاتب.
ويقول حول ذلك: «إن عملية إنهاء الاستعمار في منتصف القرن العشرين ضمت إلى التغيرات في شخصية العولمة التي شكّلت عالماً متعدد الأعراق يتجاوز الحدود الوطنية. هذه المرحلة الجديدة كانت غير متوافقة مع خلق، أو إبقاء الإمبراطوريات الإقليمية. ومع ذلك، بعد 1945، خلق مصطلح «الإمبراطورية» الأمريكية ظهوره الأخير في دراسات تتحدث عن القوة الأمريكية غير الرسمية، وغير المباشرة، المفروضة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ويتم استكشاف هذه المفارقة الواضحة في نهاية هذه الدراسة البحثية التي تقيّم حدود القوة الأمريكية في عصر عولمة ما بعد الاستعمار.
ومن خلال وضع الفترة ككل في سياق الإمبراطوريات الغربية، بشكل عام، والنموذج البريطاني، بشكل خاص، من الممكن إدراك التوجهات المشتركة في ما اعتبر غالباً بطريقة، أو بأخرى، كقصة وطنية منفصلة.
ويمكن رؤية الثورة الأمريكية كامتداد لأزمة المقاطعات الخارجية التي كانت تنزل على الحكومات العسكرية- المالية لأوروبا في أواخر القرن الثامن عشر. وفي الفترة بعد 1783، لم تكن كثيراً قصة صعود «الحرية والديمقراطية» كشكل من الصراع بين المحافظين والإصلاحيين على شكل الدولة ما بعد الثورية التي عكست صراعات متشابهة في أوروبا بعد 1815.
ويرى هوبكنز أن «عملية بناء دولة صناعية-وطنية ردّدت صدى التطورات في أوروبا، من بينها التمدد إلى الإمبريالية العسكري. وفي معاينة لفترة الحكم الإمبريالي اللاحقة، يظهر أنه، بعد 1898، الإمبراطورية المنفصلة في جزيرة، والتي كسبتها الولايات المتحدة، عاينت نفس طرق الحكم التي عاينتها الإمبراطوريات الغربية الأخرى، وشعرت بنفس تذبذبات الثروة، ووصلت إلى نهايتها في الوقت نفسه، وللأسباب نفسها».
ويعود في خاتمة عمله إلى حصار الكوت ليقول إن «الرسالة من حصار الكوت هي أن الفشل في تقدير التغير الأساسي في الظروف التي تتم فيها ممارسة القوة، والطبيعة المتغيرة للقوة نفسها، حمل نتائج هائلة بالنسبة ل «النظام والفوضى» في العالم».
ويختم عمله قائلاً: «إن المستنقع في العراق، الذي يتميز بسهولة الانجذاب إليه، وبطء الغوص فيه، يعيد التأكيد على حكمة ابن خلدون في اعتقاده أن التاريخ هو، أو ينبغي أن يكون، فناً عملياً مطلوباً لأجل «اكتساب التفوق في الحكم». وعلى الرغم من أن «دروس التاريخ» محل نقاش، إلا أنه يمكن مناقشة مزاياه وعيوبه، على الأقل، لضمان أن السياسات تتشكل في ضوء الأدلة، وليس في وجهها. اليوم، المؤرخون غير ملتزمين بوضع أنفسهم في خطر جسدي نيابة عن حكوماتهم الوطنية، لأسباب ليس أقلها، على خلاف ابن خلدون، أنهم الآن أبعدوا عن ممرات السلطة»؛ وعلى الرغم من العلاقة بين المعرفة المختلة والسياسات المختلفة، لابد من السعي إلى إسماع الصوت رغم القوة الكبيرة التي تواجه المؤرخين والخبراء، كما يقول المؤلف.
نبذة عن الكاتب
أي. ج. هوبكنز، من مواليد 1938، أستاذ متقاعد لتاريخ الكومنولث في جامعة كامبريدج، والرئيس السابق لكرسي والتر بريسكوت ويب في التاريخ في جامعة تكساس في أوستن. له العديد من المؤلفات من بينها: «التاريخ العالمي: التفاعلات بين الدولي والمحلي»؛ و»العولمة في تاريخ العالم»، و»الإمبريالية البريطانية: 1688-2015»؛ و»التاريخ الاقتصادي لغرب أفريقيا». ويعيش حالياً في كامبريدج( إنجلترا).
ترجمة : نضال إبراهيم
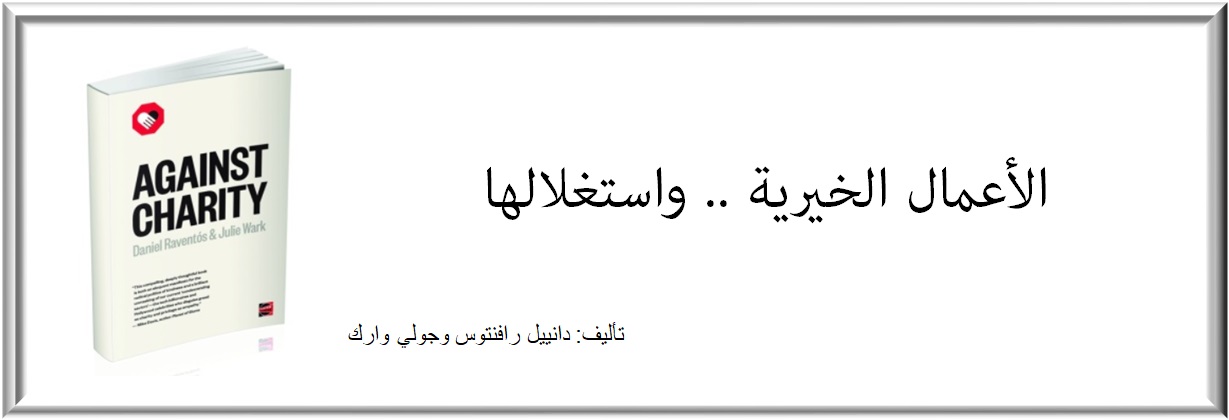
تصبح الأعمال الخيرية عديمة النفع إذا ما قدمت بطريقة تخدم الغايات السياسية، أو كانت غطاء على قضايا فساد، أو شكلاً للتهرب من الضرائب بالنسبة للشركات. للجمعيات والمؤسسات الخيرية الأمريكية والأوروبية قصص بعيدة عن الأضواء، تخفي وراءها قضايا كبرى تضرّ بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل متساوٍ. يحاول هذا الكتاب أن يكشف خبايا الجمعيات والأعمال الخيرية المرتبطة بالسياسيين والمشاهير، ويقدّم وجهة نظر بشأن كيفية تقديم الدعم للمتضررين والمحتاجين في العالم.
في كتابهما «ضد الأعمال الخيرية» يقدّم الكاتب الإسباني دانييل رافنتوس والمترجمة الأسترالية/الإسبانية جولي وارك تحليلاً متعدد الجوانب لفكرة العمل الخيري الذي يستهدف المنكوبين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية. يفنّد الكاتبان مفهوم الإحسان أو العمل الخيري من الجانب الفلسفي والاجتماعي والاقتصادي. ويقدمان رؤى تبدو للبعض صادمة حول واقع مسكوت عنه تغطيه الحملات الدعائية وتتستر عليه بروباجندا مدروسة تضيع معها المضامين الحقيقية للعمل الخيري.
يتألف الكتاب من جزأين؛ الأول «مشكلات» ويشمل مقدمة وثمانية فصول، والثاني «حل جزئي» ويضمّ فصلين. أما المقولة الرئيسية في الكتاب فتدور حول أهمية فهم أن العمل الخيري ليس هبة بقدر ما هو وجه من وجوه الليبرالية الجديدة.
العمل الخيري: الأصل والواقع
يكتب المؤلفان في المقدمة: «تعدّ كلمة لطيف، أو رؤوف kind ذات أصل جرمانيّ وترتبط بمعنى kin قريب أو نسيب. كان المعنى الأساسي للكلمة مرتبطاً بخاصية طبيعية أو فطرية، فبات، بالتالي، يعني طبقة متمايزة بخصائص موروثة، أو كما سيكون في القرن الرابع عشر، صفات مرتبطة بالكياسة أو الأفعال النبيلة التي تعبر عن المشاعر التي يكنها الأقرباء تجاه بعضهم. ثمة حسّ بالمساواة متضمن داخل هذه الكلمة، هناك أيضاً شيء من التآخي والاحترام.
أما الأعمال الخيرية، بمفهومها وشكلها المؤسساتي على الأقل، فقد تركت وراءها جميع تلك المعاني المبكرة مثل «الاستعداد لفعل الخير» و«المشاعر الخيّرة، والنية الطيبة والكياسة» لتأخذ بدلاً منها شكلها الحالي القائم على العلاقة بين مانحٍ ومتلقٍ، وهي تفتقد للمساواة على اعتبار أن المتلقي ليس في موقع من يمكنه القيام، أو الرد، بالمثل. لكنها مع ذلك لا تزال تظهر عادة كرأفة، وهذا يكون في الغالب طريقة لتغطية التفاوت القاسي المبنيّ داخل هذه العلاقة.
لهذا، مثلاً، كتب جاك لندن يقول: «العظمة التي تلقيها للكلب ليست بعمل خير. عمل الخير هو أن تشارك العظمة مع الكلب، عندما تكون جائعاً مثله».
فجوة طبقية واجتماعية
يشدد الكاتبان على الحاجة لوجود نظام اجتماعي عادل تنتفي فيه الحاجة للعمل الخيري فيكتبان: «النوع الأكثر شيوعاً من الأعمال الخيرية هو ذلك الذي أصبح مؤسساتياً، وهو الذي يكتب عنه الكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي في روايته «كثبان النمل في سافانا»: «بينما نقوم بالعمل الخيري، دعونا لا ننسى بأن الحل الحقيقي يكمن في عالم تصبح الأعمال الخيرية فيه غير ضرورية» ومع ذلك، فقد أصبحت الكلمة الفاعلة في السياسة هي «التفرقة»؛ الفجوة الكبيرة بين شديدي الثراء الغالبية وذوي الفقر المدقع، والتفرقة بين الرجال والنساء، والمواطنين واللاجئين، البيض والسود، نشوب النزاع بين مجموعة إثنية وأخرى، دين ضد الأديان الأخرى، «التقدم» ضد الكوكب، الخاص ضد العام، وهكذا دواليك. أما الحكومة، ولا سيما إدارة ترامب، فإنها تحرض على التفرقة لصالح قلة قليلة ممن يمتلكون السلطة، ما يؤدي إلى حرب صريحة ضد المجال الشعبي، الشعب ذاته، والخير العام. وبهذا، فإن الأعمال الخيرية المؤسساتية تعزز من قوة أصحاب الملايين المتخففين من عبء الضرائب الذين يوزعون إحسانهم على مشاريع تعود عليهم بالفائدة، مما يزيد من هوّة هذه الفجوة.
عنوان كتابنا هو ضد الأعمال الخيرية، لكن يمكن له، بشكل مساو، أن يكون «من أجل الرأفة»، وسيكون بالتالي دعوة لحقوق الإنسان العالمية ومبادئها الثلاثة العظيمة؛ الحرية، والعدالة، والكرامة. ربما بإمكان أيّ كان أن يقول إنه يطمح لامتلاك هذه المبادئ والتمتع بها، لكنها في الواقع لا تُعطى عبر الإحسان والأعمال الخيرية، لأن المساواة والتآخي خصائص أساسية بذاتها.
المشاهير والعمل الخيري
إذا نظرنا لمسألة الأعمال الخيرية من ناحية الشخصيات الشهيرة (celebrity)، فإنها لا تزال تأخذ توجهاً معقداً أكثر وغريباً في بعض الأحيان. يبدو الجدال حول الغيرية مراوحاً بين لماذا يهتم الناس (عموماً، دون النظر بشكل جدي إلى حقيقة أن الأثرياء يتباهون بمظهر الغيرية بينما قد يكون الأشخاص العاديون أسخياء أو رؤوفين لكن لا يعلم كثير من الناس بذلك) بالآخرين على حساب مصالحهم الشخصية. لكن ثمة أسئلة أخرى. منها مثلاً، يعطي شديدو الثراء جزءاً صغيراً من ثرواتهم، فلماذا يشعرون بأنهم مكلفون بامتلاك ما يزيد عن حاجتهم بكثير؟ لماذا يتسامح المجتمع معهم، بل ويقدسهم؟
يكمن أحد الأجوبة على ذلك في أن هذه هي النيوليبرالية الصلبة، والتي ترتبط بالنزعة الاستهلاكية. بدورها، تحتاج النزعة الاستهلاكية إلى الدعاية، وهذا ما يقوم به بعض المشاهير، الإحسان وعمل الخير ليس بغية إفادة الجنس البشري، وإنما كنوع من التسويق الذاتي.
اقتصاد القطاع غير الربحي
يعد القطاع غير الربحي اليوم ثامن أكبر اقتصاد في العالم، بوجود 19 مليون موظف يتقاضون الرواتب. ينخرط الكثير منهم في مجال العمل الإنساني والإغاثي حين تستمر الأزمات لوقت أطول، وتكون الحاجات متزايدة بسرعة كما في حالة التغير المناخي، والاقتصادات المنهارة والصراعات المميتة في أنحاء عديدة من العالم.
يعلق الكاتبان هنا: «هناك الكثير مما يمكن انتقاده في طريقة عمل المنظمات غير الربحية الكبيرة والصغيرة في مجال العمل الإنساني، لكن اهتمامنا هنا لا ينصب على انتقاد أفعالها أو أفعال عمال الإغاثة الأفراد ممن تكون، غالباً، دوافعهم حميدة في الأصل». ويضيفان: «لكننا نركز على العمل الإنساني كنوع من الأعمال الخيرية التي تعمل ضمن أنظمة جائرة وتنتج إقطاعية من المنح السخية. لكن إذا كان هذا القطاع ضخماً لهذا الحد، فلماذا لا نرى الأشخاص الذين يفترض أن يخدمهم هذا القطاع ظاهرين كثيراً في وسائل الإعلام؟».
تسييس الأعمال الخيرية
يبدو جلياً أن دونالد ترامب، الذي قال في إنديانابوليس في 28 أبريل/نيسان 2016: لدينا الكثير، الكثير من الدول التي نعطيها المال الوفير، ولا نحصل مطلقاً على أي شيء في المقابل، وهذا سيتوقف سريعاً»، لا يفهم المبدأ الأساسي للأعمال الخيرية، فهي ليست هبة، ومع ذلك فإنه يدعي أنه محسنٌ متحمس ومحب للخير – وهو وصفٌ أزيل من السيرة الذاتية المنشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة ترامب في أواخر عام 2016، قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. ويدعي أنه منح شخصياً مبلغ 100 مليون دولار للأعمال الخيرية خلال السنوات الخمس الماضية. لنقل إن الأعمال الخيرية من اختصاص مؤسسة دونالد جيه ترامب، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية بموظفين غير مدفوعي الأجر. لكن في واقع الأمر، فإن الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر ديفيد فارنتولد من صحيفة «واشنطن بوست» قد توصل في استقصاءاته إلى أن ترامب لم يتبرع بسنت واحد لمؤسسة دونالد جيه ترامب منذ عام 2008. بل إنه ببساطة يجتذب الأموال من الآخرين، وهو يعرف أن هذا غير قانوني على اعتبار أن المؤسسة غير مسجلة لتلقي مساهمات بهذه الطريقة.
هذه المؤسسة «العائلية» غير الاعتيادية تتلقى كل أموالها تقريباً من أشخاص آخرين. كانت الطريقة بسيطة. إذ ذهب دونالد ترامب إلى مؤسسة تشارلز إيفانز الخيرية في نيوجرسي، وطلب منهم تبرعاً لمؤسسة شرطة بالم بيتش. جمعت المؤسسة الخيرية مبلغ 150 ألف دولار وقدمته لمؤسسة دونالد جيه ترامب التي «تبرعت» به لاحقاً لمجموعة الشرطة التي تحمل اسم المؤسسة. يصبح الأمر أفضل عندما نعرف أن دونالد ترامب قد تلقى عام 2010 جائزة من مؤسسة شرطة بالم بيتش تقديراً منهم ل «دعمه الخيريّ». كما عقدت المؤسسة احتفالها في منتجع Mar -a- Lage الذي يملكه ترامب. وفي عام 2014، كشفت التقارير الضريبية أنهم دفعوا 276.436 ألف دولار لاستئجار المكان في تلك السنة وحدها.
وبحسب تحقيقات لوكالة أسوشيتد برس، فإن مؤسسة إريك ترامب (ابن دونالد ترامب) تستفيد من الأعمال الخيرية المرتبطة بعائلة ترامب وأفراد من مجلس الإدارة. إذ لوحظت دفعات مالية محوّلة باستمرار إلى أحد نوادي الجولف الخاصة المملوكة لدونالد ترامب ولمنظمات مرتبطة بعائلة ترامب من خلال المؤسسات أو العائلة أو العلاقات التي تدور حول المنح الخيرية.
ووفقاً لتقارير دائرة الإيرادات الداخلية، فقد جمعت مؤسسة إريك ترامب 7.3 مليون دولار بحجة دعم الأطفال المصابين بالسرطان، وجمع المبلغ بشكل رئيسي من مانحين ومتبرعين حريصين على التعامل مع عائلة ترامب (مثل الأشخاص الذين دفعوا 50 ألف دولار مقابل دعوة رباعية للعب الجولف والاستمتاع بالعشاء في حفل جمع أموال للمؤسسة عام 2015).
«بزنس» الصناديق الخيرية
أما رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فيفترض بمؤسسته الخيرية التي أصبحت تسمى الآن «غير الربحية»، أن تكون مكرسة للأعمال الخيرية المستقلة، مع وجود بلير كراع غير تنفيذي. لكنه كان حاضراً على الدوام كشخصية «سوبر ستار» تجذب الممولين المحتملين، حاصلاً على ملايين الجنيهات الإسترلينية من تبرعات أفراد أثرياء، والحكومة الأمريكية وحتى اليانصيب السويدي.
ثم هناك رجل الأعمال الأوكراني الكبير فيكتور بينتشوك، الذي منح مؤسسة توني بلير الخيرية مبلغ 320 ألف جنيه استرليني بغية مساعدة «الناس على فهم الدور الرئيسي الذي يلعبه الدين داخل المجتمع». كما منح بينتشوك 150 ألف دولار لمؤسسة ترامب، وبعده قام ترامب بمداخلة عبر الفيديو في منتدى «استراتيجية يالطا الأوروبية» السنوي عام 2015، وشدد فيه على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة تدابير أشدّ في تعاملها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما قدّم 8.2 مليون دولار لصندوق مؤسسة كلينتون، لتستضيفه لاحقاً وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على العشاء.
ويشدد المؤلفان على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق مؤسسة كلينتون الخيرية، التي ترتبط من خلال علاقات متينة مع عشرات رجال الأعمال النافذين والشركات الخاصة والشركات الحكومية وأخرى غير الحكومية لدعم الصندوق، وتلقي منح وهدايا بملايين الدولارات. وهي مبالغ يصفها الاقتصادي الأمريكي مايكل هدسون بأنها مخبأة في مرأى من أعين الجميع.
ففي عام 2001، إبان نهاية فترة رئاسة بيل كلينتون الثانية في البيت الأبيض، ادّعت المؤسسة، طبعاً، بأنها تستهدف «الحدّ من الفقر، وتطوير الصحة العالمية، وتقوية الاقتصادات، وحماية البيئة». لكن ما حصل في الواقع، أنه بحدود نهاية عام 2014، وصل مجموع أرصدة الصندوق ل 354 مليون دولار. أما أفراد عمل المؤسسة البالغ عددهم 486 شخصاً في 180 دولة فلم تكن لديهم سوى معرفة ضئيلة، أو معدومة، في العمل التنموي.
نبذة عن المؤلفين
– دانييل رافنتوس:
كاتب واقتصادي إسباني، يعيش في مدينة برشلونة. له عدد من المؤلفات منها: «الدخل الأساسي: الشروط المادية للحرية».
– جولي وارك:
هي كاتبة ومترجمة أسترالية تعيش في برشلونة. لها كتاب سابق بعنوان «بيان حقوق الإنسان».
ترجمة: نضال إبراهيم

مع انهيار الأحزاب التقليدية في جميع أنحاء العالم، ومع توقّع العديد من الخبراء حدوث «أزمة الديمقراطية»، تبقى قيمة الانتخابات كطريقة للاختيار من جانب من وكيف، يتم حكمنا موضع تساؤل. يحاول المنظّر الديمقراطي المعروف عالمياً آدم بيرزورسكي أن يسلط الضوء على عملية الانتخابات السياسية في ظل الديمقراطيات العالمية، ويطرح العديد من الأسئلة في هذا الكتاب، منها: ما فضائل ونقاط الضعف في الانتخابات؟ هل هناك قيود على ما يمكن تحقيقه واقعياً؟
في هذا الكتاب الصادر حديثاً عن دار «بولايتي» في 210 صفحات من القطع المتوسط يقدّم المنظّر الديمقراطي آدم بيرزورسكي، تحليلاً شاملاً للانتخابات والطرق التي تؤثر بها في حياتنا. ويشير إلى أن الانتخابات ناقصة بطبيعتها، لكنها تبقى أقل الطرق سوءاً في اختيار حكامنا. وفقاً لبروزورسكي، فإن أكبر قيمة للانتخابات – وهي بحد ذاتها موضع اعتزاز – هي أنها تعالج أي صراعات قد تنشأ في المجتمع بطريقة تحافظ على الحرية النسبية والسلام. ولكن تبقى المعضلة الصعبة وغير الواضحة، وهي إذا ما كان المرشحون سينجحون في القيام بتحقيق ذلك في ظل المناخ السياسي العالمي المضطرب في الوقت الراهن.
بعد المقدمة، يأتي الكتاب في قسمين أساسيين هما: أولاً: «كيف تعمل الانتخابات»؟ ويأتي في خمسة فصول هي: فكرة انتخاب الحكومات، حماية الممتلكات، التنافس على المنفعة اللاحزبية، خاتمة: ما المترسخ في الانتخابات؟ ثانياً: «ما الانتخابات التي يمكن ولا يمكن تحقيقها»؟ ويتألف القسم من سبعة فصول هي: مقدمة إلى القسم الثاني، العقلانية، التمثيل، والمحاسبة، وفرض التحكم على الحكومات، الأداء الاقتصادي، المساواة الاجتماعية والاقتصادية، السلام المدني، استنتاجات.
أزمة الديمقراطية
يقول الكاتب آدم بيرزورسكي إننا «نختار حكوماتنا عبر الانتخابات. تقترح الأحزاب السياسات وتقدّم المرشحين. ندلي بأصواتنا، ثم يتم الإعلان عن فوز أحدهم وفقاً لقواعد متأسسة بشكل مسبق. ينتقل الفائز إلى مكتب الحكومة والخاسر يعود إلى بيته. لبضع سنوات يحكمنا هؤلاء، وثم تكون هناك فرصة لنقرر إذا ما كنا سنعيد هؤلاء إلى مكاتبهم أو نرمي بالأشرار إلى الخارج. كل هذا أمر روتيني نتعامل معه على البديهة.
وفي توضيح لعلاقتنا بعملية الانتخاب يقول بيرزورسكي:»على الرغم من أن عملية الانتخابات معروفة ومألوفة، إلا أنها تبقى ظاهرة معقدة. ففي انتخاب نموذجي لواحد من اثنين، ينتهي الأمر بخسارة أحدهما. في الأنظمة الرئاسية، قليلاً ما يتلقى الفائز أكثر من 50 في المئة من الأصوات، والأنظمة البرلمانية متعددة الأحزاب، نادراً ما تكون الحصة الأكبر أعلى من 40 %. علاوة على ذلك، تجد العديد من الناس الذين صوتوا لأجل الفائزين يشعرون بالتخوف من أدائهم في المنصب. بالتالي يبقى العديد منا خائبي الأمل، سواء مع نتيجة أو أداء الفائز. ومع ذلك، تأتي الانتخابات بعد الانتخابات، وكثير منا يأمل أن يفوز مرشحنا المفضّل في المرة المقبلة وألا يخيّب أملنا«.
ويضيف في السياق ذاته:»الأمل والخيبة. الخيبة والأمل: هناك شيء ما غريب. التوضيح الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو الرياضة: فريقي المفضل في كرة القدم، هو أرسنال، لم يفز بأي بطولة منذ سنوات، لكن مع كل موسم جديد أتأمّل أن يفوز بالبطولة. بعد كل هذا، في عوالم أخرى من الحياة، نضبط توقعاتنا وفق الخبرات الماضية. لكن ليس في الانتخابات. فالأغنية المغرية للانتخابات لا يمكن مقاومتها. هل الأمر لا عقلاني«؟
ويوضح الكاتب أن الأسئلة المتعلقة بقيمة الانتخابات كآلية بموجبها نختار بشكل جماعي من يحكمنا وكيف سيقومون بذلك قد أصبح أمراً ملحاً على نحو خاص في السنوات القليلة الأخيرة، قائلاً:»في العديد من الديمقراطيات، تشعر أعداد كبيرة من الناس أن الانتخابات تديم فقط حكم المؤسسة الحاكمة، أو حكم النخب أو حتى حكم الحزب، بينما على الطرف الآخر يشعر العديد بصعود الأحزاب الشعبوية، القمعية، وغالباً ما تكون عنصرية ولديها رهاب من الأجانب. توجد مثل هذه المواقف بشكل مكثف على الجانبين، وهذا بدوره يولّد انقسامات عميقة، وحالات استقطاب، ويفسّر الأمر من قبل العديد من المثقفين بأنه «أزمة الديمقراطية» أو على الأقل علامة على عدم الرضا عن مؤسسة الانتخابات نفسها.
إعادة القرار للشعب
يتوقف الكاتب عند نتائج استطلاع يظهر أن الناس بشكل عام، والشباب منهم بشكل خاص، يعتبرون مسألة الديمقراطية أقل ضرورة عما كان عليه في الماضي، فقد كان حماسهم أكثر فيما مضى، لكن لم يعد الأمر كما قبل، حيث كان جل طموحهم هو أن يعيشوا في بلد يحكم بشكل ديمقراطي. بحسب الاستطلاع كلهم يدعمون ما يتردد من أن الديمقراطية تعيش في أزمة.
ويعلق الكاتب على هذه الفكرة قائلاً: ومع ذلك، لا شيء «غير ديمقراطي» حول نصر دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو صعود الأحزاب المعادية للمؤسسات الحاكمة في أوروبا. حتى أنه يكون أكثر تناقضاً عند قول الشيء نفسه حول نتائج الاستفتاءات المتنوعة، سواء فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بشأن الإصلاح الدستوري في إيطاليا (لكن بشكل ضمني جميع أوروبا)؛ فالاستفتاءات يفترض أن تكون أداة «الديمقراطية المباشرة» التي تعتبر من قبل البعض متفوقة على الديمقراطية التمثيلية. علاوة على ذلك، ففي الوقت الذي يطلق فيه علامة «فاشي» من دون مبالاة لتشويه سمعة هذه الأحزاب السياسية، نجد أن هذه الأحزاب، على خلاف الأحزاب في فترة الثلاثينات، لا تدافع عن استبدال الانتخابات بطريقة أخرى لاختيار الحكّام. ربّما يرونها بشعة، لكن هذه الأحزاب تقوم بحملاتها تحت شعار إعادة السلطة المغتصبة من قبل النخب إلى «الناس»، إذ يرون في هذا تقوية للديمقراطية».
ويضيف: «في الكلمات الدعائية لترامب كان يقول: حركتنا هي لأجل استبدال المؤسسة السياسية الفاسدة والفاشلة بحكومة جديدة تتحكمون بها أنتم، أيها الشعب الأمريكي». واليمينية الفرنسية مارين لوبان وعدت «بالدعوة إلى إجراء استفتاء على أوروبا، حيث تقررون فيه أنتم، أيها الشعب». ببساطة إنهم ليسوا ضد الديمقراطية. كما أنهم من خلال عملهم، ليس هناك من هو ضد الديمقراطية بشأن أناس يريدون أن تكون لديهم حكومة«قوية أو على قدر من الكفاءة ومؤثرة»، بحسب الاستجابات إلى أسئلة الاستطلاعات التي زادت بشكل متتالٍ خلال السنوات الأخيرة، وفيها يفسر بعض المعلقين ذلك بأن ما يحدث عرض من أعراض تراجع الدعم للديمقراطية.
التوجّه نحو الإصلاحات
وفي سياق توضيحه أكثر يجد الكاتب أن عدم الرضا عن نتائج الانتخابات لا يمكن اعتبارها بنفس سوية حالات عدم الرضا عن الانتخابات كآلية اتخاذ القرار الجمعي، ويقول:»صحيح أن إيجاد نفسك على الجانب الخاسر لا يمكن القبول به. لكن تظهر الاستطلاعات حقاً أن نسبة الرضا عن الديمقراطية أعلى بين من صوتوا لأجل الفائزين. تظهر في الانتخابات العديد من المنصات التي يتحدث فيها الفائزون أكثر من الخاسرين، لكن على العموم، يقدّر الناس ويصوتون لحزب يمثّلهم ويعبّر عن آرائهم، حتى وإن انتهى بهم الأمر على الجانب الخاسر. (بناء على دراسة هاردينغ في 2011 التي غطت 40 استطلاعاً من 38 دولة بين 2001 و2006).
عندما ينهض الناس للاحتجاج ضد «المؤسسة الحاكمة»، غالباً ما يقصدون أنهم إما أن الحزب لا يمثّل آراءهم أو أن الحكومات تتغير من دون تحقيق أي تأثير في حياتهم، مشيرين إلى أن الانتخابات لا تولّد التغيير. لكننا، والغالبية العظمى كذلك، نستطيع تقدير آلية الانتخابات حتى وإن كانت نتائجها لا تروق لنا».
يعاين الكاتب العديد من الأسئلة، ويحاول في إجاباته التعامل مع الانتخابات كما هي بشكل واقعي، مع كل العيوب والأخطاء الموجودة فيها، ودراسة فرض تأثيراتها في الأشكال المتنوعة لوجودنا الجمعي، ومن هذه الأسئلة:«لماذا ينبغي ولماذا يتوجّب علينا أن نقدّر الانتخابات كطريقة لأجل اختيار من يحكمنا والطريقة التي حكمنا بها؟ ما فضائلهم، نقاط ضعفهم، وحدودهم»؟
يشير الكاتب إلى أن بعض الانتقادات الشعبية للانتخابات، بشكل خاص من هؤلاء الذين لا يقدمون أي خيار ويعتبرون أن المشاركة الانتخابية الفردية غير فعالة، يجدهم مخطئين، بناء على فهمهم غير الصحيح للانتخابات كآلية بموجبها نقوم باتخاذ قرار جماعي.
ويفترض أنه في المجتمعات التي يكون فيها للناس آراء ومصالح متضاربة، يكون البحث عن العقلانية أو «العدالة» أمراً ميؤوساً منه، لكن تلك الانتخابات تقدّم توجيهات وتعليمات للحكومة لتقليل حجم عدم الرضا مع كيفية حكمنا. ويقول:«سواء اتبعت الحكومات هذه التعاليم أو التوجيهات وسواء عملت الانتخابات على إزالة الحكومات التي لا تتبعها حينها تكون أكثر شكوكية؛ الحكومات التي تكون سيئة جداً تكون خاضعة لقوانين انتخابية، لكن هامشها للتهرب من المسؤولية كبير جداً».
ويعبّر الكاتب عن خشيته تجاه عملية الانتخابات قائلاً: «أخشى أن التوقع الدائم والمستمر للانتخابات بفرض تأثيرها في خفض التفاوت الاقتصادي يتسم بالهشاشة في المجتمعات التي تكون فيها الملكية الإنتاجية في يد قلة من الناس، وتوزع فيها الأسواق بشكل غير متساوٍ الدخل (الرأسمالية)».
ويضيف:«قيمة الانتخابات الكبرى هو أنها على الأقل تحت بعض الشروط تسمح لنا بالتحرك في حرية نسبية وسلام مدني مهما كانت الصراعات الموجودة في المجتمع، فهي تمنع العنف. هذه وجهة نظر تدافع عن الاعتدال السياسي (تشرشلية)، والمقتنعون بها يقرّون أن الانتخابات ليست جميلة جداً، ولم تكن أبداً «عادلة» جداً، وهي عاجزة عن مواجهة بعض الحواجز التي تظهر أمامهم في مجتمعات محددة».
في التعامل مع آلية الانتخابات يرى الكاتب أنه لا طريقة سياسية لاختيار حكامنا، ويقول: لا يمكن لأي نظام سياسي أن يجعل المشاركة السياسية للجميع فعّالة بشكل فردي. لا يمكن لنظام سياسي أن يكون وكيلاً مثالياً للمواطنين. لا يمكن لنظام سياسي أن ينتج ويحافظ على درجة المساواة الاقتصادية في المجتمعات الحديثة التي يكون فيها العديد من الناس مهووسين بالهيمنة. السياسة بأي شكل أو نمط، لديها حدود في صياغة وتحويل المجتمعات والتأثير فيها. هذه حقيقة حياتية معاشة. أعتقد أنه من المهم معرفة هذه الحدود، لكي لا ننتقد الانتخابات لعدم تحقيقها ما لا يمكن لأي ترتيبات سياسية أن تحققها. ولكن هذا لا يعني الرضا والتسليم بالوضع القائم مع كل مشكلاته. إدراك الحدود يساعد في توجيه جهودنا نحو هذه الحدود، ويوضح الاتجاهات لأجل الإصلاحات المناسبة.
في خاتمة هذا العمل لا يبدو الكاتب متفائلاً أمام ما يحدث من حالات استقطاب سياسي على مستوى عال في العالم، ولكن يعبر عن رغبته في عدم التوجه نحو انقسامات فعلية تؤدي إلى صراعات في مجتمعات بقيت لفترة من دون حروب.
نبذة عن الكاتب
ولد أستاذ العلوم السياسية الكاتب البولندي- الأمريكي آدم بيرزورسكي 1940 في وارسو، بولندا. تخرّج في جامعة وارسو في عام 1961. وبعد ذلك بوقت قصير، انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في جامعة نورث ويسترن في عام 1966. يعدّ اليوم من بين أهم المنظّرين والمحللين المهمين للمجتمعات الديمقراطية، ونظرية الديمقراطية والاقتصاد السياسي.
يعمل حالياً أستاذاً في قسم السياسة في قسم ويلف فاميلي للسياسة في جامعة نيويورك. حاضر في العديد من الجامعات منها: جامعة شيكاغو، حيث حصل على لقب مارتن رايرسون كأستاذ الخدمة المتميز، كما حاضر في جامعات خلال زيارات إلى الهند وتشيلي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا. منذ عام 1991، كان عضواً في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وشارك عام 2001 في جائزة وودرو ويلسون لكتاب الديمقراطية والتنمية. في 2010، حصل على جائزة يوهان سكايت في العلوم السياسية «لرفع المعايير العلمية المتعلقة بتحليل العلاقات بين الديمقراطية والرأسمالية والتنمية الاقتصادية». له العديد من الكتب البارزة منها: الرأسمالية والديمقراطية الاجتماعية (1985)؛ «الديمقراطية والسوق: الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية» (1991)؛ «الدول والأسواق: الكتاب الأول في الاقتصاد السياسي» (2003)؛ «الديمقراطية وسيادة القانون» (2003).
ترجمة: نضال إبراهيم

اختفت أزمة الهجرة واللاجئين في أوروبا عن نشرات الأخبار مؤخراً، رغم أن تأثيرها على الأجندة السياسية استمر في جميع أنحاء القارة. وعلى الرغم من أن هناك مشاهد مأساوية، كما هو الحال مع الصورة المروعة للطفل السوري آلان كردي المسجّى على شاطئ بودرم التركي، إلا أنه في معظم الأحيان تضيع القصص الفردية للفارين من الحروب وسط الهستيريا الإعلامية الغربية التي تدعو إلى تخفيض أعداد المهاجرين وإغلاق أبواب القلعة – أوروبا. تحاول الصحفية هسياو-هونج باي في عملها هذا نقل حقيقة القصص الإنسانية المؤثرة التي يحاول الكثير من الأوروبيين إبقاءها بعيداً عن الأعين والأذهان.
سافرت هسياو-هونج باي إلى مناطق ودول عديدة بهدف لقاء المهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا يصلون للتو إلى شواطئ لامبيدوزا أو صقلية، وكيف كان يتم استيعابهم في مخيمات استقبال سيئة. وتتطرق في تفاصيل الكتاب إلى حياة طالبي اللجوء في إيطاليا وألمانيا، حيث واجه البعض منهم مضايقات من المجموعات اليمينية المتطرفة، وعاش آخرون ظروفاً مروعة في المخيمات على ساحل شمال غرب فرنسا.
يقع الكتاب الصادر حديثاً عن «نيو إنترناشيناليست» في 240 صفحة من القطع المتوسط باللغة الإنجليزية. ويحتوي على ستة أقسام هي: بوابة لأوروبا، تجارة استقبال اللجوء في صقلية، السير من تحت الأرض، التوجّه شمالاً؛ جيتوهات أوروبا، غابة باريس.
أزمة اللاجئين
تقول الكاتبة إن كلمات مثل «أزمة اللاجئين» أو «أزمة المهاجرين» من المصطلحات التي تستخدمها وسائل الإعلام الأوروبية السائدة لتخبرنا عن حالة الأشخاص الذين لا يملكون رؤوس الأموال، والفارين من الصراعات، والحروب. هذه المصطلحات المستخدمة تدخل في سياق لعبة الأرقام، وزرع فكرة لدى الرأي العام أن «أوروبا لا يمكن أن تحتمل أكثر من ذلك». في نهاية المطاف، يتم من خلال هذه المصطلحات الحفاظ على مفهوم «نحن» و«هم» وترسيخها.
وتضيف: «عندما قرأت لأول مرة هذه المصطلحات الإعلامية، واستمعت إلى اللغة المستخدمة في التعامل مع وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، كانت الأسئلة التي أردت طرحها هي: من يعرّفها على أنها «أزمة»؟ لماذا هي «أزمة»؟ ما هي طبيعة «الأزمة»؟».
وترى أنه في العالم غير المتكافئ الذي نعيش فيه، حيث شمال الكرة الأرضية يحدد ويكتب التاريخ نيابة عن الجنوب، يتم نشر معرفتنا للعالم والتحكم فيها من خلال المؤسسات القوية للنخب الحاكمة في الشمال، وفهمنا للأحداث العالمية وغالباً ما يتم تشكيلها وتوجيهها من قبل هذه المؤسسات.
على عكس الرأي السائد الذي ينظر إلى وصول اللاجئين والمهاجرين من ناحية الأمن وإدارة الهجرة، يطرح هذا الكتاب نهجاً بديلاً يضع القراء في قلب الصورة الحقيقية. وتقول الكاتبة: «بصفتي شخصاً لم يولد في بريطانيا، وعاش فقط هنا منذ أن كان عمره 21 عاماً، فهمت دائماً ماذا يعني أن تكون «غريباً»، ومدى صعوبة إسماع صوتك إلى الرأي العام. خاصة أن المؤسسات الإيديولوجية النافذة، مثل وسائل الإعلام، تحرص على عدم إسماع قصة «الغريب» إلا نادراً، وعندما يحدث ذلك، غالباً ما تُعرض القصة كإحصائيات وبيانات مجرّدة من الحالة الإنسانية. وبطريقة ما، من خلال عمل وسائل الإعلام، الواقع المأساوي لعشرات الآلاف من الأرواح التي فقدت في البحر لم يحرك ساكناً».
الموت على أبواب أوروبا
يتم تصوير اللاجئين والمهاجرين، في أحسن الأحوال، كضحايا بحسب ما تقول الكاتبة. وتوضح أنه في الذهنية الجمعية العامة، ليس لديهم وجوه أو أسماء. وسعت في عملها إلى تغيير هذه الصورة من خلال تناول القصة من جانب آخر، من عيون اللاجئين والمهاجرين، وتعمقت في حقيقة الأشخاص الذين فروا من الاضطهاد والنزاع والفقر المدقع، حيث خاطروا بحياتهم لعبور البحر، ثم وجدوا أنفسهم عالقين في نظام غير مصمم لتوفير الحماية لهم، ولكنه غالباً ما يسعى إلى الاستفادة منهم والحفاظ على تهميشهم. تتناول الكاتبة قصة الذين تشكلت حياتهم ومصائرهم على حدود أوروبا، حيث اتبعت رحلتهم أثناء انتقالهم من ملجأ إلى آخر، من الجنوب إلى الشمال، ومن بلد إلى بلد، ووثقت ظروفهم وتطلعاتهم.
بذلت الكاتبة جهداً بحثياً كبيراً في الأرقام والإحصائيات أيضاً، ومما تذكره في الكتاب: «فقد أكثر من خمسة آلاف مهاجر حياتهم عبر البحر المتوسط وبحر إيجة في عام 2016، حيث غرقوا أو خنقوا أو سحقوا أثناء العبور. لقد مات أكثر من 25 ألف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا أو البقاء فيها منذ عام 2000. وفي منتصف عام 2017، شهدنا الآلاف يفقدون حياتهم في البحر أثناء رحلتهم إلى أوروبا».
وتضيف: «بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالرحلة عبر البحر وتمكنوا من الوصول إلى أوروبا، بدأت مرحلتهم التالية من البؤس. ترى ذلك البؤس في أنظمة استقبال اللجوء عبر دول الاتحاد الأوروبي في الخطوط الأمامية، والناجمة عن تعهيد المرافق وخصخصتها. ترى ذلك في «نظام النقاط الساخنة» الذي تفرضه المفوضية الأوروبية، والذي يعمل فقط كإجراء يرفض الأكثرية ويحمي أقل عدد منهم.. ترى البؤس عند المهاجرين الذين يواجهون البرد القارس والثلوج دون ملاجئ في جزيرة ليسبوس لأنهم كانوا محاصرين وسط حالة من الغموض، كنتيجة مباشرة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ترى مهاجرين ليس لديهم مكان يلجؤون إليه وينامون في الشوارع، وسط أوروبا الغربية «المتحضرة». ومع وجود مؤسسات قوية، كان من الصعب على الدوام تحدي المفهوم السائد للهجرة، وتصحيح رواياتهم عن اللاجئين والمهاجرين، وأصبح الأمر أعقد بشكل متزايد منذ الأزمة المالية. لقد نمت الأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة بشكل مطرد، مستفيدة من الأوقات الاقتصادية السيئة. في العقد الماضي، ساهمت سياسات التقشف التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في استياء متزايد، حيث كان هناك قدر كبير من سوء توجيهه ضد «الأجانب»، وبعبارة أخرى، ضدّ اللاجئين والمهاجرين».
قوانين صارمة
وبحكم وجودها في بريطانيا، تنتقد الكاتبة السياسة البريطانية في مسألة اللجوء قائلة: «فشلت بريطانيا دائما في الوفاء بالتزاماتها الدولية لاستقبال اللاجئين، وتهربت من مسؤولياتها حتى عندما أصبحت أعداد أكبر من اللاجئين تدخل أوروبا في عام 2015. وبعد تعهد ديفيد كاميرون الذي يرثى له، فقد قررت حكومته أخذ 20 ألف لاجئ سوري من مخيمات اللاجئين بحلول عام 2020، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي ذهبت أبعد من ذلك، ليس فقط ضد عمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، التي وصفتها بأنها عامل جذب، ولكن أيضاً «جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لطالبي اللجوء عند وصولهم إلى بريطانيا، وأبقت خدمات الاستقبال في مراكز اللجوء بيد شركات خاصة، وباتت تقدم لطالبي اللجوء دعماً مالياً غير كاف، وعرّضتهم لظروف معيشية مروعة».
وتضيف: «تستمر حكومة حزب المحافظين في رفض المشاركة في استقبال اللاجئين: تم تقديم ثلاثة بالمئة فقط من طلبات اللجوء في أوروبا في بريطانيا. في عام 2016، تلقت بريطانيا فقط حوالي 39 ألف طلب لجوء، مقارنة بحوالي 723 ألف طلب في ألمانيا، وحوالي 124 ألف طلب في إيطاليا، وحوالي 86 ألف طلب في فرنسا. أصبحت السياسات المناهضة للاجئين والمهاجرين التيار الأبرز في جميع أنحاء أوروبا الغربية».
كما تتوقف الكاتبة عند سياقات اللجوء في عدد من الدول من بينها هنغاريا، التي تقول الكاتبة عنها: «في هنغاريا، رئيس الوزراء فيكتور أوربان من فيدس – الاتحاد المدني المجري اليميني من أشد المعجبين بدونالد ترامب. وبالإضافة إلى إغلاق الحدود مع كرواتيا في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وضع المزيد من الضوابط على الشرطة بين البلدين، واقترح احتجاز اللاجئين في معسكرات حدودية حيث يتم تقييد حرية تنقلهم بالكامل».
وتتحدث عن الدنمارك أيضاً قائلة: «في عام 2016، أصدرت الدنمارك قانوناً صارماً يسمح لسلطات الشرطة الدنماركية بالبحث والاستيلاء على الأشياء الثمينة لدى طالبي اللجوء (تقدر قيمتها بأكثر من 10000 كرونة، أو 1600 دولار)، وذلك لتغطية تكاليف السكن والطعام. والأسوأ من ذلك هو أن القانون الدنماركي يضمن أيضاً أن على اللاجئ الانتظار ثلاث سنوات قبل أن يتمكن من تقديم طلب لمّ شمل لعائلته للقدوم إلى الدنمارك».
لطالما كان لدى الدنمارك – بحسب الكاتبة – مستوى منخفض من طلبات اللجوء يتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف طلب سنوياً قبل عام 2014. وحتى عندما فرّ عشرات الآلاف من سوريا وحاولوا الدخول إلى أوروبا، لم تستقبل الدنمارك سوى 15 ألف طلب لجوء في عام 2014، ولم يُمنح سوى 6 آلاف شخص منهم تصريح الإقامة. في عام 2015، عندما كانت ألمانيا تستقبل حوالي 800 ألف طالب لجوء، كان لدى الدنمارك فقط 18.500 طلب، ولم يتم منح سوى 10 آلاف منهم حق الإقامة.
اختبار ضمير أوروبا
في بلد لم يتأثر مشهده الاقتصادي بوجود اللاجئين والمهاجرين، لا شك أن الخوف من «الغزو» هو نتيجة للتلاعب السياسي كما ترى المؤلفة. وتستشهد بما قاله المؤلف الدنماركي مارتن بيترسن الذي كتب بشكل مكثف عن الهجرة في أوروبا، والذي يشعر بالفزع والحزن لأن الأغلبية في البرلمان الدنماركي صوتت على هذه القوانين. بحث بيترسن في رحلة اللاجئين وظروفهم في لامبيدوزا في بداية الألفية، واستوحى كتاباته من الصحفي الإيطالي فابريزيو جاتي الذي قام بأعمال سرية من أجل الكشف عن مصير اللاجئين البائسين في أوروبا. شهد بيترسن نفسه الظروف المعيشية غير الإنسانية والمعاملة القاسية للاجئين والمهاجرين – مثل الضرب واستخدام اللغة العنصرية – في مراكز الاستقبال الإيطالية، والذي أعاد تسمية «حديقة الحاويات» في روايته «خروج سوجارتاون».
تؤيد الكاتبة ما ذهب إليه بيترسن في القول أن وصول اللاجئين هو اختبار لضمير أوروبا ونظامها الأخلاقي. ومما تذكره من كلام بيترسن: «قبل بضعة أعوام، كان عدد قليل جداً من الناس في الدنمارك يعرفون أو كانوا مهتمين بما يحدث في لامبيدوزا ومالطا واليونان وإيطاليا وإسبانيا. لكن منذ سبتمبر/أيلول 2015 عندما شوهد اللاجئون السوريون وتم تصويرهم وهم يسيرون شمالاً على طول الطرق السريعة في جنوب جزيرة جوتلاند السويدية، أعتقد أن أعين الكثير من الناس تفتحت. وكانت ردود الفعل كثيرة. من الرجل الذي بصق على اللاجئين من جسر فوق الطريق السريع، إلى الناس الذين توجهوا نحو الحدود الألمانية في سياراتهم وأوصلوا اللاجئين إلى كوبنهاجن، حتى يتمكنوا من الوصول إلى السويد بشكل أسرع. بعض الدنماركيين الذين ساعدوا السوريين حوكموا، وربما عوقبوا بتهمة الاتجار بالبشر، رغم أنهم في هذه الحالة كانوا ينقلون اللاجئين السوريين، بدون أي أجر، من الحدود الألمانية إلى العبّارات أو الجسر إلى السويد.
بيترسن يشعر بالخزي من السياسات الدنماركية بحق طالبي اللجوء. حتى أن حزب يمين الوسط الحاكم، فينستري، المدعوم من قبل حزب الشعب الدنماركي المناهض للمهاجرين كان يريد إغلاق الحدود، قال علناً إن هذه القوانين يتم إصدارها بشكل أساسي لإبقاء الناس بعيداً وإخافتهم من طلب اللجوء في الدنمارك. ولسوء الحظ، 20٪ من الدنماركيين يصوتون لحزب الشعب الدنماركي، ويحبّون هذا القانون. حتى البعض يريد قوانين أكثر صرامة».
تجد الكاتبة أن هناك قلة من الكتّاب والصحفيين يواجهون عقبات صعبة، خاصة عند الإبلاغ عن الهجرة وتقديم الحقائق بصدق. ويكون التحدي الأول دائماً الابتعاد عن حدود وسائل الإعلام السائدة والخطاب السياسي المهيمن، وذلك من خلال طرح بعض الأسئلة مثل: من يحدد «الأزمة»، لماذا هي «أزمة»، وما هي طبيعة «الأزمة»؟
يكشف هذا العمل البحثي عن العنف الهيكلي الذي وضعته النخبة في الشمال، ونظرتهم إلى اللاجئين والمهاجرين المحاصرين في نظام الهجرة المتبع في الاتحاد الأوروبي، وتصنيفهم على أنهم مجرد أرقام في الميزانيات العمومية لسلسلة استقبال اللجوء، حيث يتم التعامل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم على أنها غير ذات صلة.
ونختم بما تقوله الكاتبة: «إن الأزمة الحقيقية التي نواجهها هي أزمة عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لأشخاص من الجنوب يفرون من ظروف بائسة بحثاً عن ملجأ وإقامة. الأزمة الحقيقية هي فشل الاتحاد الأوروبي الهائل في إحباط هؤلاء».
نبذة عن الكاتبة
هسياو-هونج باي من مواليد 1968 تايبيه،( الصين الوطنية). نشرت وتنشر في العديد من الصحف والمواقع العالمية باللغة الإنجليزية والصينية. ومؤلفة للعديد من الأعمال منها كتاب همسات الصينيين: قصة جيش العمال المخفي لبريطانيا(2008)، وصل للقائمة القصيرة في جائزة أورويل للكتاب لعام 2009، رمال متفرقة: قصة المهاجرين الريفين في الصين(2012)، وفائزة بجائزة بريد آند روزيس في 2013، والمخفي: تجارة العاملات لأجل الجنس في بريطانيا2013، شعب أبيض غاضب: وجهاً لوجه مع اليميني البريطاني المتطرف (2016). تعيش باي في المملكة المتحدة منذ عام 1991، وتحمل شهادات الماجستير من جامعة ويلز، وجامعة دورهام وجامعة وستمنستر. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة فو جين الكاثوليكية في نيو تايبيه.
ترجمة: نضال إبراهيم
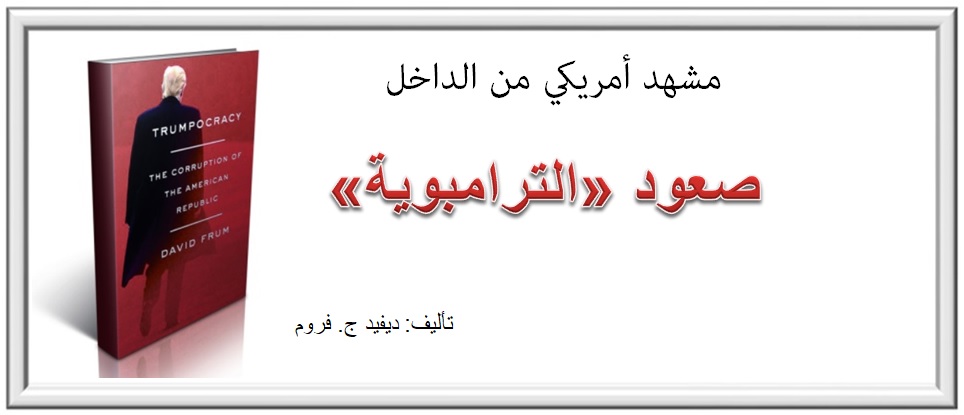
كان الكاتب ديفيد فروم يجمع الأكاذيب، والتشويش، والتجاهل الصارخ للقيود التقليدية المفروضة على مكتب الرئاسة الأمريكية لفترة طويلة، وساعدته بشكل خاص فترة عمله في البيت الأبيض ككاتب خطابات لجورج بوش، حيث شهد الطرق التي كانت فيها الرئاسة مقيدة، ليس بموجب القانون، بل بالتقاليد، والأعراف، والاحتجاج العام، لكن كلها ضعفت الآن. يجد في عمله هذا أنه سواء دامت رئاسة ترامب عامين، أو أربعة، أو سبعة أعوام أخرى، فإن طبيعة الرئاسة تغيرت إلى الأسوأ، ومن المرجح أن تظل كذلك لعقود من الزمن.
في كتابه الجديد هذا المقسم إلى اثني عشر فصلاً، الذي يقع في 320 صفحة من القطع المتوسط الصادر عن دار «هاربر» للنشر باللغة الإنجليزية، يوضح فروم أن العمل الشاق للانتعاش في الرئاسة الأمريكية يبدأ من الداخل الأمريكي. ويشير إلى أن «ترامبوكراسي»، أو «الترامبوية» توضح كيف أن ترامب يمكن أن يدفع أمريكا نحو الليبرالية، وعواقب ذلك على الشعب الأمريكي، وشعوب العالم، والتدابير الممكن القيام بها لمنعها.
ولتوضيح عنوان الكتاب، ننطلق من كلمة «الديمقراطية» التي في مناهج التربية المدنية في المدارس تعود بأصلها إلى كلمتين إغريقيتين هما «الناس» و«الحكم». وسمّى هذا الكتاب «ترامبوكراسي» لأنه دراسة الحكم القائم في الولايات المتحدة، وليس دراسة شخصية ترامب. الموضوع هو سلطة الرئيس ترامب: كيف استطاع أن يكسبها؟ كيف استخدمها؟ ولماذا مع ذلك لم تتم مراجعتها بشكل مؤثر؟
يقول الكاتب حول ذلك: «أي رئيس أمريكي ليس زعيم قبيلة، يحكم بالكاريزما الشخصية لديه، أو بقوة مجردة. الرئيس (ربما يوماً ما الرئيسة) يمارس مهامه عبر الأنظمة؛ عبر حزب في الكونجرس والولايات؛ عبر منظمات إعلامية داعمة؛ عبر شبكات سياسية وطنية من المتبرعين والناخبين؛ عبر مئات الطواقم المتضمنة في مصطلح «البيت الأبيض»؛ وعبر آلاف الموظفين القدامى الذين معاً يديرون الفرع التنفيذي».
ويضيف: «كذب ترامب بالطبع بشكل سيئ، بشأن تاريخه الخاص في ما يتعلق بحرب العراق. وكرر فانتازيا بشأن معارضة الحرب بشدة، مضمونها أن الرئيس جورج دبليو بوش أرسل ممثلين له إلى ترامب يناشدونه ليبقى هادئاً. كل هذا كان غير صحيح تماماً. ومع ذلك، لا يهم إذا كان غير صادق حول تاريخه الشخصي، إلا أنه حطم كل التابوهات التي أسكتت الصدق والنزاهة في الآخرين».
كسر القيود
هذا الكتاب هو قصة الذين يمكّنون، ويدعمون، ويتعاونون مع دونالد ترامب. العديد من هؤلاء الناس وجدوا طرقاً للتعبير عن عدم راحتهم الشخصية، وانزعاجهم من ترامب. تلك التعابير يمكن أن تكون على نحو صحيح بدرجة أقل، أو أكثر. ربما تصبح في أحد الأيام مهمة، كما يقول الكاتب. ويضيف أنه «في الوقت الذي يتخلى فيه أنصار ترامب عنه، سيبقى في حالة من العزلة والعجز، وسيصبح سناً ميتاً في لثة الحكومة الأمريكية. ومع تلك الفرصة التي اكتشفها، والخطر الذي قدّمه لن ينتهي مع الحياة المهنية لدونالد ترامب. فنقاط الضعف التي استغلها ترامب سوف تبقى نقاط ضعف قائمة. وكذلك مزّقت القرارات السياسية والاتجاهات الاقتصادية بعمق الولايات المتحدة المعاصرة، إلى جانب ترسيم خطوط الطبقة، والعرق، والدين، والأصل الوطني، والهوية الثقافية. حتى إن الروابط بين الرجال والنساء أصبحت ضعيفة. تلك ليست ادعاءات بلاغية، بل حقائق قابلة للقياس. التنوع يستدعي عدم الثقة، وعدم الثقة المتبادلة بين الأمريكيين كانت المصدر السياسي الأكثر أهمية لدونالد ترامب».
ويضيف الكاتب: «من روسيا إلى جنوب إفريقيا، ومن تركيا إلى الفلبين، ومن فنزويلا إلى المجر، حطم القادة السلطويون القيود المفروضة على قوتهم. وتآكلت حرية وسائل الإعلام والقضاء في ظلهم. صحيح أنه لا يزال الحق في التصويت قائماً، لكن الحق في أن يُحسب صوت واحد بنزاهة لم يعد موجوداً. حتى إنه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، أصبح انحدار الديمقراطية العالمي مصدر قلق لشعوب أخرى في أنحاء العالم. هذا التفاؤل الذي يبعث على الرضا عن النفس قوبل بالصعود السياسي لدونالد ترامب».
ويشير الكتاب إلى مكمن الخطورة قائلاً: «الأزمة على الأمريكيين، هنا والآن. بهدوء، وثبات، يدمّر ترامب وإدارته المبادئ والممارسات المقبولة للديمقراطية الأمريكية، وربما بشكل لا رجعة فيه. وبينما هو وعائلته يجمعون الثروة، تقع الرئاسة نفسها في أيدي الجنرالات والممولين الذين يحيطون به».
فشل النظام
يلجأ الكاتب في عمله إلى تسليط الضوء على الناخبين الأمريكيين أكثر من المرشحين؛ على الاتجاهات طويلة المدى، وليس الحوادث الدراماتيكية؛ على اللعبة كما يتم تنفيذها. ويقول: «حتى قبل أن يدفع دونالد ترامب نفسه كمرشح رئاسي كانت السياسة الأمريكية تتجه نحو التطرف واللا استقرار. هيمن ترامب على فرصة سوداء، لكن تلك الفرصة فتحها ووسعها الآخرون له. انتخاب ترامب كان فشل النظام، لكن النظام لم يفشل خارج السماء الزرقاء الصافية.
المؤسسات لا تهتم لنفسها. بل تهتم بالطريقة التي تعمل بها، أو تفشل في خدمة شعب هذه البلاد. «الترامبوية» تركت الأمريكيين في وضع أقل أمناً أمام المخاطر الخارجية».
كما يشير إلى أنه «حتى الآن، خطورة تحدّي ترامب للديمقراطية الأمريكية تبقى موضع جدل وشك. بعض الجمهوريين من ذوي الذهنية التقليدية سوف يشيرون إلى الإحباطات السياسية وصنع القرار الفوضوي لإدارة ترامب بأنه تطمين. كيف يمكنه أن يكون أوتوقراطياً عندما ينفذ أجندته في الكونجرس من دون إتقان؟ لا يمكنه فعل شيء لخمس عشرة دقيقة متواصلة، فضلاً عن إطاحته نظام حكومة دام أكثر من مئتي سنة. الفرضية المنتهية في هذه التطمينات هي أن القادة الوحيدين الذين يجب أن نخشاهم هم أولئك الاستراتيجيون، المنهجيون، والحاذقون، وأن التهديدات الوحيدة التي يجب على الديمقراطية أن تقلق بشأنها هي الهجمات السرية والمفتوحة على شرعيتها. مؤسسو الجمهورية الأمريكية عرفوا ذلك على نحو أفضل. أحد المفكرين السياسيين الذي ترك تأثيراً كبيراً فيهم هو الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو الذي حذر من «أن أي مجتمع حر يجب أن تتم حراسته ليس فقط ضد «الجرائم» التي يقوم بها القادة المتنفذون، بل أيضاً ضد الإهمال، والأخطاء، ومسألة إهمال حب الوطن، النماذج الخطيرة، بذور الفساد التي لا تسير في مواجهة القوانين، بل تتملص منها، وهذا الأمر لا يدمر القوانين، بل يضعفها».
ويقول الكتاب أيضاً «بالتالي الآن، الشيء الذي يُخشى منه في رئاسة ترامب ليس الإطاحة الفجة بالدستور، بل الشلل الخفي للحوكمة، ليس المواجهة المفتوحة للقوانين، بل التدمير التراكمي للأعراف وقواعد السلوك، ليس نشر قوة الدولة لتخويف المعارضين، بل إثارة العنف الخاص لجعل المناصرين متطرفين. ترامب لا يعمل وفق استراتيجية، بل وفق الغريزة. مهارته الكبرى تكمن في الكشف عن نقاط ضعف خصومه، ووصفه كل واحد منهم بأنه: «قليل الطاقة»، «صغير»، «فاسد»، «كاذب».
بالطريقة نفسها، يستشعر ترامب فطرياً النقاط الضعيفة في النظام السياسي الأمريكي، وفي الثقافة السياسية الأمريكية. راهن ترامب على أن الأمريكيين شعروا بالامتعاض من اختلافاتهم أكثر من ابتهاجهم بديمقراطيتهم المشتركة. حتى الآن، الرهان نجح.
وعن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية يعلق: «كسب ترامب الرئاسة بفضل جزء كبير من الناخبين الذين يشعرون بالاشمئزاز من واقع لم يعد ينفعهم، ويقدم لهم شيئاً. كانت التركيبة الأكبر والأكثر إخلاصاً من أولئك الناخبين رجالاً شعروا بالتقليل من قيمتهم في الحياة الاقتصادية، وبعدم الاحترام على المستوى الثقافي. ترامب لم يبقِ على إيمانه بهؤلاء الناخبين، لكنهم أبقوا على إيمانهم به. وبسبب خشية الحزب من فقد الناخبين، يبقى متعلقاً بترامب. العديد من أعضاء حزبه يشجبون أفعاله، لكنهم يبقون الأمر بعيداً عن العامة، حيث يبقون داعمين له أمامهم».
انقسامات داخلية
يرى الكاتب أن الرئيس ترامب وضع الولايات المتحدة في حالة من الفوضى لتعزيز سلطته الشخصية. أقنع الملايين من الأمريكيين بتجاهل المعلومات التي يحتاجونها ك«أخبار كاذبة» من «إعلام فاسد». وسمح للدول الأجنبية والسياسيين المحليين بالعبث بنزاهة الانتخابات الأمريكية لمصلحته. ويطالب بأن يتجاهل الضباط الكبار القانون لأجل الولاء الشخصي له. وركز السلطة في أيادي رجال عسكريين أفضل منه، لكنها ليست في أياد صحيحة لحكومة مدنية. عزل الحلفاء، وأرضى الأعداء، ودفع الأمور نحو الأسوأ بسبب أشياء صغيرة. أثار بقسوة الانقسامات العرقية والطبقية التي مكّنته في المقام الأول. أغنى نفسه في الحكومة بطريقة تثبط همّة كل ضابط نزيه، وتدعو المخادعين لمحاكاته.
يجد الكاتب أن الصحف الأمريكية تشير إلى أن الديمقراطية تموت في الظلام، لكنه يجد أنه سيكون «من الدقة بمكان إذا قلنا إنها تموت عبر درجات. ضاعت الديمقراطية الدستورية، وهي في الحقيقة ضاعت بسبب الممثلين السياسيين الذين انتهكوا قواعدها بالتناوب لتحقيق هدف ملح وفوري. كل واحد منهم ينتهك القاعدة، ثم يأتي التالي ليبرر له، في دورة من الانتقام تنتهي فقط في الإلغاء الرسمي وغير الرسمي للنظام الدستوري».
ويذكر أن الديمقراطية الدستورية تأسست في المقام الأول على الالتزام بقواعد اللعبة. الخاسرون في أي جولة من اللعبة يقبلون بخسارتهم، لأنهم يؤمنون بأن دورهم سيأتي مرة أخرى في القريب، والفائزون يقبلون بالحدود وفق مكاسبهم، لأنهم يتوقعون أنه في المرة القادمة ربما يحققون أرقاماً بين الخاسرين.
ويعلق على ذلك: «منذ سنة 1992، تطورت لعبة السياسة كثيراً إلى شكل من تمارين الذخيرة الحية. ربما توضح نهاية الحرب الباردة القسوة المكثفة للمنافسة، ومنذ 1990 كان اهتمام النخب الأمريكية قليلاً ما يتجه نحو قلاقل الأمن القومي. كما أن التباطؤ في النمو الاقتصادي منذ سنة 2000 وصدمة الأزمة المالية والركود الكبير قد أصابت السياسة أيضاً، عندما يبدو أن هناك القليل المتوفر، يتقاتل الناس بقسوة أكثر على ما بقي».
ويشير إلى أن الإحباطات والأخطاء في السياسة الحكومية منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، عبر حرب العراق، وعبر التعافي الضعيف من الركود الكبير، تحركت كفة ميزان السلطة بسرعة أكبر من جانب إلى آخر، مغرية كل طرف بالاستحواذ على المزيد طالما أنه يستطيع، مدركاً أن الفرصة لن تدوم للأبد.
ويذكر في ختام عمله: «في الوقت الذي يكون الرئيس ترامب قاسياً، جاهلاً، كسولاً خائناً، أنانياً، حاقداً، جشعاً، يترتب علينا أن نكون متسامحين، لطفاء، كرماء، وطنيين، مثابرين، وعلى قدر المسؤولية، ونبلّغ عن الأخطاء. وفي الوقت الذي يكون فيه داعمو ترامب مستهزئين، وغير مبالين، وقاصري النظر، ومتبلدي الذهن، وحاقدين، في المقابل على معارضي ترامب أن يكونوا مثاليين، ومتبصرين، وحكماء، وتوفيقيين، وذوي حساسية أخلاقية عالية. قالت امرأة حكيمة: إنهم ينحدرون نحو الأسفل، ونحن نصعد نحو الأعلى».
ويضيف: «أولئك المواطنون الذين يتخيلون تحدي الاستبداد من داخل مجمعات محصّنة لم يفهموا أبداً كيف يتم تهديد الحرية بشكل فعلي في وضع بيروقراطي حديث؛ ليس بالإملاء أو العنف، لكن من خلال العملية البطيئة المثبّطة من الفساد والتضليل. والطريقة التي يجب الدفاع عنها ليست بسلاح الهواة، بل بإصرار لا يهدأ على الصدق، والنزاهة، ومهنية المؤسسات الأمريكية وأولئك الذين يقودونها.
نحن نعيش أكثر التحديات خطورة للحكومة الحرة للولايات المتحدة الأمريكية التي صادفها أي شخص على قيد الحياة. ما يحدث تالياً يعود إليك. لا تكن خائفاً. هذه اللحظة من الخطر يمكن أن تكون أفضل ساعة لك كمواطن، وكأمريكي».
نبذة عن الكاتب
– ديفيد ج. فروم من مواليد 30 يونيو/ خزيران 1960. معلق سياسي أمريكي كندي. كان كاتب خطابات الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، وفي وقت لاحق أصبح مؤلف أول كتاب بعنوان «من الداخل» حول رئاسة بوش. وهو محرر رئيسي في «ذا أتلانتيك» ومساهم في «إم إس إن بي سي»، ونائب رئيس وزميل مشارك في معهد آر ستريت. وهو ابن الصحفية الكندية الراحلة باربرا فروم. حاصل من جامعة ييل على درجة البكالوريوس في الآداب والماجستير في التاريخ عام 1982.
وحصل على دكتوراه في القانون من جامعة هارفارد في عام 1987. له العديد من المؤلفات منها: «عودة إلى الوراء: السياسة المحافظة التي يمكن أن تفوز مرة أخرى» (2007)؛ «نهاية الشر: كيف تكسب الحرب على الإرهاب؟» (2004)؛ «الرجل المناسب: الرئاسة المفاجئة لجورج دبليو بوش» (2003)؛ «كيف وصلنا إلى هنا؟ السبعينات: العقد الذي جلب لك الحياة الحديثة – نحو الأفضل أو الأسوأ» (2000)؛ «ما هو اليمين: الأغلبية المحافظة الجديدة وإعادة تشكيل أمريكا» (1997)؛ «سر رأس المال: لماذا تنتصر الرأسمالية في الغرب وتفشل في مكان آخر» (2003).
ترجمة: نضال إبراهيم

في الثامن من مارس من كل عام، يحل الموعد الذي اختارته المنظومة الدولية لإعلان الاحتفال بما يوصف بأنه «يوم» المرأة أو هو «عيد» المرأة في أقوال أخرى.
والحاصل أن اليوم أو العيد المذكور يتيح السبيل أمام استعراض وتأمل سيرة النساء البارزات الشهيرات على مر التاريخ.
هنالك تستعيد المجامع الدولية سرديات الشهيرات، حيث تركت كل منهن بصمة واضحة وأثراً ملموساً في دفتر الكسب الإنساني، ومازالت سيرتها تشكل معْلماً بارزاً في الدفتر الزمني المذكور.
في هذا الإطار ترتسم في الذاكرة الإنسانية أسماء وألقاب ترتبط في سياقها «نون» النسوة مع «شين» الشهرة، وتتعانق على أديمها مفردات الحظوظ مع تصاريف الأقدار بالسلب أحياناً وبالإيجاب في أحيان أخرى.
هكذا مضت مسارات الحياة لسيدات شهيرات مازالت أسماؤهن لامعة وسِيَرهن متداولة على اختلاف الحقب الزمنية ومع تباين الثقافات والظروف والسياقات والحضارات.
ثم ها هي الدكتورة «ليزلي بييرس»، أستاذة التاريخ المرموقة في كبرى الجامعات الأميركية تعرض إلى قائمة النساء اللائي أتيح لهن القبض على، أو الاقتراب من مقاليد السلطة، بل والإمساك بصولجان الحكم عبر مراحل مختلفة من التاريخ: هي القائمة التي ضمت مثلاً من القاهرة «شجرة الدر» في الحقبة الأيوبية، وشملت قبلها من الإسكندرية «كليوباترا» في الحقبة البطلمية من حكم مصر.
ثم عمدت البروفيسور «ليزلي بييرس» إلى اختيار الدرس والتحليل لحقبة محورية أخرى في سياق تاريخ بلدان الشرق وهي الحقبة العثمانية التي دامت عدة قرون، ربما بدأت مع إنشاء تلك الدولة التركية في القرن الثالث عشر إلى حين زوالها عند بداية العقد الثالث من القرن العشرين.
هذه التصورات تبلورت في قصة حياة امرأة روتها أستاذة علم التاريخ في واحد من أحدث إصداراتها، وهو الكتاب الذي نعايشه في هذه السطور، حيث صدر تحت العنوان المثير التالي: «إمبراطورة الشرق» ثم يزداد العنوان إثارة بعد أن تضيف مؤلفة الكتاب عنواناً شارحاً آخر هو: «كيف أتيح لجارية أوروبية أن تصبح ملكة الإمبراطورية العثمانية».
وعبر المحتويات التي تجاوزت 350 من صفحات كتابنا، جهدت المؤلفة في سرد ومتابعة وتحليل سيرة «روكسلانا»: هي بطلة الحكاية المثيرة تاريخياً وسياسياً التي شاءت لها أقدارها أن تولد في أصقاع منطقة تعرف باسم «روثنيا»، وهي منطقة تتوسط حالياً كلاً من بيلاروس (روسيا البيضاء) وأوكرانيا في شرقي القارة الأوروبية.
وكان ذلك على مدار الفترة التي امتدت من مطالع القرن السادس عشر وحتى انتصاف القرن المذكور.
لا تتردد مؤلفة كتابنا في تأكيد أن الاسم الأصلي لبطلة كتابها أصبح مفقوداً. وهكذا خلع عليها الأوروبيون اسم «روكسلانا» الذي دخلت به التاريخ كما قد نقول بدلاً من اللقب الذي شاع إبّان الفترة المذكورة أعلاه، وهو: «فتاة روثنيا».
هي الفتاة، (بالأدق الطفلة الشرق – أوروبية) التي اختطفها تجار الرقيق التتار، ولمّا يتجاوز عمرها الثالثة عشرة، وحملوها إلى سوق النخاسة في اسطنبول، ولكن رسمت لها الأقدار أن يضموها إلى حريم السلطان في عاصمة الإمبراطورية العثمانية التي كانت وقتئذ في أوج مجدها، حيث كان على رأسها السلطان سليمان القانوني.
وتوضح مؤلفتنا كيف أن الصبية الأوروبية لم تكتف بمجرد كونها جارية في صفوف الحريم: لقد قررت أن تطور نفسها. عكفت على تعلّم وإجادة اللغة التركية..
وبدأت مهاراتها ومواهبها تتجلى، فكان أن خلعوا عليها ألقاباً وأوصافاً تدل على نجابتها وخفة روحها. وكان أن اجتذبت اهتمام السلطان سليمان الذي جعلها المحظية رقم واحد في بلاطه، فكان أن أنجبت له أول أبنائه الذي حمل اسم «محمد» وأول بناته التي حملت اسم «مِحْرمة».
وتتوقف فصول الكتاب عند عام 1532 بالذات، وهي السنة التي شهدت إنجاب المرأة القادمة من شرق أوروبا طفلها السادس من أبناء السلطان، الذي لم يلبث أن أعلن زواجه الرسمي من «روكسلانا» التي تصفها المؤلفة أيضاً بأنها كان لها أكبر تأثير وأهم نفوذ لدى أعظم سلاطين الدولة العثمانية عبر تاريخها الطويل.
والحق أن الدكتورة «ليزلي بييرس» بذلت جهوداً حثيثة ومتعمقة في سياق بحثها الأكاديمي في بحث جوانب حياة الزوجة السلطانية المذكورة أعلاه، فكان أن عكفت على تدارس رسائل «روكسلانا» وتعليماتها إلى المبعوثين الأتراك في داخل الإمبراطورية وخارجها بل وخطاباتها الشخصية أيضاً.
في عام 1558 رحلت «روكسلانا» عن دنيا الأحياء بعد أن استطاعت خلال سنوات عمرها، التي تابعتها فصول كتابنا بالسرد والتحقيق والتحليل، أن تضفي تغييرات حاسمة في تصور مؤلفة الكتاب على وضعية المرأة في البلاط العثماني الإمبراطوري المطل على ضفاف البوسفور:
من مجرد دمية أو محظية أو تابعة ضمن صفوف الحريم، إلى حيث تمتعت حرم السلطان «سليمان القانوني» بمركز تأثير فاعل ومحوري ضمن مؤسسة الحكم في اسطنبول، وخاصة بعد أن أصبحت، وفي خطوة غير مسبوقة -كما قد نقول- الملكة الأولى، بل والوحيدة، في تاريخ البلاط العثماني.. بل تضفي المؤلفة على السيدة المذكورة فضل بدء إمبراطورية «بني عثمان» في استهلال المسيرة نحو التمدين والتحديث.
فكان أن ظلوا يصنّفون مسلكيتها وقدراتها وسيرتها في نفس الإطار التاريخي الذي يضم شهيرات النساء المعاصرات في ذلك التاريخ: بدءاً بكاترين دي مديتشي في فرنسا، وليس انتهاء بإليزابيث ملكة إنجلترا التي عاصرها «ويليام شكسبير» ولايزال المؤرخون ينسبون إلى اسمها حقبة الازدهار في تاريخ الإبداع الفني والأدبي في أرض الإنجليز.
الكتاب: إمبراطورة الشرق
المؤلفة: ليزلي بييرس
الناشر: مؤسسة بيزك بوكس
الصفحات:
329 صفحة

في عام 1914 اندلعت نيران الصراع الدولي الذي حمل اسم الحرب العالمية الأولى. اكتوى بلهيب هذه الحرب كل ممالك وإمبراطوريات العالم الحديث في ذلك الزمان: ما بين إمبراطورية «رومانوف» في روسيا إلى إمبراطورية «بني عثمان» في تركيا، إلى إمبراطورية «الهابسبورغ» في النمسا إلى إمبراطورية «غليوم» في ألمانيا.
دولة كبرى كانت بازغة في ذلك الزمان ارتأت أن تنأى بنفسها عن أتون الصراع الدولي، خاصة وقد عاينت مصير الانهيار، ثم الزوال الذي حاق بتلك الممالك والإمبراطوريات التي أتينا على ذكرها في مستهل هذه السطور.
نتحدث عن الولايات المتحدة، التي لم يكن عمرها قد أوفى مئة وخمسين عاماً، وكان على رأسها وقت نشوب الحرب العالمية الأولى «توماس ويلسون» (1856 ـ 1924) رئيسها الـ28. عاين الرجل ما خلفته الحرب من كوارث وما تسببت فيه من ويلات، فكان أن أعلن شعاره الشهير قائلاً في عام 1917: «فلنجعل العالم ساحة مأمونة من أجل الديمقراطية».
وكان منطقياً أن يترجم الرئيس الأميركي هذه المقولة إلى دعوة لتأسيس منظمة كبرى تسهر على استتباب السلام في العالم. وهي المنظمة التي حملت عنوانها الشهير في التاريخ الحديث: «عصبة الأمم» (1920 ـ 1938).
ورغم أن «ويلسون» حصل على جائزة «نوبل» العالمية للسلام في عام 1917، إلا أن عصبة الأمم ذاتها فشلت في وقف تيارات العنف وإخماد لهيب الصراع الدولي، وقد أدت التطورات إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.
ولقد خرجت أميركا من الحرب على رأس المنتصرين، بمعنى أن آلت إليها مقاليد القيادة الدولية في عالم ما بعد الحرب العالمية، ولدرجة أن انتهت إليها مواريث القوى الإمبريالية الكلاسيكية متمثلة في تركة الاستعمار البريطاني والاستعمار الفرنسي.
بيد أن قيادة عالم النصف الثاني من القرن العشرين ألقت بدورها عوائق جسيمة على عاتق أميركا، التي شاءت أقدارها أن تخوض غمار صراعات دموية جديدة: في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينيات ثم في أدغال جنوب الشرق الآسيوي في الستينيات.
ورغم ما حققته أميركا مع العقد التسعيني الأخير من فوز في صراع الحرب الباردة على غريمها الشيوعي السوفيتي، فالإجماع لايزال منعقداً على ضرورة أن تواصل واشنطن الاضطلاع بمهمة التعاطي المستمر مع مشكلات عالم القرن الواحد والعشرين من أجل الحفاظ على دورها القيادي أو الطليعي في عالم القرن الجديد، وباعتبار أن هذا الدور ليس مجرد وجاهة لدولة عفيّة وإنما هو دور لدولة تبحث عن مكان وتنشد مكانة في منظومة أمم العالم.
هذا الدور يلخصه عنوان الكتاب الجديد الصادر تحت عنوان رئيسي يبدو فلسفياً وهو: «التعامل الوقائي». وقبل أن يتوه القارئ في جنبات هذا العنوان، يبادر المؤلف بإضافة عنوان تفسيري يقول بما يلي: «كيف يتسنى لأميركا أن تتجنب الحرب (ولكن) تبقى قوية وتحافظ على السلام».
أما مؤلف الكتاب فهو واحد من الأكاديميين الخبراء المتخصصين في علم الوقاية من النزاعات، فضلاً عن كونه مسؤولاً عن مركز الإجراءات الوقائية الذي يشكل فرعاً تابعاً لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن.
بين الاندفاع والاتزان
إن مثل هذه النوعية من الدراسات تشكل نموذجاً لنهج الرشد أو الاتزان في مقاربة المشكلات الخطيرة التي ما برح العالم يعانيها، وعلى رأسها مشكلة الجمع المتوازن بين دور محوري ومهم تضطلع به الدولة المعنية، وبين الحيلولة دون تورط هذه الدولة صاحبة هذا الدور في صراعات قد تدفع فيها الدولة أو الأطراف ثمناً فادحاً من اقتصادها ومواردها، فما بالك بالثمن الأكثر فداحة، متمثلاً في أرواح مواطنيها ودماء أبنائها؟!
هنا يدعو المؤلف إلى تدارس وتبنّي نظرة يراها موضوعية ومتوازنة، كما أنها واقعية، إلى المشهد العالمي الراهن، بعد انتصار أميركا في الحرب الباردة وتمتعها بمركز القطب العولمي الأوحد خلال عقد التسعينيات. كما يشير إلى أن وضعية أميركا لم تعد كما كانت عليه: في مرحلة سبقت المسرح العالمي الذي تغيرت مقولاته وتبدلت ديكوراته، ويكفي مثلاً النظر بعين الدرس والتأمل إلى معاودة روسيا – بوتين التطلع إلى مركز قيادي في العالم، فضلاً عن رقم جديد وخطير بكل معنى في معادلة القوة الفاعلة، وهو «الصين» بطبيعة الحال.
هنا ينصح مؤلفنا بأن تتبع السياسة العليا في واشنطن أسلوب التركيز على «علامات النذير». وهو ما يستدعي في تصوره بلورة النظرة الكفيلة بتدارس الأوضاع والعلاقات والمصالح الدولية التي تنطوي بحكم طبيعتها على احتمال نشوب الخلافات ثم اندلاع المنازعات بين الدولة الفاعلة على المسرح الدولي الراهن، وهو يسوق العلامات التحذيرية؛ ما بين قوة الصين الاقتصادية، وتطلعات روسيا إلى دور سوبر ـ قيادي في الشرق الأوسط، فضلاً عن تطوير الإمكانات النووية في أقطار من قبيل كوريا الشمالية أو إيران.
هنا أيضاً يشدد المؤلف على ضرورة أن تحرص واشنطن على أن تنأى بنفسها عما يصفها بأنه الصراعات أو النزاعات الداخلية أقطار العالم، ثم يعمد إلى طرح معادلة ثلاثية الأبعاد في مضمار السلوك السياسي:
• أولاً: تبنّي سياسات تؤدي إلى تخفيض خطر النزاعات التي تنشب وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
• ثانياً: بذل جهود من شأنها إعطاء الأولوية لاستباق وقوع الأزمات وتجنب حدوثها، وهو ما يفرض تشجيع اتباع سبل التفاوض والتوسط السياسي.
• ثالثاً: تنمية القدرة على تخفيف الصراعات التي تنشب، مع العمل على الحيلولة دون تصاعدها، ومن ذلك مثلاً اتباع سبل الضغط الدبلوماسي واللجوء إلى العقوبات المالية.
ومهما تباينت المواقف، ينبغي استنفاد جميع السبل والوسائل كي «لا تملك أميركا ترف السلبية إزاء التحديات الدولية، بقدر ما أنها لا تملك ترف الاندفاع المتهور نحو مواجهة تلك التحديات».