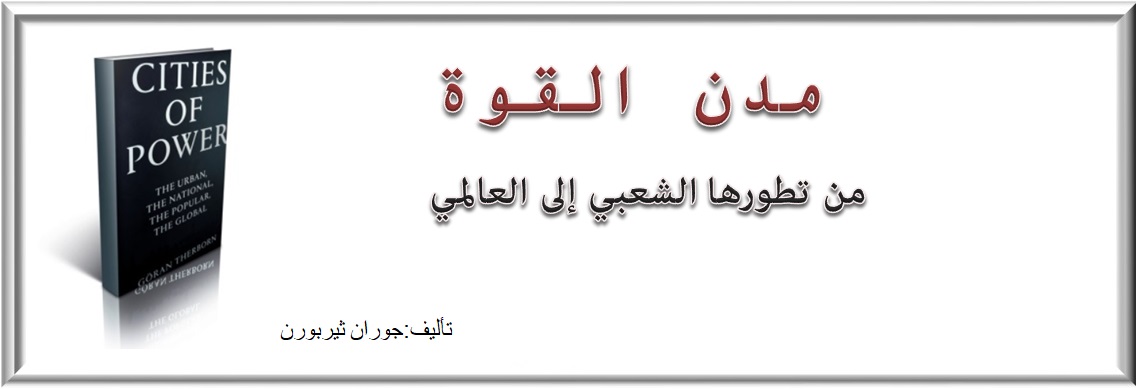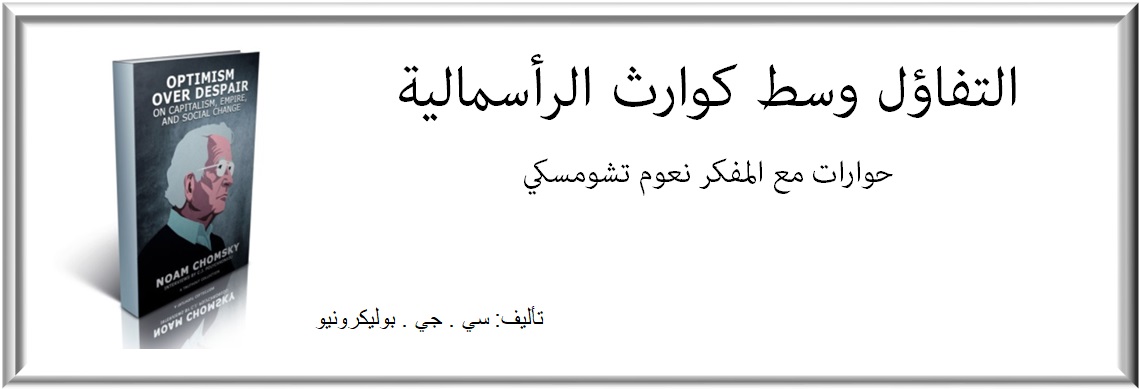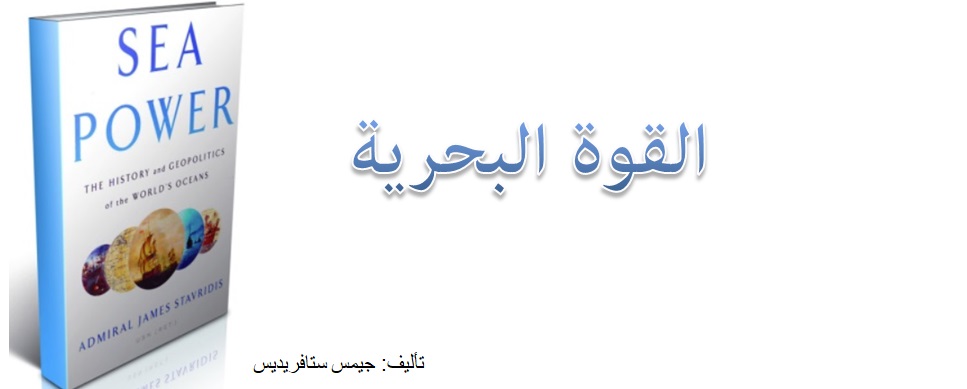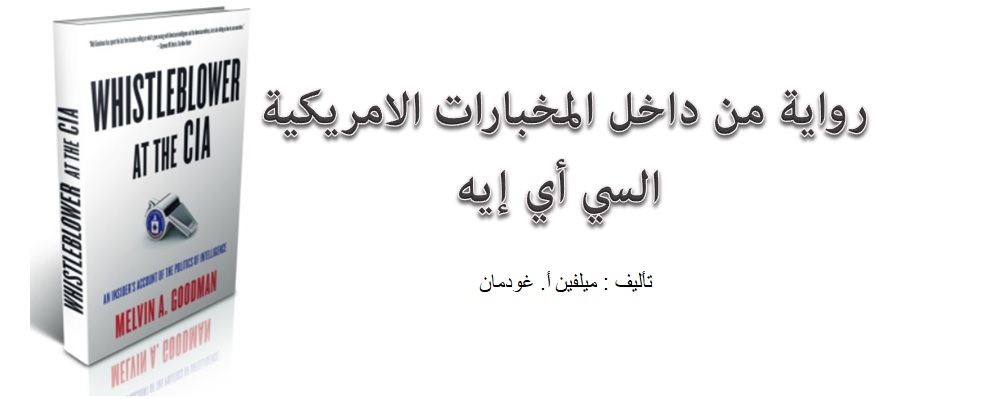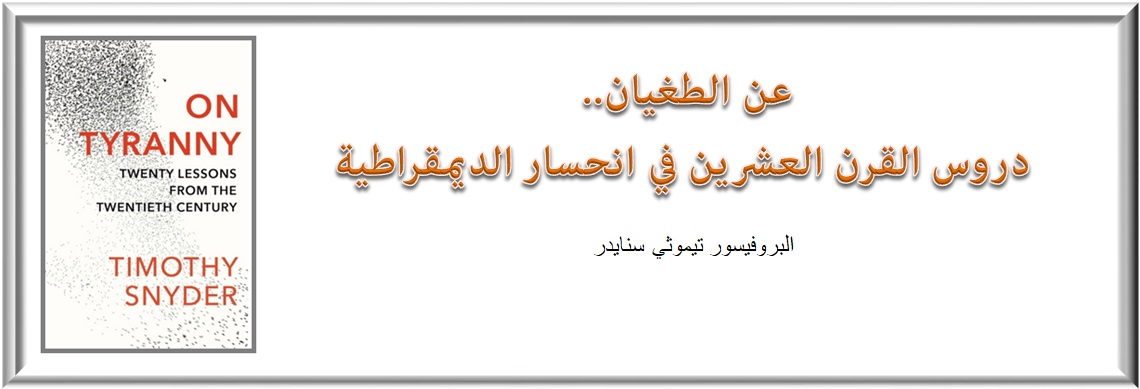
نتحدث عن جانبي السلطة والحكم والنفوذ والسيطرة عبر التاريخ وهما: الديمقراطية والطغيان، وفي الوقت الذي عرفت فيه البشرية عديد الأفكار، وصاغت مفاهيم ومصطلحات تنصرف إلى معان سامية من قبيل: الشورى، أو قبول الآخر، أو التسامح أو التفاهم أو التوافق، فقد ظل الجانب المقابل بمثابة صخرة كأداء تحُول دون انطلاق البشر إلى حيث يتفاهمون، ويتراحمون ويتسامحون ويتواصلون، وظل الطغيان أشبه بكابوس يقضّ مضاجع الشعوب عبر التاريخ.
وها هو الأكاديمي تيموثي سنايدر أستاذ علم التاريخ جامعة ييل التي تعد واحدة من كبرى الجامعات الأميركية، قد أصدر أخيراً دراسته المركزة عن ظاهرة أو آفة الطغيان، لا عبر مراحل انقضت من تواريخ الشعوب وإنما عن أقرب مرحلة لا يزال يعيشها الناس في الفترة الزمنية الراهنة، حيث اختار المؤلف لكتابه عنواناً مباشراً، هو «عن الطغيان: عشرون درساً في القرن العشرين».
البروفيسور «سنايدر» يَصدر في مقولات كتابه عن منطلق محدد يصوغه في العبارات التالية:
• إن الآباء المؤسسين (للولايات المتحدة) حاولوا أن يحُولوا بيننا وبين الإصابة بداء الطغيان الذي طالما اجتاح الديمقراطيات القديمة، ولكن ها نحن اليوم وقد أصبحنا نواجه تهديدات جديدة ليست بعيدة الشبه بما سبق وشهدته مراحل سبقت من التاريخ.
أستاذ التاريخ الذي أصدر هذا الكتاب عكف على تدارس ما شهدته عقود وسنوات القرن الماضي من أنظمة حُكم ومن أيديولوجيات وأطروحات وشعارات وأفكار، اتسم الكثير منها، بحسب رأي المؤلف، بآفة الطغيان والديكتاتورية والشمولية والاستبدادية، فما بالك، يلاحظ المؤلف، أن هذه «الطغيانات»، إن جاز المصطلح، نشأت وتطورت وازدهرت، لا في الأصقاع المنسية من غابات العالم، ولا في الساحات القصّية، شبه المجهولة أو شبه المتخلفة من خارطة البسيطة. بل في قلب العالم المتقدم وقتها، تقنياً وثقافياً وعملياً، يستوي في ذلك روسيا الشيوعية، أو ألمانيا النازية أو إيطاليا الفاشستية أو حتى اليابان الإمبراطورية.
وفيما يواصل المؤلف العزف على هذه النغمة، فهو يصل إلى نهايات القرن العشرين، موضحاً أن القوم تصوروا وقتها أنهم وصلوا إلى منعطف حاسم مع انهيار الكيان الشيوعي ـ السوفييتي في مفتتح تسعينات القرن المذكور.. وكان أن أطلقوا عليه وصف «نهاية التاريخ»، وربما كانوا يمنّون أنفسهم بمنطق التعلّل بالأمنيات، بافتتاح عالم جديد من الحرية والديمقراطية والإصغاء إلى صوت البسطاء وإنصاف المهمشين في العالم المستجّد المأمول، في حين أن القرن الجديد جاء ليشهد للأسف حروباً وصراعات، شكل البسطاء والمهّمشين غالبية ضحاياها.
وهنا يرفع المؤلف نغمة التحذير قائلاً في سطور محددة «..الأميركيون في أيامنا الحالية، ليسوا أعقل ولا أذكى من نظرائهم الأوروبيين الذين عايشوا، خلال عقود القرن الماضي، تحولات بلادهم (ألمانيا، إيطاليا وشرق أوروبا مثلاً) إلى نظم الطغيان الشمولية التي عصفت بالديمقراطية بكل معانيها ومبادئها وتجلياتها». وفي هذا السياق، يسوق المؤلف نماذج، من الواقع الأميركي، على خطورة مثل تلك التحولات، لاسيما في ظل الإدارة الجمهورية الحالية ورئاسة ترامب للولايات المتحدة.
صحيح أن شعارات الديمقراطية ما زالت مرفوعة. ويتصدرها الشعار الأثير الذي تلخصه العبارة المفروض أن تضبط العلاقات بين السلطات الحاكمة في الدولة «المراجعات والتوازنات» (Checks and Balances)، إلا أن الأصح، وفق المؤلف، هو أن إدارة الرئيس ترامب الراهنة لا تفتأ، تشنّ هجومها على «ميديا» الاتصال والتوعية والتنوير والإعلام وعلى منظومات التوعية والفكر والثقافة بشكل عام، مستخدمة في ذلك سبل التواصل الاجتماعي فضلاً عن طرحها، المتعمد طبعاً، لشعارات ومرويات وتصريحات من شأنها إبقاء الجمهور المتلقي في حالة تشكيك وحيرة وتضارب إزاء ما يتلقاه من أفكار ومعلومات.
في السياق نفسه، يرصد المؤلف نماذج من مشاركة فئات المثقفين والمهنيين في مثل هذه التجاوزات التي تتحول بالممارسات السياسية من ساحات الديمقراطية إلى كهوف الطغيان، حيث يتوقف ملياً عند سلوكيات وطروحات و«اجتهادات» المحامين والصحفيين وكبار الموظفين، والمسؤولين المدنيين الذين وضعوا خلاصة خبراتهم في خدمة هذا اللون المستجد والمزوّق أيضاً من سلوكيات «الطغيان» من طراز الألفية الثالثة.
ولا حل في نظر المؤلف سوى أن تنشط كل دوائر المجتمع المدني، في الولايات المتحدة وغيرها من الأقطار، بحيث يصبح من واجبها التنبه إلى هذه التحولات التي لا يكاد يشعر بها أحد ما بين ممارسات الديمقراطية إلى آفات اللاديمقراطية ومهاوي الاستبداد والطغيان.
ويتمثل الحل، بنظر البروفيسور تيموثي سنايدر، في أن يتمسك الإنسان العادي، المواطن البسيط بأنه «مواطن» بالدرجة الأولى، وأن له حقوقاً يتفاعل معها ويطالب بتفعيلها من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتجمعات ورابطات المواطنين، بل يصل أمر المؤلف إلى دعوة أهل الاختصاص إلى تدارس وتحليل الشعارات والعبارات التي يطرحها القادة في الوقت الراهن، وعلى رأسهم بالطبع رئيس الدولة سواء كانت خطابات أو تغريدات ومن ثم تكون المبادرة إلى تفنيدها، والرد عليها وبيان ما تنطوي عليه من أخطار، قد تداهم الممارسة الديمقراطية، حتى لو كانت ترفع شعارات تتحدث عن الخطر على الوطن أو الديانة أو المستقبل.
المطلوب إذن هو التنبّه إلى مخاطر المستقبل من خلال تحليل معطيات الحاضر واستقاء العبرة من تجارب الماضي وقد كانت تجارب مريرة في كل حال.