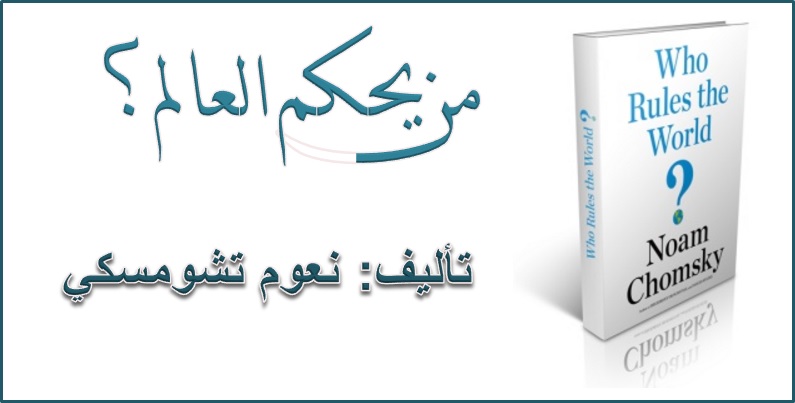كيف تبني السلطات السياسية الدعم لنفسها، وحكمها؟ في الحقيقة، القيام بذلك أمر مهم لإحقاق السلطة على أرض الواقع، لكنه لا يخلو من الصعوبات والتعقيدات، خاصة في اتحاد أوروبي يضم العديد من الدول المتنوعة بلغاتها، وأعراقها، وأفكارها. تقف المؤلفة كاثلين ر. ماكنمارا في عملها الجديد هذا، على تفاصيل السياسة اليومية في أوروبا، وكيفية بناء السلطة الفعلية في الاتحاد الأوروبي، التي يمكن أن يكتب لها العمر الطويل وسط التحديات الكبرى.
يوضح هذا الكتاب (الصادر في 224 صفحة باللغة الإنجليزية عن مطبعة جامعة أكسفورد)، كيف يمكن للعمليات الاجتماعية أن تشرعن حكاماً جدداً، وتجعل ممارسة سلطتهم تبدو طبيعية. تاريخياً، استخدمت السلطات السياسية الرموز والممارسات بعناية لخلق بنية تحتية ثقافية للحكم، وعلى الأخص عبر القومية وبناء الدولة.
اليوم، يواجه الاتحاد الأوروبي، بوصفه شكلاً جديداً من أشكال الحكم، مجموعة من التحديات الحادة. ومع ذلك، فإن التحول البطيء في رموز وممارسات الحياة اليومية، جعل الاتحاد الأوروبي السلطة السياسية «التي تمت الموافقة عليها»، فأوجدت نوعاً معيناً من الهوية الأوروبية المشتركة. ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد دولة قومية. وبدلاً من ذلك، نجد أن البنية التحتية الثقافية للاتحاد الأوروبي متجذرة في نوع معين من السلطة «العادية» التي تتنقل إلى الولاءات الوطنية، في الوقت الذي يتم تصوير الاتحاد الأوروبي فيه على أنه مكمل للهويات المحلية، وليس في صدد منافستها. وتشير الكاتبة إلى أنه كثيراً ما يتم تهميش الملصقات والخرائط الذهنية والروايات التي تولدها سياسات الاتحاد الأوروبي، ويتم تطهير ارتباطاتها بسلطات الدولة القومية، وتوحيدها في حالة من الغموض التي لا تبدو موضع اعتراض.
ومن خلال الأخذ بنهج تنمية سياسية جديدة، يساعدنا هذا الكتاب على فهم كل من شرعية الاتحاد الأوروبي، كممثل ناشئ جديد، والحدود المحتملة للعمليات الثقافية التي أرساها. يأتي الكتاب في ثمانية أقسام موزعة كالتالي: 1- المقدمة. 2- بناء الاتحاد الأوروبي كحقيقة اجتماعية. 3- تقنيات البناء الثقافي. 4- المباني والأغاني. 5- المواطنة والتنقل. 6- اليورو والسوق الموحد. 7- السياسة الخارجية الأوروبية. 8- الخاتمة.
الثقافة السياسية الأوروبية
تتحدث الكاتبة في مقدمة العمل عن الأدبيات المتعلقة بالتنمية السياسية المقارنة، ودور الرموز والممارسات في خلق الثقافة السياسية الأوروبية، التي يمكن أن تساعد في الكشف عن العمليات الاجتماعية اليومية التي تضفي الشرعية على الاتحاد الأوروبي. كما تلقي المقدمة الضوء على الحجج الرئيسية للكتاب، وتحديداً فكرة إنشاء بنية تحتية ثقافية للحكم عند الضرورة لتجنيس السلطات السياسية الجديدة، وتوليد الهوية السياسية، وتوضح الكاتبة كيف نشأ هذا في حالة الاتحاد الأوروبي. وتخلص المقدمة إلى مناقشة الاستراتيجيات المنهجية لدراسة الثقافة.
ومما تقوله الكاتبة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره في بقية الدول في الاتحاد: «استفتاء التصويت الذي حدث في 23 يونيو/حزيران 2016 من قبل المملكة المتحدة على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، يمثل رحيلاً مذهلاً من طريق لا مفر منه على ما يبدو للاتحاد، حيث يظهر أقرب من أي وقت مضى. أغلبية المصوتين في المملكة المتحدة فضلت الخروج من الاتحاد على الالتزام بالعضوية المستمرة في الاتحاد الأوروبي، وهذا الاختيار أطلق فترة لا مثيل لها من الشك والمجهول بالنسبة لمستقبل واتجاه المشروع الأوروبي، في الوقت الذي تستمر فيه الملامح الدقيقة للخروج بالتطور. ومع ذلك، فإن الخروج البريطاني هو أبعد ما يكون عن التحدي الأساسي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي اليوم. فأمواج اللاجئين التي تجرفها البحار إلى شواطئ إيطاليا واليونان تصاعدت في صيف 2015، منتجة بذلك أزمة إنسانية، مع تقديم القليل من الحلول في الأفق.
في تلك الأثناء، تستمر التوترات ضمن منطقة اليورو، مع برامج التقشف، وتخفيض الإنفاق التي تنتج أزمة طاحنة في اليونان، ونمواً مشوهاً بشكل ضار عبر أغلب أوروبا الجنوبية. «ويبقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي بظلاله ليهدد أوروبا، مع خوف العديد من توغل أكثر للقوات الروسية إلى ما وراء منطقة أوكرانيا. وفي النهاية، شهد الاتحاد الأوروبي صعود الأنظمة الأوتوقراطية ضمن حدوده، حيث تبدو التطورات الأخيرة في هنغاريا وبولندا أنها تقلص التماسك الديمقراطي في النطاق السوفييتي السابق، خالقة بذلك تحدياً أساسياً للاتحاد الأوروبي كنظام ديمقراطي ليبرالي».
وتضيف: «كل هذه الأزمات التقت مع ما يبدو أنها استجابات غير فعالة من قبل الاتحاد الأوروبي، وقادته القوميين، والإحباط والغضب الذي اعترى الجمهور الأوروبي. وبشكل غير مفاجئ، نمت الأحزاب المشككة في اليورو أضعافاً مضاعفة، وطالبت بإعادة فرض السيادة الوطنية على كل من الحدود والأسواق. وفي الوقت الذي تعثر فيه الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ في العديد من النقاط خلال فترة وجوده في نصف قرن من الزمن، وخطورة وتعدد التحديات التي يواجهها اليوم لم يسبق لها مثيل».
البناء الاجتماعي والثقافي
يوضح الفصل الأول من الكتاب أهمية «البنية التحتية الثقافية» في إضفاء الشرعية على السلطة السياسية. ويوضح أن علينا فهم الثقافة كعملية دينامية مكونة من معنى تشكّل بين مجموعة محددة من الناس الذين يشتركون في الهويات الجماعية المستمدة من هذه الثقافات والتفاعل معها. ثم يربط الفصل بين الثقافة والهوية بالسياسة، استناداً إلى المفاهيم بما في ذلك المجتمعات المتخيلة لوصف التأثير السلبي للقومية وغيرها من مساعي صنع الأساطير، ويشير إلى أننا بحاجة إلى النظر في الاتحاد الأوروبي في ضوء ذلك. كما يوضح الفصل الآليات المحددة التي تخلق الاتحاد الأوروبي كحقيقة اجتماعية، وتحدد آليات أساسية للبناء الاجتماعي في مجال الرموز (كتمثيل جماعي) والممارسات مثل (التجارب المعيشة، والإنجازات، والتفاعل مع العالم المادي).
على مر التاريخ، نشرت الجهات الفاعلة السياسية الماهرة مجموعة متنوعة من التقنيات السياسية المجربة والحقيقية التي غالباً ما كانت تنطوي على التصنيف والفئوية، لتوليد سلطة شرعية للحكم.
ويتساءل هذا الفصل ما هو المحور المحدد الذي وضعه الاتحاد الأوروبي على هذه العمليات الاجتماعية؟ ثم يحدد التقنيات الخاصة للبناء الثقافي التي تؤسس الاتحاد الأوروبي كحقيقة اجتماعية وطبيعية مسلم بها، حتى إن كان من الممكن الاعتراض على أفعالها وسياساتها. فالعمليات المنتشرة لوضع العلامات ورسم الخرائط والروايات العامة تصنع المعاني وتشكّل تفسير التجارب اليومية لأوروبا بطرق مترابطة منطقياً على الصعيد السياسي. إلا أن الاتحاد الأوروبي ينشر ثقافته الخاصة في مجال الحوكمة مع تحقيق توازن دقيق بين الرموز والممارسات الأوروبية والوطنية، والتخلي عن المشروع نفسه كسلطة سياسية محظورة.
ويعرض الفصل الرابع البرامج الثقافية للاتحاد الأوروبي، ويستخدم أمثلة عن العمل الذي تقوم به السياسات الثقافية من أجل إظهار كيف أن هذه الأنشطة تساعد على تجنيس وتشريع السلطة السياسية الأوروبية. غير أنه يحذر على العموم من أن معنى المنتجات والخبرات الثقافية المحددة لم يخضع لأي سيطرة على الإطلاق من قبل أي فرد، أو بيروقراطية، أو شركة، ما يجعل المنتجات والخبرات الثقافية مجالاً محتملاً ينطوي على مخاطر بالنسبة للأنشطة الرمزية. ويتم فحص جغرافية الحوكمة من خلال العمارة العامة للاتحاد الأوروبي، وبناء المساحات ونماذج من بروكسل. كما يتطرق إلى الساحة الثقافية الثانية في مسابقة الأغنية الأوروبية وخلق الأوروبيين. ويركز الجزء الأخير منه على تبني الاتحاد الأوروبي وجهوده لإعادة اختراع الرموز القومية، خاصة في النشيد الأوروبي «نشيد الفرح».
المواطنة والتنقل
يبدأ الفصل الخامس بمناقشة موجزة عن السبب الذي يجعل الحدود والتنقل والمواطنة تنطوي على ديناميات ثقافية، ثم يقدم لمحة عامة عن تاريخ السياسة في هذا المجال. ويعاين الفصل عن قرب الآثار الرمزية والعملية للمواطنة الأوروبية كتصنيف قانوني، وجواز السفر الأوروبي، وإعادة تأطير تعليم التاريخ عبر الاتحاد الأوروبي من الدولة القومية إلى رؤية مناصرة لأوروبا. كما يتوقف عند أهمية ممارسة التنقل في منطقة شينغن الحرة، وبرنامج إيراسموس، والتغيرات الأخرى في الرموز اليومية، وتجارب التنقل الأوروبي التي ترتبط أيضاً بالسلطة السياسية للاتحاد الأوروبي. وتقول الكاتبة: «النمط العام الذي يبرز هو بناء نوع معين من المجتمع المتخيل من الأوروبيين، يميل بخجل نحو الدولة القومية، في حين يستعين بشكل متحرر من تقنيات مجرّبة وحقيقية لبناء الأمة».
ويرى الفصل السادس أن الأسواق هي مواقع ثقافية، وليس أكثر من أي مكان آخر، خاصة على اليورو ومشروع السوق الواحدة. وبعد إبراز التطور التاريخي بإيجاز، تبرز الكاتبة مختلف الرموز والممارسات الكامنة في هذه المشاريع. ويصف الفصل كيف أن اليورو والسوق الواحدة -بعيداً عن التأثيرات المادية المهمة – يخلقان «أوروبا الخيالية» للمواطنين من خلال العمليات الاجتماعية لوضع العلامات، ورسم الخرائط، والروايات العامة، على سبيل المثال مع صور أيقونية لليورو، أو إنشاء «سي»، أو فئة «سوسيتاس يوروبايا» للشركات الأوروبية. وكما هو الحال مع التجربة التاريخية للدول القومية، فإن هذه العمليات تعمل على شرعية نقل السيادة بشكل كبير، على الرغم من أنها تفعل ذلك باستخدام استراتيجيات توطين أوروبا في محاولة لجعل أنشطة السوق في الاتحاد الأوروبي تبدو أقل تنافسية من الناحية السياسية.
السياسة الخارجية
يبدأ الفصل السابع بمناقشة دور الثقافة في السياسة الخارجية، كما يستعرض التطور التاريخي المدهش للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، ويسلط الضوء على بطء إضفاء الطابع المؤسسي على القدرات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي وكذلك على التنسيق الأمني له. وتشير الكاتبة إلى فهرسة الرموز والممارسات التي تصنف السياسة الخارجية الأوروبية، وترسم خريطة لها وترويها، وهي: البناء القانوني للاتحاد الأوروبي ككيان سيادي، وتعيين دبلوماسيين أوروبيين في دائرة العمل الخارجي الأوروبي، ووضع استراتيجية أوروبية كبرى، (وإن كان متداخلاً دائماً ضمن بعثات الناتو وبعثات الأمم المتحدة). وتشير المؤلفة إلى أن المعاني الناتجة عن السياسة الخارجية الأوروبية تشكل جزءاً أساسياً من إنشاء مجتمع أوروبي متخيّل بشكل أوسع، لكنها تظهر أيضاً أنه مجتمع يعاني قيوداً ونواقص مضمنة بشكل كبير.
وفي ختام العمل تلقي الكاتبة نظرة عامة على محتوى الكتاب، وتنظر في نتائج ما تطرحه على مستقبل أوروبا. وتقول إنه «على الرغم من أن رموز وممارسات الحياة اليومية قد خلقت نوعاً من الشرعية للاتحاد الأوروبي، إلا أنه يتم التعامل مع سلطتها بشكل متسامح، وليس بدافع حب الأوروبيين له. وقد أظهر فشل الدستور الأوروبي في عام 2005 قيود السلطة الضعيفة للاتحاد الأوروبي، وهشاشة المظهر الزائف للتكامل لديها مع الدولة القومية. كما أن أزمة منطقة اليورو ومشاعر الإقصاء الاجتماعي الأوسع، تفرضان تسييساً جديداً للاتحاد الأوروبي». ويخلص الكتاب إلى أن التنافس الأكثر انفتاحاً وشفافية وتوجيهاً بشكل فعّال، هو الذي يكون مدعوماً ببنية تحتية ثقافية من شأنه أن يسمح بالصراع العلني للقيم السياسية التي حدّدت حلقات تاريخية سابقة من التطور السياسي، وهو السبيل الوحيد لإضفاء الشرعية الدائمة على الاتحاد الأوروبي.
نبذة عن المؤلفة
كاثلين ر. منمارا، أستاذ مشارك في الخدمة الحكومية والخارجية، ومديرة مركز مورتارا للدراسات الدولية بجامعة جورج تاون. وهي كاتبة «عملة الأفكار: السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي» (كورنيل ونيفرزيتي بريس، 1998)، وشاركت في تحرير كتاب «صنع التاريخ: التكامل الأوروبي وتغيير المؤسسات في الخمسينات» (مطبعة جامعة أكسفورد، 2007)، ونشرت العديد من المقالات عن سوسيولوجية الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد السياسي الدولي، والخدمات المصرفية المركزية، ودور الأفكار والثقافة في صنع السياسات. حاضرت ماكنمارا في جامعة برينستون وساينس بو (باريس)، وكانت باحثة زائرة في مؤسسة راسل ساجا، وزميلاً في صندوق مارشال الألماني، وزميلاً فولبرايت. وهي مشاركة في مجموعة متنوعة من مجموعات السياسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، وبكالوريوس من جامعة مكغيل الكندية.
عرض وترجمة: نضال إبراهيم