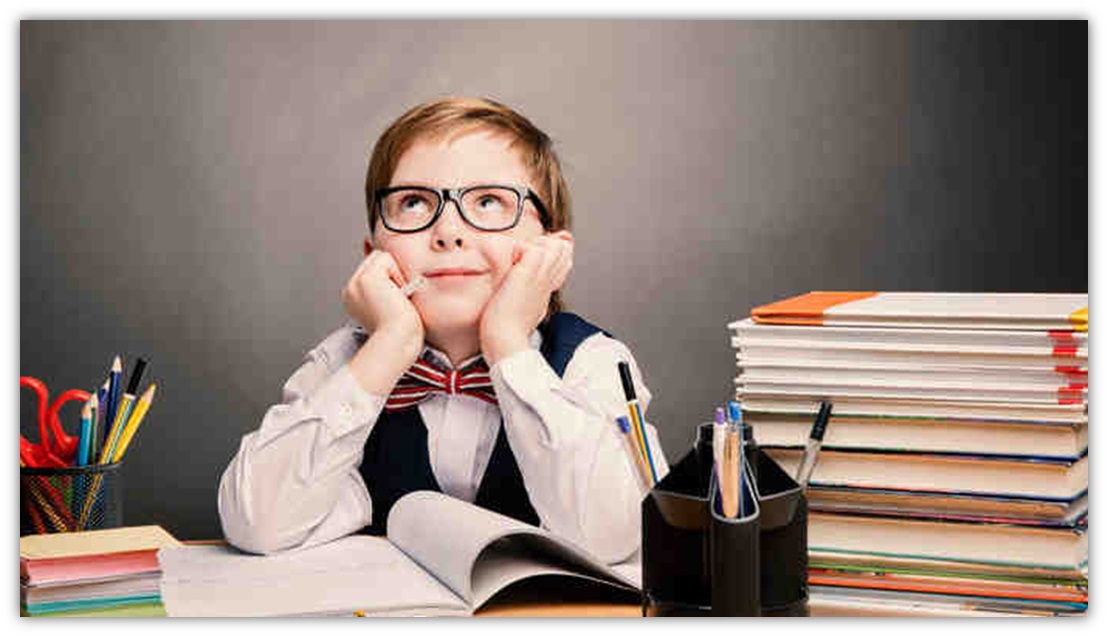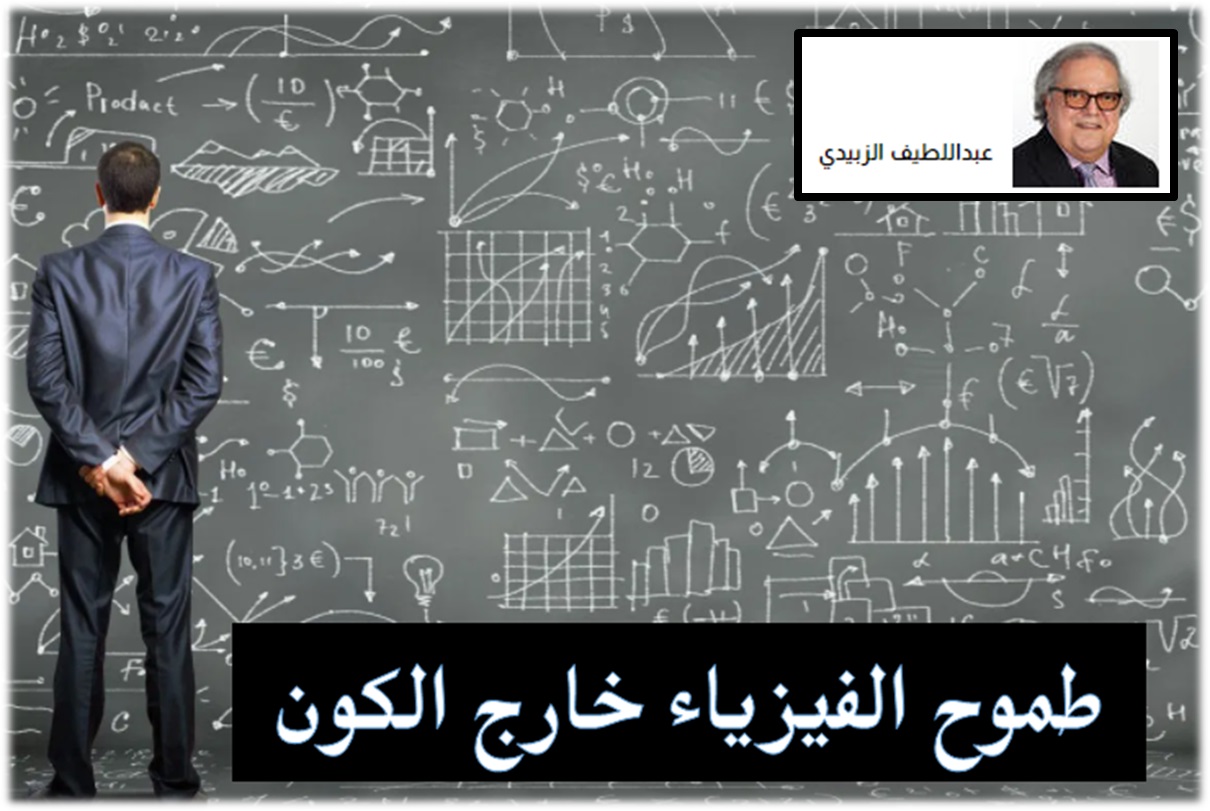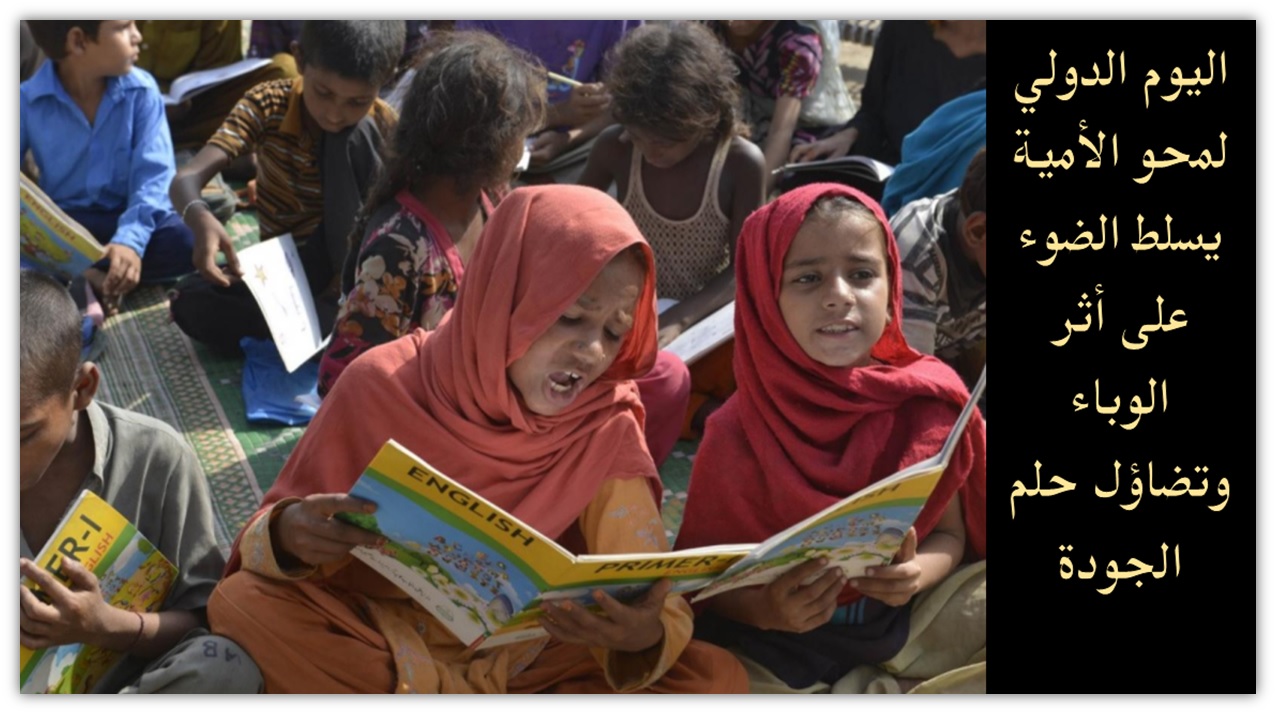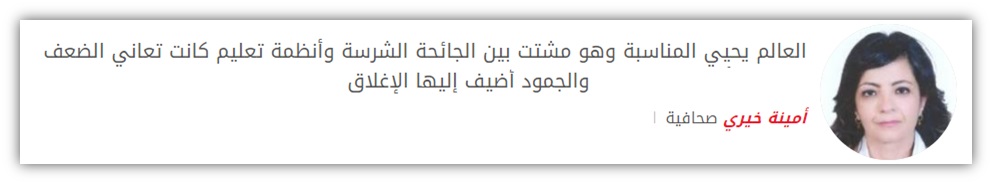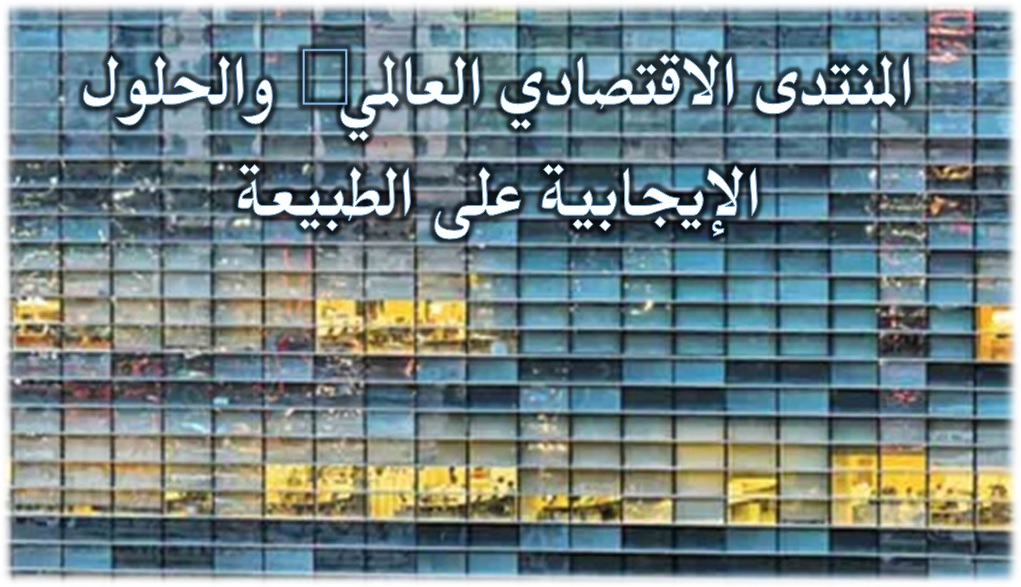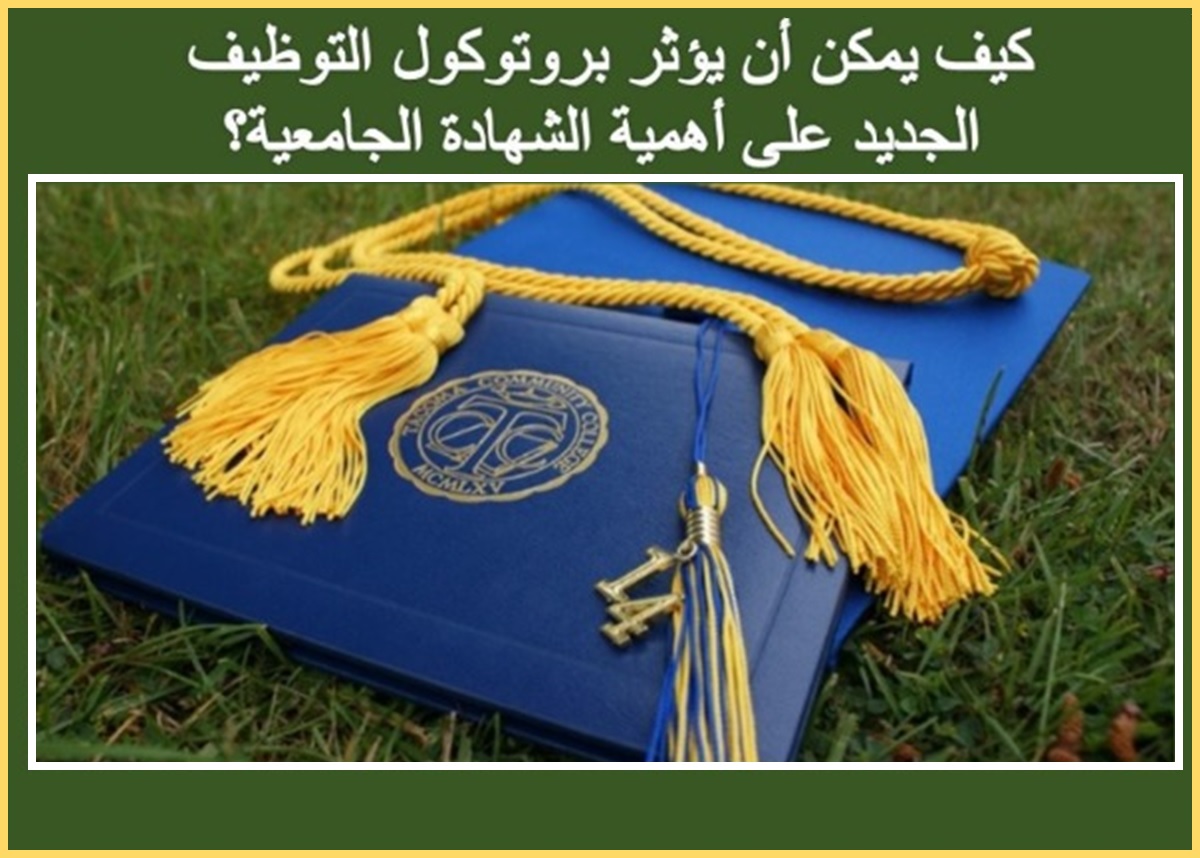يشعر الأشخاص الذين يقومون بزيارة عيادتي من أجل علاج مشاكل العمل بالقلق من السلوك الذي يعرفون أنه يضر بحياتهم المهنية أو أعمالهم التجارية، لكنهم غير قادرين على التعامل معه.
عندما تفشل نصيحة المدربين أو الزملاء المقدمة بحسن نية في تقديم مساعدة، فإن البحث بعمق أكبر لفهم دوافعنا الأساسية يمكن أن يكون الحلّ الأكثر فعالية. منذ النتائج التي توصل إليها سيغموند فرويد، أدرك المعالجون النفسيون أن تجارب الطفولة المبكرة الخاصة بنا لها تأثير كبير على تصوراتنا وسماتنا الشخصية، والتي تؤثر على حياتنا المهنية في المستقبل.

يمكن فهم الدوافع مثل الكمالية وإدمان العمل وسلوكيات التحكم وحتى إرضاء الناس، والعادات التي يمكن أن تقوض وظائفنا، بشكل أفضل من خلال فحص ماضينا. تكمن علاقاتنا المبكرة في أعماق أذهاننا وبوعي أو عن غير وعي، ننشئ نموذجًا لكيفية ارتباطنا بالآخرين واستجابتنا للنزاع والتعامل مع السلطة. تحدد هذه العلاقات، بدءًا من تلك التي تربطنا بوالدينا أو مقدمي الرعاية، مسار نظرتنا لجميع العلاقات اللاحقة، لاسيما تلك التي نربطها بمكان العمل.
على سبيل المثال، في حال تلقينا من آبائنا خلال فترة نشأتنا الرعاية والاهتمام اللازمين، فمن المرجح أن نعتقد أن رموز السلطة ستعاملنا لاحقًا بالطريقة ذاتها. في المقابل، إذا لم يقع الاهتمام بنا أو تعرضنا للأذى بأي شكل من الأشكال، فمن المحتمل أن نتوقع أن الأشخاص الآخرين الذين نعتمد عليهم سيخذلوننا أو حتى سيكونون أعدائنا.
بينما قد نعترف على مضض بأن سلوكنا غير المنطقي في حياتنا الشخصية هو بمثابة ردّ فعل على التجارب العائلية المبكرة، إلا أننا نادرًا ما نعتقد أن مشاكل العمل ناجمة تلك التجارب ذاتها. في العمل نحن مقتنعون عمومًا بأن الآخرين هم سبب المشاكل والتهديدات التي نواجهها على غرار الزملاء المخادعين أو الرؤساء المتنمرين أو العملاء الذين تتزايد طلباتهم بشكل مستمر.
في المقابل، يكمن الخطر في أننا قد نسيء تفسير الأمور ونبالغ في تقدير التهديدات الخارجية (من الرؤساء أو العملاء أو الزملاء أو حتى التابعين) ونقلل من شأن التهديدات الداخلية (من النزاعات السابقة التي لم يقع حلها). من المحتمل أن هذا الاضطراب يعني أننا قيمنا الوضع بشكل خاطئ. على سبيل المثال، قد نعتقد بأن تدخلات مديرنا في عملنا توضح أنه يخطط لطردنا بدلاً من محاولة مساعدتنا.
تقييم المواقف بشكل خاطئ
كاد رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في مجال الإعلانات أن يتعرض لانهيار عصبي لأنه شعر بأنه ضحية استغلال سلسلة من المديرات. كان يعتقد دائمًا أنه على وشك التعرض للإقالة أو الانتقاد، وبالتالي أصبح يعمل بضمير حي بشكل شديد ويحاول أن يكون موظفا مثاليا في عمله.
في هذا السياق، وصف هذا الموظف رئيسته الأولى: “كانت تفاجئني بأفكارها الغريبة وتتركني بعد ذلك للتعامل معها. كنا نجري هذه المحادثات الطويلة التي شعرت أنها حميمة للغاية. لكني أردتها أن تتوقف عن تقديم هذه الأفكار الغبية التي لن تنجح. وكنت أشعر أنها تشبه والدتي التي تحاول إقناعي بفكرة واهية”.
خلال فترة شبابه، كانت أسئلة والدته المتطفّلة والمتواصلة عن تفاصيل حياته تشعره بالاختناق. ويقول الموظف ذاته: “خلال فترة المراهقة، كنت بائسا وكنت أرغب أن تكف أمي عن طرح أسئلتها المتواصلة، حيث كانت تريد أن تتعرف على أقرب أصدقائي وأولئك الذين يمكن أن أكشف لهم أسراري وقد كانت دائمًا تريد سحب المزيد من المعلومات مني”.
علاوة على ذلك، كان لرفضه الإجابة عن أسئلتها عواقب شديدة. في هذا السياق، أوضح الموظف ذاته: “كنت أخشى دائمًا أن تغضب أمي وتشعر بالحزن إذا تجاهلتها”. بمجرد أن بدأ حياته المهنية انتقل هذا الاضطراب وانعدام الثقة بالنساء إلى مديراته. وبالتالي، كان يميل إلى إساءة قراءة نواياهن على أنها خبيثة بدلا من أن تكون مساندة له.
من بين أكثر الأمور إثارة للسخرية، أنه بدلاً من تجنب توجيه النقد لهنّ، كان يشجّعهن على هذا السلوك دون دراية بذلك. فعلى سبيل المثال قال إنه ذات مرة اقترحت عليه إحدى المديرات فكرة غريبة وما استنتجه أنّ “ذلك كان غبيًا ويبعث على السخرية. للوهلة الأولى صدمت ثمّ تجاهلت الأمر. وكانت النتيجة النهائية أنّ ما قمت به قد أثار انزعاجها. أدركت لاحقًا أن الفكرة كانت جيدة ولكن حينها اعتقدت أنها تفعل ذلك لتورّطني في الأمر وتجعلني أبدو شخصًا سيّئا أمام الجميع”.
طالما أن مثل هذه التهديدات الداخلية تكمن داخل اللاوعي فإن ذلك يعني أن نطاق سيطرتنا على ردود أفعالنا ضئيل إن لم يكن منعدمًا. لكن إدراج مثل هذه الأحداث في الإدراك الواعي يمنحنا الوضوح الكافي للاستجابة بشكل مناسب بدلاً من ردود الفعل اللاعقلانية.

حصلت حادثة أخرى في الماضي يمكن استحضارها في الوقت الحاضر تخصّ رئيسا تنفيذيًا لشركة استشارية تمت ترقيته مؤخرًا. كان خوفه من إهانة الناس يعني أنه غير قادر على مواجهة عملائه بالحقائق القاسية التي كانوا يدفعون له مقابل سماعها. وبدلاً من ذلك، كان في كل مرة يجعلهم يشعرون بالرضا وبذلك لم يكن يهدم مسيرته المهنية فحسب، بل كانت الشركة معرضة لخطر فقدان عملائها أيضًا.
من خلال مناقشاتنا، اكتشفت أن أول شخص ضايقه بجدية كان والدته. في البداية، كان “طفلها الغالي” ولكن عندما تعرض للتنمر في المدرسة فقد بريقه وروح الدعابة. اضطرت والدته إلى التنحي جانبا بعد أن فهمت بشكل خاطئ أنّ مزاجه العكر فيه انتقاد لها وليس طلبًا للمساعدة، وهذا ما جعله يشعر بالاكتئاب والوحدة.
اكتشف في سن المراهقة أنه من خلال إرضاء الآخرين يمكنه الهروب من الشعور بالوحدة. ثم قام لاحقًا بتطبيق نفس المنهج في حياته المهنية لحماية نفسه من تهديدات الرفض المتخيّلة. خلّف ذلك عواقب – بات يدركها الآن – وهي أنّ “[إرضاء الناس] مثبط للهمم لأن القرارات التي تتخذها قائمة على العديد من الاعتبارات حول ما يشعر به الشخص الآخر تجاهك وكيفية تفاعلك معه، وكيف يمكن أن يتحدث ضدك أو يحرض الآخرين عليك. وبمحاولة عدم الإساءة إليهم وانتقاء ما تقوله يعني ذلك أنك أقل كفاءة وأقل إنتاجية”. ومن المفارقات أن هذا زاد من احتمال إصابة زبائنه بالإحباط والنفور منه، تاركين في نفسه المشاعر التي كان يهرب منها.
لماذا يتجلّى الماضي في الحاضر؟
إن السؤال الأكثر شيوعًا الذي أطرحه هو: لماذا يكرر أي شخص عن قصد سلوكًا يقوض حياته المهنية؟
ببساطة، غالبًا ما يكون التصميم على حلّ المشاكل التي واجهناها في سنواتنا الأولى قويًا بما يكفي لتخريب طموحاتنا. ودون وعي، نكرر السيناريوهات السابقة في محاولة يائسة لحلها. ولكن للأسف، غالبًا ما ينتج عن هذه المحاولات فشل متكرر بدلاً من إيجاد حلول. كما أن العودة إلى الماضي مقنعة وهناك القليل من المفاجآت، في حين أن التغيير غير مريح ومربك.
لا يقتصر الأمر على تجلي النزاعات التي لم يتم حلها في الماضي مجددا في مكان العمل فحسب، بل كذلك بمحاولات تحقيق حاجاتنا الأعمق. ربما كنت تفتقر إلى الاهتمام الكافي أو الطمأنينة من أحد الوالدين، ونادرًا ما شعرت بالحب والإحساس بالأمان. في مكان العمل، يمكن إثارة هذه الرغبات حيث أن المديح والثناء الذي تتلقاه من رئيسك قد يعني لك أكثر بكثير من مجرد أنك تقوم بعمل جيد – ويصبح هذا هو طريقك لمحاولة تلبية الاحتياجات التي لم تُلبّى بشكل كافٍ في مرحلة الطفولة.
ما هي الخطوة التالية؟
إذا كنا نعتقد أن الأشخاص في العمل يقفون ضدنا، فنحن بحاجة إلى التفكير فيما إذا كانت شكوكنا قائمة على الواقع أو نابعة مما تشكل لدينا من تصورات في فترة الطفولة. يعد فصل ماضينا الشخصي عن حاضرنا المهني أمرًا بالغ الأهمية لقراءة المواقف بدقة وحتى يكون ردّ الفعل مناسبًا.

إذا كانت مشاعرك قوية وردود أفعالك غير عقلانية، فربما تستجيب لأحداث الماضي أكثر من الأحداث الحالية. ابحث عن شخص تثق به لمساعدتك على اكتساب منظور مختلف للأشياء. تعرف على رؤسائك وزملائك والعاملين معك حقا، بدلاً من إنشاء تصورات عنهم. فقد تكتشف أنهم عقلانيون وليسوا ضدك على الإطلاق.
لا عجب أن علاقات العمل تلامس الجروح العميقة لماضينا. يمكن للمشاكل المتعلقة بالتبعية والخضوع للسلطة والقرب في مكان العمل أن يعيد إحياء تجاربنا المبكرة. نادرًا ما يكون هناك وقت أو اهتمام لمعرفة الزملاء، وبدلاً من ذلك نحكم عليهم بسرعة، ونضعهم في قوالب مختلفة نادرًا ما نميل إلى إعادة تقييمها. ولكن إذا كانت نظرتنا إليهم تستند إلى تصوراتنا المضللة فإن وقوعنا في سوء الفهم أمر لا مفر منه.
يقوم الجميع على نحو متفاوت بتمثيل تجارب طفولتهم في مكان العمل وهذا ما يجعل سياسات المكتب مثل حقل ألغام. وإذا كنت تريد أن تفهم السلوك غير العقلاني لزملائك فابدأ بفهم سلوكك أولًا.
المصدر: فايننشال تايمز