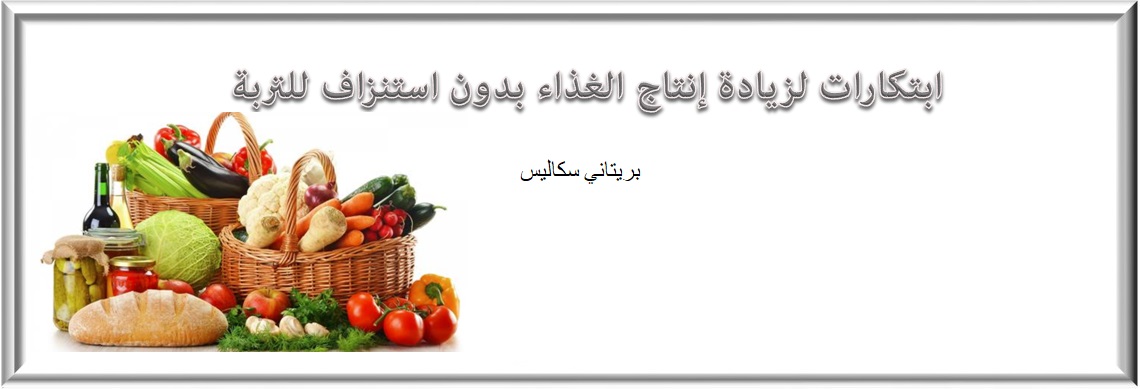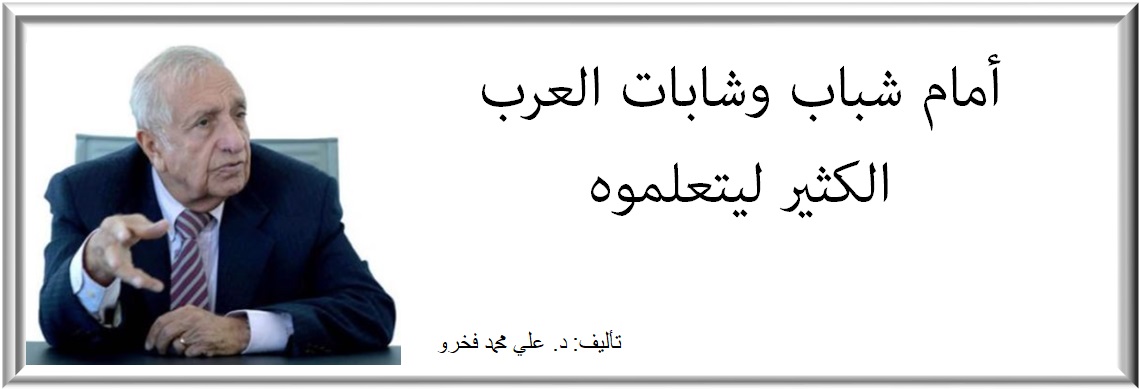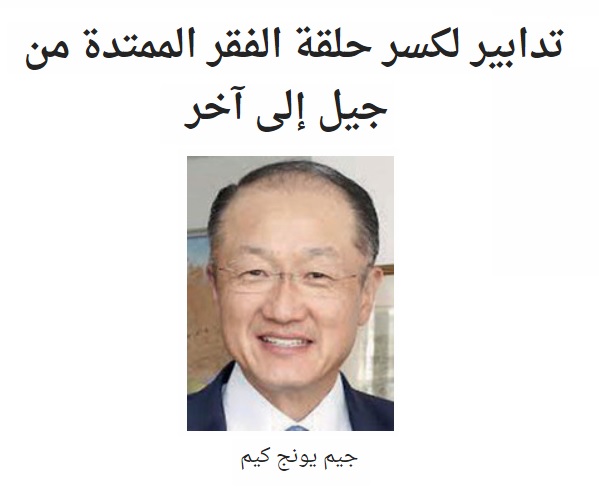تحرير – سالي إسماعيل:
مباشر: في أسواق الصرف الأجنبية، لا ينتظر المستثمرون لمعرفة عما إذا كانت جميع التهديدات الجمركية ستؤدي إلى حرب تجارية شاملة.
ويشير تقرير نشرته شبكة “بلومبرج” إلى أن بعض مديري الأموال بدأوا في تحويل أموالهم إلى الملاذات التقليدية مثل الين، في حين ابتعد آخرون عن العملات تماماً وحتى أولئك الذين لا يراهنون كثيراً سوف يلجأون إلى التحوط تحسباً لأي وضع.
وتتمثل المخاوف في أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، ستؤدي إلى موجة من الردود الانتقامية التي تعوق التوسع الاقتصادي العالمي.
وجاءت استجابة الاتحاد الأوروبي للتعريفات المقترحة على المعادن عبر إعداد خطوات انتقامية على السلع الشهيرة، حيث تدرس حالياً أي من المنتجات الأمريكية سيتم فرض رسوم عليها.

على صعيد آخر، قادت استقالة “جاري كوهن” مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادي اتجاهات المستثمرين، حيث ارتفع الين في حين تراجعت قيمة البيزو والدولار الكندي.
و”كوهن” هو أحد كبار المدافعين عن سياسة التجارة الحرة، وهو ما يعني أن استقالته ترجع لرفضه الرسوم الجمركية التي تحولت بالفعل إلى قرار رسمي، لكن ترامب أكد لاحقاً بأنه سيعود إلى العمل مجدداً وأن أمر الاستقالة مؤقت.
تعزيز الين
ويرى “جين تانوزو” مدير محفظة في شركة “كولومبيا ثريدنيدل” أن العملات يمكن أن تكون صغيرة جداً لكنها ذات آثار قوية، حيث يمكن أن يؤدي استثمار قليل منها إلى تأثير كبير.
وجاء أول رد فعل للمتعاملين من خلال تعزيز حيازتهم للين الياباني، ثم الفرنك السويسري لكن بدرجة أقل، حيث وصلت العملة اليابانية في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 بالتزامن مع الإفصاح عن الرسوم الجمركية.
وعقب الكشف عن تعريفات ترامب، أبدى الدولار الأمريكي ضعفاً ملحوظاً في أدائه ليواصل خسائره المسجلة في العام الماضي، في حين صعدت سندات الخزانة مع اتجاه الأسواق نحو الأصول الأقل خطورة.
الانسحاب
وبحسب “تانوزو”، كان الرد على المناوشات التجارية التي تلوح في الأفق هو تخفيض مخاطر العملة بشكل تدريجي.
وأوضح أنه تصرف على أساس هذا القلق في العام الماضي مع توقعات بتحول مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية “النافتا” إلى حالة من الفزع، حيث خفض التعرض إلى البيزو المكسيكي والدولار الكندي في صندوق الدخل الاستراتيجي في كولومبيا.
وكان الصندوق يضم حوالي 4% من العملة مقسومة بين العملتين قبل القيام ببيع صفقاته في منتصف عام 2017 بالإضافة لخفض الدولار الكندي في أواخر العام الماضي.
وقال “تانوزو” إن هذه المرة ربما تكون الأولى على الإطلاق التي لا يضم الصندوق فيها عملتي الدولار الكندي أو البيزو المكسيكي، والسبب الأساسي في ذلك يرجع إلى المفاوضات في الجانب التجاري.

ومن الواضح أن ترامب استخدم الرسوم الجمركية كورقة مساومة في محادثات “النافتا”، بعدما أشار إلى إمكانية إلغاء تعريفات الصلب والألومنيوم على كندا والمكسيك، حال التوصل إلى اتفاق جديد وعادل بشأن اتفاق التجارة في أمريكال الشمالية، وهو ما تم بالفعل.
وخلال هذا الأسبوع، تراجع الدولار الكندي إلى أضعف مستوياته منذ يوليو الماضي.
وتدرس الإدارة الأمريكية كذلك فرض تعريفات جمركية على مجموعة كبيرة من الواردات الصينية، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر.
وبالنسبة لبعض المستثمرين، فإن التحرك الأمريكي مقابل الصين من شأنه أن يشير إلى خطر متزايد من إجراءات الانتقام المتبادل.
ولا يتجاهل مدير المال في “جي.إيه.إم” البريطانية “أدريان أوينز” الخطاب بشأن التجارة، فبالنسبة له أفضل طريقة هي التنقل بين العملات التي يمكن أن تحمل تقلب مؤقت، على حد قوله.
ويركز “أوينز” على عملتي النرويج والسويد، والسبب في ذلك أن العملة الأخيرة تبدو رخيصة في حين تشير البيانات إلى قوة الاقتصاد.
وقال “أوينز” الذي تدير شركته حوالي 170 مليار دولار، إنه يحب هذا النوع المميز، معترفاً بأن أحد المخاطر هو تدهور الموقف مع ترامب ليصل إلى الحرب التجارية.
وأوضح أنه من أجل الحماية من مخاطر انخفاض الكرونة التي يصاحبها تصاعد التوترات التجارية وتقويض النمو الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى الطلب على النفط النرويجي، فإنه يتحوط من خلال المراكز التي تحقق أرباحاً من مكاسب الين.
الخاسرون
ويقول “مايك موران” رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد” إن تراجع الإنتاج العالمي وانخفاض رغبة المخاطرة من شأنه أيضاً أن يهدد عملات الدول الناشئة.
ويضيف أن هذا النوع من الحروب التجارية لم يوفر بيئة جيدة بالنسبة للأسواق الناشئة على الإطلاق، مشيراً إلى أن تلك الدول تعتبر أكثر حساسية للتجارة العالمية وبالتالي فإن أي ضرر فيها يؤثر سلباً عليهم.
وعلى النقيض، يراهن “ريتشارد بينسون” رئيس استثمارات المحافظ في “ميلنيم جلوبال” والتي تدير أصولاً قيمتها 14 مليار دولار، على العملة الصينية كونها ستستفيد من التوترات التجارية.

معضلة الدولار
السؤال هنا، ماذا يعني كل ذلك بالنسبة للدولار؟ الحرب التجارية العالمية يمكن أن تتسبب في مأزق، هكذا يفسر الوضع محللون في بنك “باركليز”.
كما يتوقع المحللون تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في أعقاب تعريفات الصلب والألومنيوم.
لكن هذا الاتجاه سيتضخم اعتماداً على الطريقة التي سوف يستجيب بها شركاء الولايات المتحدة التجاريين للخطة الموقعة مؤخراً.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار ينص على فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من جميع الدول مع استثناء كندا والمكسيك من تلك التعريفات.

ويُعد ذلك الوضع تطوراً مثيراً للقلق بالنسبة للولايات المتحدة، حيث سيؤدي النقص في التجارة والميزانية إلى جعل واشنطن أكثر اعتماداً على الطلب العالمي على سنداتها بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل.
فيما يصف “تانوزو” مدير محفظة بـ”كولومبيا ثريدنيدل” الوضع الراهن بأنه سيف ذو حدين، موضحاً أنه يجب أن يتم تعزيز الدولار في نهاية المطاف على المدى القصير مقابل العملات التي ستتأثر بقرار التعريفات.
لكن الدولار يمكن أن يظل على المدى الطويل تحت الضغط بشكل عام كونه مطالب بتمويل العجز الكبير والمتنامي في الحساب الجاري.